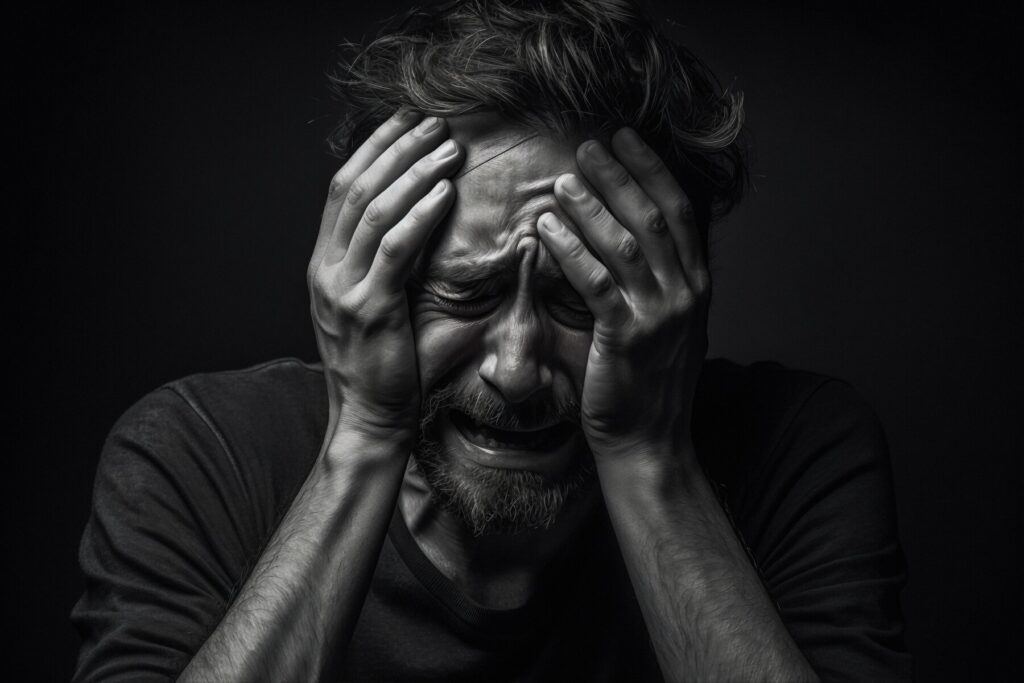المستخلص:
تبنىٰ الباحث في دراسته بيان وراثة – المادية والمعنوية – للإمام الحسين (عليه السلام) من الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) المذكورين – وغير المذكورين – في زيارة وارث، ويتجلىٰ ذلك بالسنن، والخصائص، والمقامات، وغيرها علىٰ شكل مقارنة، وأوجه تشابه، وربط ما بينهما، وذلك عن طريق إجراء دراسة تحليلية مقارنة بينهم، وذلك عن طريق تتبع سيرة الإمام الحسين (عليه السلام) علىٰ نحو الاستقراء الناقص، ومقارنتها مع سيرة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) وخصائصهم، ومقاماتهم، وسننهم، وما جرىٰ عليهم قرآنياً وروائياً، وذلك بتتبع – والاقتصار علىٰ محل الشاهد من – الآيات القرآنية العظيمة المحكمة النازلة فيه (عليه السلام) ووجه تأويلها فيه، والآيات المشار بها إليه بتفسير، وتأويل، وإشارة روايات العترة الطاهرة (عليهم الصلاة والسلام)، وتفسير بعض مصطلحات الدراسة – التي تحتاج إلىٰ بيان وإيضاح – قدر الإمكان.
الكلمات المفتاحية: الإمام الحسين (عليه السلام)، ووراثته من الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، زيارة وارث، وارث، الوراثة بالمعنىٰ الأعم، بالمعنىٰ الأخص، الإرث المادي والمعنوي.
المقدمة:
بسم الله والحمد لله الذي جعل الإمام الحسين (عليه السلام) وزيارته وسيلة لرحمة العباد، وذخرهم في يوم المعاد، والصلاة والسلام علىٰ جده المبعوث رحمة للعباد، وعلىٰ أبيه حامل راية يوم المعاد، وعلىٰ أخيه حجة الله علىٰ العباد، وأُمُّه الزهراء، وذريته الأئمة الأمجاد، واللعنة علىٰ ظالميهم، وقاتليهم، وسالبي حقهم إلىٰ يوم المعاد، آمين يا رب العالمين.
تعدّ زيارة وارث من زيارات الإمام الحسين (عليه السلام) المهمة؛ لاحتوائها علىٰ مضامين عالية عقائدية وأخلاقية وغيرهما، وقد لفتت نصوصها اهتمام الباحثين فلم يقفوا في بياناه عند حد معين، وعُرِفَتْ بالترابط بين الإمام الحسين (عليه السلام) وبين الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) علىٰ نحو الوراثة الخاصة، وقد بينت الروايات وراثة الأئمة (عليهم السلام) بشكل عام من الأنبياء (عليهم السلام) فَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحُونَ﴾ قَالَ: آلُ مُحَمَّدٍ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)(1).
وعن الإمام الباقر (عليه السلام) قَالَ: «لَمَّا قَضَىٰ مُحَمَّدٌ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) نُبُوَّتَهُ وَاُسْتُكْمِلَتْ أَيَّامُهُ أَوْحَىٰ الله إِلَيْهِ أنْ يَا مُحَمَّدُ قَدْ قَضَيْتَ نُبُوَّتَكَ وَاِسْتَكْمَلْتَ أَيَّامَكَ، فَاجْعَلِ اَلْعِلْمَ اَلَّذِي عِنْدَكَ والإيمَانَ وَاَلْآثَارَ وَاَلاِسْمَ اَلْأَكْبَرَ وَمِيرَاثَ اَلْعِلْمِ وَآثَارَ اَلنُّبُوَّةِ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنِّي لَمْ أَقْطَعْ اَلْعِلْمَ والإيمَانَ وَاَلْآثَارَ وَاَلاِسْمَ اَلْأَكْبَرَ عِلْمَ اَلنُّبُوَّةِ مِنَ اَلْعَقِبِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ كَمَا لَمْ أَقْطَعْهَا مِنْ بُيُوتَاتِ اَلْأَنْبِيَاءِ»(2).
وَقَالَ (عليه السلام): «إِنَّ مُحَمَّداً (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) كَانَ أَمِينَ الله فِي أَرْضِهِ فَلَمَّا قَبَضَهُ الله كُنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَرَثَتَهُ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ الله فِي أَرْضِهِ عِنْدَنَا عِلْمُ اَلمَنَايَا وَاَلْبَلاَيَا وَأَنْسَابُ اَلْعَرَبِ وَفَصْلُ اَلْخِطَابِ وَمَوْلِدُ اَلْإِسْلاَمِ»(3).
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ) جَعَلَ اسْمَهُ الْأَعْظَمَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ حَرْفاً، فَأَعْطَىٰ آدَمَ مِنْهَا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَرْفاً، وَأَعْطَىٰ نُوحاً مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفاً، وَأَعْطَىٰ مِنْهَا إِبْرَاهِيمَ ثَمَانِيَةَ أَحْرُفٍ، وَأَعْطَىٰ مُوسَىٰ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَحْرُفٍ، وَأَعْطَىٰ عِيسَىٰ مِنْهَا حَرْفَيْنِ وَكَانَ يُحْيِي بِهِمَا المَوْتَىٰ وَيُبْرِئُ بِهِمَا الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، وَأَعْطَىٰ مُحَمَّداً اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ حَرْفاً»(4).
وورد عنه (عليه السلام) فيما عندهم من رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وآثاره وآثار الأنبياء: «إن عندي ألواح موسىٰ، وعصاه، وحجره، وقميص يوسف، وخاتم سليمان، وإن عندي الطشت الذي يقرب به موسىٰ القربان، وإن عندي التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله، وعندي سلاح رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) ورايته، ودرعه، وسيفه، ولامته، ومغفره، وعمامته، وقميصه، لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله وَرِثَ عَلِيٌّ عِلْمَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَا هُنَالِكَ ثُمَّ صَارَ إلىٰ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»(5).
وَقَالَ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام): «الإمام كلمة الله، وحجة الله، ووجه الله، ونور الله، وحجاب الله، وآية الله، يختاره الله، ويجعل فيه منه ما يشاء، ويوجب له بذلك الطاعة والأمر علىٰ جميع خلقه، فهو وليّه في سماواته وأرضه، أخذ له بذلك العهد علىٰ جميع عباده، فمن تقدَّم عليه كفر بالله من فوق عرشه، فهو يفعل ما يشاء، وإذا شاء الله شاء، يكتب علىٰ عضده وتمّت كلمة ربّك صدقاً وعدلاً، فهو الصدق والعدل، ويُنصب له عمود من نور من الأرض إلىٰ السماء يرىٰ فيه أعمال العباد، ويلبس الهيبة وعلم الضمير، ويطّلع علىٰ الغيب ويعطي التصرف علىٰ الإطلاق، ويرىٰ ما بين الشرق والغرب، فلا يخفىٰ عليه شيء من عالم الملك والملكوت، ويُعطىٰ منطق الطير عند ولايته، فهذا الذي يختاره الله لوحيه، ويرتضيه لغيبه، ويؤيّده بكلمته، ويلقّنه حكمته، ويجعل قلبه مكان مشيّته، ويُنادىٰ له بالسلطنة، ويُذعن له بالإمرة، ويُحكم له بالطاعة؛ وذلك لأنَّ الإمامة ميراث الأنبياء، ومنزلة الأصفياء، وخلافة الله وخلافة رسل الله…»(6).
ورد أنَّه وكانت عليه سيماء الأنبياء، فكان في هيبته يحكي هيبة جده التي تعنو لها الجباه(7)، فقد روي عن أبو هريرة أنَّه قال: (دخل الحسين بن علي (عليه السلام) وهو معتم فظننت أنَّ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) قد بُعث)(8).
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ وَرَّثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدِ انْتَهَىٰ إلىٰ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)… وَنَحْنُ وَرَثَتُهُ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)»(9)، وورد عن الإمام عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «نَحْنُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَحْنُ وَرَثَةُ اولِي الْعِلْمِ، وَأُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»(10).
بعد هذا البيان المقتضب يسعىٰ الباحث إلىٰ تسليط الضوء علىٰ الورثة الخاصة للإمام الحسين (عليه السلام) – السنن، والصفات، والخصائص، التي ورثها – من الحُجَج المذكورين في زيارة وارث وفي عشرة فصول علىٰ سبيل المقارنة، وأوجه التشابه، من خلال تتبع الآيات القرآنية المحكمة النازلة فيه (عليه السلام)، ووجه تأويلها، بروايات أهل البيت (عليهم السلام)، وتفسير بعض المصطلحات قدر الإمكان.
ومن هذا المنطلق قسم الباحث دراسته إلىٰ عشرة محاور ثم الوقوف عليها بشكل مفصَّل، وبها تكمن مشكلة الدراسة، وهي:
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي آدم (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي نوح (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي إبراهيم (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي موسىٰ (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي عيسىٰ (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من النبي محمد (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من أُمِّه فاطمة الزهراء (عليها السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من أخيه الإمام الحسن الرضي (عليه السلام)؟
- ماذا ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من الأنبياء غير المذكورين في الزيارة؟
أهمية الدراسة:
وتكمن أهمية الدراسة في معرفة الأُطر الوراثية للإمام الحسين (عليه السلام) المادية والمعنوية بالمعنىٰ الأعم والأخص، ورفد المكتبة الشيعية بنمط بحثي جديد عنه (عليه السلام) بنمط قرآني وروائي عن طرق التطابق بينهما، وتنوير فكر محبيه بلمحة معرفية جديدة، وتسهم الدراسة في رفع المنسوب الثقافي والمعرفي عن الإمام الحسين (عليه السلام) لدىٰ محبيه، واستفادة الخطباء وأهل المنبر والباحثين من معلومات الدراسة.
أهداف الدراسة:
وتكمن أهداف الدراسة في توضيح – وتسليط الضوء علىٰ – الأُطر الوراثية للإمام الحسين (عليه السلام) المادية والمعنوية، وبيان علاقته الوراثية بينه وبين الأنبياء والأوصياء، وبيان ذلك قرآنياً وروائياً، وإثبات أنَّ وراثته (عليه السلام) امتداد للخط الإلهي واستمراره، وإضافة لمحة معرفية جديدة عنه (عليه السلام)، تسهم في زيادة وتعزيز وعي، وثقافة، ومعرفة، محبي الإمام الحسين (عليه السلام).
الدراسات السابقة:
هناك عدة دراسات ومؤلفات مقدمة في هذا المضمون وهي كما يأتي:
- دراسة كل من الطائي وإبراهيم (2023) بعنوان (زيارة وارث دراسة في السند والدلالة) بحث منشور في مجلة دراسات إسلامية معاصرة جامعة كربلاء.
- كتاب الحسين (عليه السلام) وارث الأنبياء إضاءات جديدة (2011)، د. السيد سامي البدري.
- كتاب زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام) (2020)، د. السيد سامي البدري.
- من الجدير بالذكر أنَّ الدراسات هذه أشارت إلىٰ وراثة الإمام الحسين (عليه السلام) بشكل مجمل ومختصر لا بشكل تفصيلي، وأمّا ما يميز الدراسة الحالية أنَّها أشارت إلىٰ وراثة الإمام الحسين (عليه السلام) بشكل تفصيلي علىٰ نحو الاستقراء الناقص – قرآنياً وروائياً وتفسير بعض مصطلحات الدراسة – علىٰ قدر المستطاع بما توصل إليه الباحث.
تمهيد في معنىٰ وارث والوراثة:
تذكر النصوص الدينية من الزيارات والأحاديث أنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) وارثاً للأنبياء والأولياء (عليهم السلام)، ولهذه الوراثة معنىٰ جامع للكثير من المعاني والحقائق ذات البعد العرفاني والاجتماعي والسياسي وغيرها، وسنخصّص الكلام في هذه الدراسة للحديث عما يمكن استفادته من معنىٰ وراثة الحسين (عليه السلام)(11).
وارث والوراثة في اللغة:
إنَّ (وارث) في اللغة: اسم فاعل وهو الذي يرث المال والمجد من أبيه، أي ورثه عنه فصار إليه، فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر(12).
ذكر أئمة المعاجم اللغوية: أنَّ الجذر وهو (ورث) يعني (أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلىٰ آخرين)، ويظهر من بعضهم أنَّ الموروث بمعنىٰ الباقي، والإيراث هو الإبقاء علىٰ الشيء، وهذا المعنىٰ لا يؤخذ فيه من حيث أصله ومفهومه كون الباقي أو المنتقل أمراً ماديّاً، بل تتعدّد الموارد بتعدّد أطراف الوراثة، فالمورّث للمال كالأب مثلاً، حين يورّث ابنه يجعل الوراثة ماديّة، وكذلك يكون توريث العلم أيضاً توريثاً حقيقياً بمعنىٰ أنَّه لا يكون مجازاً لأنَّه لا يدخل في حدِّ وتعريف الإرث إلَّا الانتقال أو الإبقاء، وعليه تتعدّد كيفية التوريث بتعدّد متعلّقات الإرث(13).
الوارث والوراثة اصطلاحاً:
إنَّ الوراثة قد تكون أحياناً مادية كما في أبواب الفقه باب الإرث والميراث أي وراثة أهل الميت له بحسب قرابتهم وطبقاتهم في الإرث، أو قد تكون هذه الوراثة معنوية ليست مادية، وهذا ما نصَّت عليه زيارة وارث التي وردت بحق الإمام الحسين (عليه السلام)(14)، فإنَّه قد ورث المسيرة الحضارية الربانية الضخمة التي تمتد عبر حياة وجهود ودعوة الأنبياء والمرسلين(15)، وأنَّ محمد وآل محمد (صلوات الله وسلامه عليهم) ورثوا كل علم وكتاب وفضيلة وكمال من الأنبياء، فقد آتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، فإنَّ كل ما ثبت للأنبياء من الصفات الحميدة التي بعثوا لأجلها فهي لهم لأنَّهم الوارثون(16).
معنىٰ وراثة الإمام الحسين (عليه السلام):
فإنَّ ميراث الإمام الحسين (عليه السلام) من الذوات المقدسة المذكورة ومنهم ستة من الأنبياء ليس المقصود هو المال، بل المقصود هو أحد أنحاء ثلاثة (17):
النوع الأول: وراثة مقام الإمامة الإلهية الذي جعله الله تعالىٰ لنبيِّه إبراهيم، وهذه الوارثة كانت بواسطة جدِّه النبي (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) فقد أورثه الله تعالىٰ دين إبراهيم وإمامة إبراهيم، وهذا النحو من الوراثة ليس خاصاً بالإمام الحسين (عليه السلام) بل ورثه أبوه وأخوه من قبل ثم ورثه التسعة من بنيه من بعده.
النوع الثاني: وراثة كتب الأنبياء التي انتهت إلىٰ النبي (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) عن طريق عمه أبي طالب ثم انتقلت منه (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) إلىٰ علي ثم الحسن ثم الحسين (عليه السلام) ثم صارت ميراثاً للأئمة من ولد الحسين (عليه السلام)، فهذا النوع أيضاً ليس خاصاً بالإمام الحسين (عليه السلام).
النحو الثالث: وراثة بعض الخصوصيات التكوينية الرسالية التي ميَّز الله بها بعض أنبيائه وأصفيائه فجمعها للحسين دون غيره من الأصفياء أو من ولده لتكون من خصوصياته بين أصفياء الله جميعاً، والوراثة هنا ليست بالوصية كما في حالة وراثة مقام الإمامة الإلهية ووراثة الكتب، بل هي وراثة بالتكوين.
ومعنىٰ أنَّ الإمام الحسين وارث النبي آدم (عليه السلام) أي أنَّه يحمل عدد من خصائصه التي تذكر به، وهكذا مع بقية الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، والجواب يتَّضح من بيان خصوصيات الأنبياء الأئمة (عليهم السلام)، وأنَّ هناك ثلاث خصوصيات رسالية للأنبياء وأوصيائهم، وهي: (الإمامة الهادية، والتراث النبوي المكتوب، وخصوصية تتعلق بالحركة الرسالية في المجتمع يتميَّز بها النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) أو الوصي في تاريخ الحركة الرسالية)، وتكشف المقارنة بين الإمام الحسين والذوات التسعة (عليهم الصلاة والسلام) عن تماثل الإمام الحسين معهم في الخصوصيات الرسالية المميزة لكل واحد منهم، وبذلك يكون الإمام الحسين (عليه السلام) وارثاً لهم، وهكذا فإنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) وارث النبي آدم (عليه السلام) في خصوصياته الرسالية التي ميَّزه الله وحباه بها، والأمر نفسه في الخصوصيات الأخرىٰ لباقي الأنبياء والأوصياء المذكورين وغير المذكورين في زيارة وارث، وأنَّ التماثل يمكن أن يضعنا أمام ظاهرة تسمّىٰ (الاستنساخ التاريخي) وهي فريدة من نوعها وغير واقع إلَّا بإذن الله دون الاستنساخ البشري الممكن كما في زماننا هذا(18).
الشكر والعرفان:
الشكر كلُّه لله الذي هو سند لمن لا سند له، وعماد لمن لا عماد له، وذخر لمن لا ذخر له، ومعين لمن لا معين له، وأحمده مع قصوري وأشكره علىٰ إعانتي وإيصالي وتوفيقي وتسديدي وتسهيل أمري وقضاء حاجتي وإجابة دعوتي.
والشكر العظيم لأهل بيته (صلوات الله عليهم) سادتي وأولياء نعمتي في دنياي وآخرتي، وعلىٰ الخصوص الأب الحنون سيدي ومولاي وإمامي المنتظر عجَّل الله فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وقرَّب زمانه، إذ لولا دعائه ورعايته ونظرته ولطفه لما وصلت إلىٰ ما وصلت إليه.
الإهداء:
أهدي هذا الجهد المتواضع لوجه الله الكريم، ولنبيِّه المصطفىٰ مُحَمَّدٍ الأمين وَآلِه الطيبين الطاهرين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) راجياً قبولهم، ورضاهم، وقضاء حوائجي بهم، وغفران ذنوبي بهم، وشفاعتهم والحشر معهم وفي زمرتهم.
الفصل الأول: السَّلامُ عَلَيكَ يا وارِثَ آدَمَ صَفوَةِ اللهَ
- الاصطفاء: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الله اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: 33)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ (البقرة: 130)، الاصطفاء أخذ صفوة الشيء وتمييزه عن غيره إذا اختلطا، وينطبق هذا المعنىٰ بالنظر إلىٰ مقامات الولاية علىٰ خلوص العبودية وهو أن يجري العبد في جميع شؤونه علىٰ ما يقتضيه مملوكيته وعبوديته من التسليم الصرف لربِّه، وهو التحقق بالدين في جميع الشؤون فإنَّ الدين لا يشتمل إلَّا علىٰ مواد العبودية في أمور الدنيا والآخرة وتسليم ما يرضيه الله لعبده في جميع أموره(19)، فالاصطفاء علىٰ العالمين، نوع اختيار وتقديم لهم عليهم في أمر أو أمور لا يشاركهم فيه أو فيها غيرهم(20)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد جاء عن علي بن إبراهيم في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَلامٌ عَلىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ﴾ (النمل: 59) قال: هُمْ آلُ مُحَمَدّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)(21)، وقال ولده أَبُو الْحَسَنِ الإمَامُ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): «نَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا الله»(22)، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ صَفْوَةُ الله»(23)، وجاء في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ الله وَابْنِ صَفِيِّهِ»، وورد في الزيارة الجامعة «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَوْلِياءَ اللهِ وَأَصْفِيائِهِ»، وورد في زيارته «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا صَفْوَةَ اللهِ».
- الخليفة: قوله تعالىٰ: ﴿إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30)، أنَّ المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه علىٰ ظهر الأرض(24)، فقد ثبت أنَّ جميع الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) هم خلفاء الله في أرضه، وأنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) أحدهم كما ورد في الزيارة الجامعة «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَنْصارِ اللهِ وَخُلَفائِهِ، رَضِيَكُم خُلَفاءَ في أرضِهِ».
- الطاعة: قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ (البقرة: 34)، أمر الله الملائكة بالسجود لنبي آدم (عليه السلام) تكريماً وتعظيماً له، كذلك قد أمر الله الملائكة بأن يصلوا علىٰ الإمام الحسين (عليه السلام) بأمر الله وطاعته، فقد قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «وَكَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالحُسَيْنِ (عليه السلام) سَبْعِينَ أَلْف مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ»(25).
- الأسماء: قوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها﴾ (البقرة: 31)، الأسماء هي جمع محلىٰ باللام وهو يفيد العموم علىٰ ما صرَّحوا به مضافاً إلىٰ أنَّه مؤكَّد بقوله: ﴿كُلَّها﴾، فالمراد بها كل اسم يقع لمسمّىٰ ولا تقييد ولا عهد(26)، وجاء في تأويلها عن الإمام العسكري (عليه السلام) في تفسيره أنَّه قال: «أَسْمَاءَ مُحَمَّدٍ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالطَّيِّبَينَ مِنْ آلهِمَا»(27).
- التلقي: قوله تعالىٰ: ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: 37)، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ: اللهمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ، فَتَابَ الله عَلَيْهِ»(28)، وتلقّىٰ الإمام الحسين (عليه السلام) دم مهجته بيديه ورفعه إلىٰ السماء، وخضَّب به رأسه وشيبته المباركة(29)، وتلقّىٰ دم ولده علىٰ الأكبر(30)، ودم رضيعه ورماه إلىٰ السماء فلم يسقط منه قطرة(31).
- الاجتباء والهداية: قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدىٰ﴾ (طه: 122) الاجتباء الجمع علىٰ طريق الاصطفاء واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصَّل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يقارنهم من الصديقين والشهداء(32)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ المُجْتَبَوْنَ»(33).
- الأوصياء التسعة والقائم: الوصي اسم مصدر بمعنىٰ العهد وما أوصيت به، يقال: أوصىٰ الرجل، والوصيّ: الذي يُوصىٰ، والذي يُوصي له(34)، والقائم هو القائم بأمر الله (عزَّ وجلَّ)(35)، رزق الله النبي آدم (عليه السلام) تسعة أوصياء من ذريته بعده(36)، كان أولهم شيث (عليه السلام)، وآخرهم النبي نوح قائمهم أطولهم عمراً، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله: «دخلت علىٰ جدي رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) فأجلسني علىٰ فخذه وقال لي: إنَّ الله اختار من صلبك يا حسين تسعة أئمة تاسعهم قائمهم»(37).
- الابتلاء: الابتلاء هو الاختبار والامتحان(38)، فقد ابتُلِيَ النبي آدم (عليه السلام) بعد هبوطه من الجنة بفراقها، ومقتل ولده(39)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) ابتلي بمقتل أولاده، وفراق مدينة جده، وقبر أمه، وقلة الناصر، وكثرة الأعداء، والكرب والمحن، والقتل، والجراحات، والطعنات، ورض الجسد بالخيول، وغيرها.
- الطلب: أنَّ النبي آدم (عليه السلام) بعد هبوطه للأرض أخذ يطلب الماء والطعام فوجده، لكن الإمام الحسين (عليه السلام) طلب الماء قائلاً: «وحق جدّي إني عطشان»(40)، فما سقوه وقد قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّ الحُسَينَ (عليه السلام) قُتِلَ حَزيناً مَكروباً، شَعِثاً مُغبَراً، جائِعاً عَطشاناً»(41).
- الأبوة: النبي آدم (عليه السلام) هو أب البشرية، والإمام الحسين (عليه السلام) أبو الأئمة (عليهم الصلاة والسلام).
- البكاء وقتل الأولاد: أنَّ النبي آدم (عليه السلام) بكىٰ علىٰ مقتل ولده هابيل(42)، وأنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) كذلك أرخىٰ عينيه(43) علىٰ ولده الأكبر، والرضيع (صلوات الله عليهم).
- الذرية الصالحة: الذرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثىٰ، كالأولاد، وأولاد الأولاد وهلم جراً(44)، أشارت الروايات أنَّ الله سبحانه وتعالىٰ رزق النبي آدم (عليه السلام) الذرية الصالحة من صلب ولده النبي شيث (عليه السلام) هبة الله، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) رزقه الله سبحانه وتعالىٰ الذرية الصالحة من صلبه المبارك الطيب.
- الغربة: ورد أنَّ النبي آدم (عليه السلام) عند هبوطه من الجنة استغرب لوحدته، وفراق الجنة، وورد أنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) قبل شهادته جاء لتوديع ولده السجاد (عليه السلام) قال: «بلِّغ شيعتي عنّي السلام، فقل لهم: إنَّ أبي مات غريباً فاندبوه، ومضىٰ شهيداً فابكوه»(45)، وجاء في زيارة الناحية «السَّلامُ عَلىٰ غَريبِ الغُرَبَاءِ»، وقال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إنَّ جدي الحسين (عليه السلام) غريب بأرض غربة»(46).
- العصا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)، قَالَ: «كَانَتْ عَصَا مُوسَىٰ لِآدَمَ سَقَطَتْ إلىٰ شُعَيْبٍ، ثُمَّ صَارَتْ إلىٰ مُوسَىٰ، وَإِنَّهَا لَعِنْدَنَا، وَإِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفاً، وَإِنَّهَا لَخَضْرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ انْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا، وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ»(47).
- القميص: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَال: «خَرَجَ عَلِيٌّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) ذَاتَ لَيْلَةٍ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ بَعْدَ عَتَمَةٍ وَهُمْ فِي الرَّحْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: هَمْهَمَةٌ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، خَرَجَ عَلَيْكُمُ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُ آدَمَ»(48)، وقد ورثه ولده الإمام الحسين (عليه السلام).
- المواساة: أنَّ النبي آدم (عليه السلام) لما هبط إلىٰ الأرض مرَّ بأرض كربلاء فاعتلَّ واعتاق وضاق صدره من غير سبب، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين (عليه السلام) حتَّىٰ سال الدم من رجليه فرفع رأسه إلىٰ السماء وقال: إلهي هل حدث في شيء من ذنب آخر فعاقبتني به! فإني طفت جميع الأرض ما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض، فأوحىٰ الله تعالىٰ إليه: يا آدم ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض من ولدك الحسين (عليه السلام) ظلماً فسال دمك موافقة لدمه، فقال آدم (عليه السلام): ومن قاتله؟ قال: قاتله يزيد لعين أهل السماوات والأرض، فقال آدم (عليه السلام): فأي شيء أصنع يا جبرئيل؟ فقال: العنه(49).
وورد أنَّه لمَّا ذَكَرَ الْحُسَيْن سَالَتْ دُمُوعُهُ وَاِنْخَشَعَ قَلْبُهُ وَقَالَ: يَا أَخِي جبريل فِي ذِكْرِ اَلْخَامِسِ يَنْكَسِرُ قَلْبِي وَتَسِيلُ عَبْرَتِي، قَالَ جبريل: وَلَدُكَ هَذَا يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ تَصْغُرُ عِنْدَهَا المَصَائِبُ فَقَالَ: يَا أَخِي وَمَا هِيَ؟ قَالَ: يُقْتَلُ عَطْشَاناً غَرِيباً وَحِيداً فَرِيداً لَيْسَ لَهُ نَاصِرٌ وَلا مُعِينٌ وَلَو تَرَاهُ يا آدَم وَهُوَ يَقُولُ: وَاعَطَشَاهْ وَاقِلَّة نَاصِرَاهْ حتَّىٰ يَحُولَ اَلْعَطَشُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْسَّمَاءِ كَالدُّخَانِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَّا بِالسُّيُوفِ وَشُرْبِ الْحُتُوفِ فَيُذْبَحُ ذَبْحَ اَلشَّاةِ مِنْ قَفَاهُ وَيَنْهَبُ رَحْلَهُ أَعْدَاؤُهُ وَتُشْهَرُ رُءُوسُهُمْ هُوَ وَأَنْصَارُهُ فِي اَلْبُلْدَانِ وَمَعَهُمُ اَلنِّسْوَانُ كَذَلِكَ سَبَقَ فِي عِلْمِ الْوَاحِدِ المَنَان فَبَكَىٰ آدَم وَجبريل بُكَاءَ اَلثَّكْلَىٰ(50).
الفصل الثاني: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وارِثَ نُوح نَبِيِّ اللهِ
- السفينة: قوله تعالىٰ: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا﴾ (المؤمنون: 27)، الفلك هي السفينة مفردها وجمعها واحد، والأعيُن جمع قلة للعين، وإنَّما جمع للدلالة علىٰ كثرة المراقبة وشدَّتها فإنَّ الجملة كناية عن المراقبة في الصنع(51)، فقد ورد عن رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أنَّه قَالَ: «إنَّ الحُسَينَ مِصباحُ هُدىٰ، وسَفينَةُ نَجاةٍ»(52)، وقال (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «مَثَلُ أهلِ بَيتي مَثَلُ سَفينَةِ نُوحٍ؛ مَن رَكِبَها نَجا ومَن تَخَلّفَ عَنها غَرِقَ»(53)، وقال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «كلنا سُفن النجاة ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع»(54)، كما جاء في زيارة النصف من رجب «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا سُفُنَ النَّجاةِ»؛ وقَالَ أَبُو جَعْفَر (عليه السلام): «نَحْنُ عَيْنُ الله»(55)، وقال (عليه السلام): «نَحْنُ سَفِينَتُكُمْ كَسَفِينَةِ نُوحٍ»(56).
- السلام: قوله تعالىٰ: ﴿سَلامٌ عَلىٰ نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ﴾ (الصافات: 79)، يقصد بالسلام هو الذي يوضِّح السلامة والعافية من كلّ أنواع العذاب والعقاب في يوم القيامة، السلام الذي هو صمّام الأمان أمام الهزائم ودليل للانتصار علىٰ الأعداء، وأنَّ المراد بالعالمين جميعها لكونه جمعاً محلّىٰ بالألف واللام (مفيداً للعموم) فيتَّسع المعنىٰ ليشمل عوالم البشر وأُممهم وجماعاتهم إلىٰ يوم القيامة ويتعدّاهم إلىٰ عوالم الملائكة والملكوتين(57)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) اسْمُهُ يَاسِينُ، وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ الله: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِلْياسِينَ﴾ [الصافات: 130]»(58)، وعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) قَالَ: «يَس مُحَمَّدٌ، وَنَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ»(59).
- الدعوة إلىٰ الله وعدم التلبية: قوله: ﴿قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهاراً 5 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً﴾ (نوح: 5-6)، القائل هو النبي نوح (عليه السلام) والذي دعا إليه هو عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله، والدعاء ليلاً ونهاراً كناية عن دوامه من غير فتور ولا توان؛ والمراد بالفرار التمرّد والتأبي عن القبول استعارة، وإسناد زيادة الفرار إلىٰ دعائه لما فيه من شائبة السببية لأنَّ الخير إذا وقع في محل غير صالح قاومه المحل بما فيه من الفساد فأفسده فانقلب شراً(60)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) دعا لعبادة الله وطاعته قائلاً: «أمّا من مغيث يغيثنا لوجه الله، أمّا من ذاب يذب عن حرم رسول الله»(61)، فقد قالوا له: (لا نفقه ما تقول يا بن فاطمة)، وأجابوه بالسيوف؛ ورشقوه بالرماح، والنبال، والحجارة؛ وسحقوا جسده ورضوا صدره الشريف وكسروا أضلاعه (صلوات وسلامه الله عليه) وقد جاء في الزيارة الناحية: «قَاتَلُوكَ بِكَيْدِهِمُ وَشَرِّهِمُ، وَمَنَعُوكَ المَاءَ وَوُرُودَهُ، ونَاجَزُوكَ القِتَالَ، وَعَاجَلُوكَ النِّزَالَ، وَرَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَالنِّبَالِ، وبَسَطُوا إِلَيكَ أَكُفَّ الاِصْطِلاَمِ، وَلَمْ يَرْعَوْا لَكَ ذِمَاماً، وَلا رَاقَبُوا فِيْكَ أثَاماً، فِي قَتْلِهِمُ أوْلِيَاءَكَ، وَنَهْبِهِمُ رِحَالَكَ، وَأنْتَ ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ».
- تعدد طرق الدعوة: قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً﴾ (نوح: 8-9) ورد أنَّ النبي نوح (عليه السلام) اتَّبع في دعوته ثلاثة أساليب مختلفة حتَّىٰ يستطيع من النفوذ في هذا الجمع المعاند والمتكبر: كان يدعو أحياناً في الخفاء فواجه أربعة أنواع من الرفض وهي (وضع الأصابع في الآذان، تغطية الوجوه بالملابس، الإصرار علىٰ الكفر، والاستكبار(، وكان يدعو أحياناً بالإعلان، وأحياناً أخرىٰ يستفيد من طريق التعليم العلني والسري ولكن أياً من هذه الأمور لم يكن مؤثراً(62)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد اتَّبع عدَّة طرق للدعوة فمرة ركب جمله، وأُخرىٰ رأوه راكباً جواده، وتارة أخرى قصدهم ماشياً، لنصحهم ودعوتهم، لكن لم يجبه أحد إلَّا الذين وفوا لرعاية الحق.
التحدي: قوله تعالىٰ: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ فَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ﴾ (يونس: 71)، المقام مصدر ميمي واسم زمان ومكان من القيام، والمراد به أي قيامي بأمر الدعوة إلىٰ توحيد الله أو مكانتي ومنزلتي وهي منزلة الرسالة، والإجماع العزم، والغمَّة هي الكربة والشدَّة وفيه معنىٰ التغطية كأن الهم يغطي القلب، ومعنىٰ الآية: ﴿وَاتْلُ﴾ يا محمد ﴿عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ﴾ وخبره العظيم حيث واجه قومه وهو واحد يتكلَّم عن نفسه، وهو مرسل إلىٰ أهل الدنيا فتحدَّىٰ عليهم بأن يفعلوا به ما بدا لهم إنْ قدروا علىٰ ذلك، وأتم الحجة علىٰ مكذِّبيه في ذلك ﴿إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي﴾ ونهضتي لأمر الدعوة إلىٰ التوحيد أو منزلتي من الرسالة ﴿وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ﴾ وهو داعيكم لا محالة إلىٰ قتلي وإيقاع ما تقدرون عليه من الشرِّ بي لإراحة أنفسكم مني ﴿فَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْتُ﴾ قبال ما يهددني من تحرج صدوركم وضيق نفوسكم عليَّ بإرجاع أمري إليه وجعله وكيلاً يتصرَّف في شؤوني ومن غير أن أشتغل بالتدبير ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ﴾ الذين تزعمون أنَّهم ينصرونكم في الشدائد، واعزموا عليَّ بما بدا لكم، وهذا أمر تعجيزي ﴿ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ إن لم تكونوا اجتهدتم في التوسل إلىٰ كل سبب في دفعي ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ﴾ بدفعي وقتلي ﴿وَلا تُنْظِرُونِ﴾ ولا تمهلوني.
وفي الآية تحدّيه (عليه السلام) علىٰ قومه بأن يفعلوا به ما بدا لهم، وإظهار أنَّ ربَّه قدير علىٰ دفعهم عنه وإن أجمعوا عليه وانتصروا بشركائهم وآلهتهم(63).
إنَّ نوحاً رسول الله الكبير صمد مقابل أعدائه الأقوياء المعاندين وواجههم بقاطعية وحزم وفي منتهىٰ الشجاعة والشهامة مع أصحابه القليلين الذين كانوا معه، وكان يستهزئ بقواهم ويريهم عدم اهتمامه بخططهم وأفكارهم وأصنامهم، وبهذه الطريقة كان يوجِّه ضربة نفسية عنيفة إلىٰ أفكارهم(64).
كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) تحدّاهم يوم العاشر قائلاً: «أيمُ الله، لا تلبثوا بعدها إلَّا كما يركب الفرس حتَّىٰ تدور بكم دور الرحىٰ، وتقلق بكم قلق المحور؛ عهد عهده إليَّ أبي عن جدّي رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ﴾»(65).
- التهديد: هدَّد قوم نوح نبيّهم (عليه السلام) بقولهم: ﴿قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ (الشعراء: 116)، المراد بالانتهاء ترك الدعوة، والرجم هو الرمي بالحجارة(66)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) هدَّده أعدائه بالقتل إذا لم يبايع، أو ينزل عن حكم أميرهم الفاسق، فأبىٰ (صلوات الله عليه وسلامه)، فجاءهم الأمر أن (اقتلوا الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة)(67)، وقد أنبأهم (عليه السلام) بذلك: «والله لا يدعوني حتَّىٰ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي»(68).
- تحكم الأغنياء بالدين والمتهتكين وأهل السلطة: كان الأغنياء والمتهتكين وأهل السلطة والفاسدين يتحكَّمون بالدين في زمن النبي نوح (عليه السلام) فواجههم ودعاهم لعبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلم يطيعوه، فاتَّبعه الفقراء ﴿فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَـراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ﴾ (هود: 27) ففي الكلام تكذيب لرسالته (عليه السلام) بأنَّه ليس إلَّا بشراً مثلهم ثم استنتاج من ذلك أنَّه لا دليل علىٰ لزوم اتِّباعه(69)، ونلاحظ هنا كلمة ﴿الْمَلَأُ﴾ التي تشير إلىٰ أصحاب الثروة والقوة الذين يملأ العين ظاهرهم، في حين أنَّ الواقع أجوف، ويشكِّلون أصل الفساد والانحراف في كل مجتمع، ويرفعون راية العناد والمواجهة أمام دعوة الأنبياء (عليهم السلام)، و(الأراذل) جمع لـ(أرذل) وتأتي أيضاً جمع لـ(رذل) التي تعني الموجود الحقير – أو غير المرغوب فيه(70) -، سواء كان إنساناً أم شيئاً آخر غير، وبالطبع فإنَّ الملتفين حول نوح (عليه السلام) والمؤمنين به لم يكونوا أراذل ولا حقراء، ولكن بما أنَّ الأنبياء ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء، فأوَّل جماعة يستجيبون لهم ويلبّون دعوتهم هم الجماعة المحرومة والفقيرة، ولكن هؤلاء في نظر المستكبرين الذين يعدّون معيار الشخصية القوة والثروة فحسب يحسبونهم أراذل وحقراء(71)، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك اتَّبعه القلة من الثلة المؤمنة وكان المتهتكين وأصحاب السلطة الفاسدة يتحكَّمون بالدين، فتصدّىٰ لهم الإمام الحسين (عليه السلام) عندما أبلغه اللعين ببيعة يزيد (لعنه الله)، فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون وعلىٰ الإسلام السلام إذ بليت الأُمَّة براعٍ مثل يزيد، إنَّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله، وبنا ختم، ويزيد فاسق، فاجر شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، مثلي لا يبايع مثله»(72).
- التصدي للانحراف: بعد النبي إدريس (عليه السلام) انحرف الناس وعبدوا الأصنام حتَّىٰ تصدّىٰ لهم النبي نوح (عليه السلام) ونهاهم فأمسكوا عنه وعاندوه ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَداً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾ (نوح: 23)، فلم يؤمن معه إلَّا القليل وهم أصحاب سفينته، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) تصدَّىٰ للذين خالفوا جدّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وانحرفوا عن التعاليم الدينية الحقة، فلم يؤمن معه إلَّا القليل، وظل أكثرهم ضالّين ومتمسِّكين بأهوائهم وعنادهم ومخالفتهم، وضَلَّتْ ﴿قُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (الحجر: 14-15) أي تظن أنَّهم مجتمعون في أُلفة واتِّحاد، والحال أنَّ قلوبهم متفرِّقة غير متَّحدة وذلك أقوىٰ عامل في الخزي والخذلان، ذلك بأنَّهم قوم لا يعقلون ولو عقلوا لاتَّحدوا ووحَّدوا الكلمة(73).
- الأذىٰ من دعوة الله: ذكرت الروايات أنَّ النبي نوح (عليه السلام) تعرَّض للأذىٰ، والضرب، وإخراج دمه، من قبل قومه، أثر دعوته ونهضته لعبادة الله تعالىٰ، فكان يغشىٰ عليه ثلاثة أيام ثم يفيق ويعيد ذلك(74)، وتارة أخرىٰ يضغطون رقبته بأيديهم حتَّىٰ يفقد وعيه، ولكنَّه ما أن يفيق إلىٰ وعيه حتَّىٰ يقول: «اللهمّ اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون»(75)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قال الإمام الباقر (عليه السلام): «لَقَد قُتِلَ بِالسَّيفِ وَالسِّنانِ، وبِالحِجارَةِ وبِالخَشَبِ وبِالعِصِيِّ، ولَقَد أوطَؤوهُ الخَيلَ بَعدَ ذلِكَ»(76)، وقد جاء في الزيارة الناحية: «نَكَّسُوكَ عَنْ جَوَادِكَ، فَهَوَيْتَ إلىٰ الأرْضِ جَرِيْحاً، تَطَؤُكَ الخُيولُ بِحَوَافِرِهَا، وَتَعْلُوكَ الطُّغَاةُ بِبَوَاتِرِها»، وقد جاء أيضاً: «قَاتَلُوكَ بِكَيْدِهِمُ وَشَرِّهِمُ، وَمَنَعُوكَ المَاءَ وَوُرُودَهُ، ونَاجَزُوكَ القِتَالَ، وَعَاجَلُوكَ النِّزَالَ، وَرَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَالنِّبَالِ، وبَسَطُوا إِلَيكَ أَكُفَّ الاِصْطِلاَمِ، وَلَمْ يَرْعَوْا لَكَ ذِمَاماً، وَلا رَاقَبُوا فِيْكَ أثَاماً، فِي قَتْلِهِمُ أوْلِيَاءَكَ، وَنَهْبِهِمُ رِحَالَكَ، وَأنْتَ ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ».
- الغربلة والتمايز: اختبر الله قوم النبي نوح (عليه السلام) وغربلهم، فتميَّزوا وافترقوا ثلاث فرق: (فرقة ارتدت، وفرقة نافقت، وفرقة ثبتت معه فأدخلهم السفينة فنجوا بعد ما صفوا وذهب الكدر منهم)(77)، وهكذا تعرَّض الناس في زمن الإمام الحسين (عليه السلام) مُحِّصُوا وتغربلوا وتمايزوا حتَّىٰ صاروا ثلاث فِرَق، ففِرْقة أسرجت وألجمت وتنقَّبت تهيأت وأعدَّت واستعدت لقتاله؛ وفرقة سكتت ولم تنصره به فما بلغت الفتح؛ وفرقة آمنت به ودخلت في سفينته ونصرته، وهم الذين صفوا واستشهدوا معه وبلغوا الفتح.
- القلة: قوله تعالىٰ: ﴿وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (هود: 40) والبقية لم يكن يرجىٰ منهم خير، وفي العيون، بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قال الإمام الرضا (عليه السلام): «هبط نوح إلىٰ الأرض كان نوح وولده ومن تبعه ثمانين نفساً، فبنىٰ حيث نزل قرية فسماها قرية الثمانين»(78)، وكذلك عدد القلة الذين كانوا مع الإمام الحسين (عليه السلام) كما أشارت الروايات، وقد صاح عياله: واقلَّة ناصراه(79).
- النصح: نصح النبي نوح (عليه السلام) قومه بقوله: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ (الأعراف: 62)، (أنصح) من مادة (نصح) يعني الخلوص والغلو عن الغش وعن الشيء الدخيل، لهذا يقال للعسل الخالص: ناصح العسل، ثمّ أطلقت هذه اللفظة علىٰ الكلام الصادر عن سلامة نية، وبقصد الخير، ومن دون خداع ومكر(80)، وإرساله الله إلىٰ قومه يدعوهم إلىٰ التوحيد وترك عبادة غيره وما واجهته به عامة قومه من الإنكار والإصرار علىٰ تكذيبه، وذكر أنَّه ينصح لهم وهو عظاته بالإنذار والتبشير ليقربهم من طاعة ربِّهم ويبعدهم عن الاستكبار والاستنكاف عن عبوديته كل ذلك بذكر ما عرفه الله من بدء الخلقة وعودها وسننه تعالىٰ الجارية فيها(81)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) نصح فقد جاء في زيارة الأربعين أنَّه قد «مَنَحَ النُّصحَ، وَبَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ لِيَستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الجَهالَةِ وَحَيرَةِ الضَّلالَةِ».
- النداء: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (الصافات: 75) التعبير بـ(نادىٰ) يأتي عادة بمعنىٰ الدعاء بصوت عال، ولعلّه إشارة إلىٰ أنَّهم آذوا هذا النّبي الجليل إلىٰ درجة جعلته يصرخ منادياً ربَّه ليدركه وينجّيه من أذاهم وشرّهم(82)، واللامان للقسم وهو يدل علىٰ كمال العناية بنداء نوح وإجابته تعالىٰ، وقد مدح تعالىٰ نفسه في إجابته فإنَّ التقدير فلنعم المجيبون نحن، وجمع المجيب لإفادة التعظيم وقد كان نداء نوح، علىٰ ما يفيده السياق، دعاءه علىٰ قومه واستغاثته بربِّه(83)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قد نادىٰ: «ألا من ناصر ينصرنا، ألا من مغيث يغيثنا، ألا من معين يعيننا، ألا من ذابٍ يذبّ عنا»، لكنهم لم يستجيبوا له بل قتلوه وضربوه بالسيف والحجارة والنبال ورضوا جسده الشريف وطحنوا أضلاعه (صلوات الله عليه).
- الاستئصال: دعا نوح (عليه السلام) بهذا الدعاء عند ما يئس من هدايتهم بعد المشقّة والعناء في دعوته إيّاهم، فلم يؤمن إلّا قليل منهم: ﴿وَقالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَىٰ الْأَرضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً﴾ (نوح: 26) هذه الآيات تشير إلىٰ استمرار النبي نوح (عليه السلام) في حديثه ودعائه عليهم والتعبير بـ﴿عَلَىٰ الْأَرضِ﴾ يشير إلىٰ أنَّ دعوة نوح (عليه السلام) كانت تشمل العالم، وكذا مجيء الطوفان والعذاب بعده، و﴿دَيَّاراً﴾ علىٰ وزن سيار، من أصل دار، وتعني من سكن الدّار، وهذه اللفظة تأتي عادة في موارد النفي المطلق كقول: ما في الدار ديّار، أي ليس في الدار أحد(84)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً﴾ (نوح: 28)، دعاء من نوح علىٰ الظالمين بالضلال والمراد به الضلال مجازاة دون الضلال الابتدائي فهو دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم وفسقهم مضافاً إلىٰ ما سيحكي عنه من دعائه عليهم بالهلاك(85)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تباراً﴾ (نوح: 28) التبار الهلاك، والظاهر أنَّ المراد بالتبار ما يوجب عذاب الآخرة وهو الضلال وهلاك الدنيا بالغرق، وقد تقدَّما جميعاً في دعائه، وهذا الدعاء آخر ما نقل من كلامه (عليه السلام) في القرآن الكريم(86)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) دعا علىٰ أعدائه واستجاب له ربّه، قائلاً: «اللهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسنيِّ يوسف، وسلِّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبرة، فإنَّهم كذَّبونا وخذلونا، وأنت ربّنا عليك توكَّلت وإليك المصير»(87)، وقال (عليه السلام): «اللهم فامنعهم بركات الأرض، وإن منعتهم ففرِّقهم تفريقاً، ومزِّقهم تمزيقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا تُرضِ الولاة عنهم أبداً، فإنَّهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا يقاتلونا ويقتلونا»(88)، وقال (عليه السلام): «اللَّهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً»(89).
- الاستجابة والوعد بالنصر: قوله تعالىٰ: ﴿فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِـرْ﴾ (القمر: 10) الانتصار الانتقام، وقوله: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ﴾ أي بالقهر والتحكم دون الحجة(90)، والغلبة المذكورة في الآية الكريمة لم تكن غلبة في الحجّة والدليل أو البرهان علىٰ عدم صحّة الدعوة، وإنَّما كانت تتجسَّد بالظلم والجناية والتكذيب والإنكار وأنواع الزجر والضغوط(91)، فنصره وقال (عزَّ وجلَّ): ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأنبياء: 77)، وورد في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ نُوح المُجَابِ في دَعوَتِهِ» كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) وعده الله بالنصر، وقال (عزَّ من قائل): ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْـرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء: 33) قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، لَوْ قَتَلَ وَلِيُّهُ أَهْلَ الْأَرْضِ مَا كَانَ مُسْرِفاً، وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ (عليه السلام)»(92).
- النجاة: قوله تعالىٰ: ﴿وَنُوحاً إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (الصافات: 76) المراد من الأهل خواص أتباعه وأصحابه المؤمنين، فإنَّها علىٰ خلاف المعنىٰ المشهور للأهل، وأنَّ ﴿الْكَرْبِ﴾ في اللغة تعني الغمّ الشديد، وهي في الأصل مأخوذة من تقليب الأرض وحفرها، لأنَّ الغمّ الشديد يقلب قلب الإنسان، ووصفه بالعظيم يكشف عن منتهىٰ كربه وأساه(93)، وبمقتل الإمام الحسين (عليه السلام) نجىٰ دين الله والبشرية من الضلال، وأرشدهم للحق وسبيل الرشاد القويم.
- الفتح: قوله تعالىٰ: ﴿فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: 118)، (الفتح) معناه واضح، وهو ما يقابل الغلق ويضاده، وله استعمالان، فتارة يستعمل في القضايا المادية كفتح الباب مثلاً، وتارة يستعمل في القضايا المعنوية كفتح الهمّ ورفع الغمّ، وكفتح المستغلق من العلوم، وفتح القضية، أي بيان الحكم حسم النزاع(94)، قال الإمام الحُسين (عليه السلام): «إنَّ مَنْ لَحِقَ بي استُشهِد، وَمَن تَخَلَّفَ لَمْ يَبلغ الفَتْح»(95).
- المحمولون: قوله تعالىٰ: ﴿مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ﴾ (مريم: 58) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ المَحْمُولُونَ مَعَ نُوحٍ»(96).
- بقاء الذكر الحسن: قوله تعالىٰ: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الصافات: 78) المراد بالترك الإبقاء، وبالآخرين الأُمم الغابرة غير الأولين، أي إحياؤه تعالىٰ دعوة نوح (عليه السلام) إلىٰ التوحيد ومجاهدته في سبيل الله عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل إلىٰ يوم القيامة(97)، يقول القرآن: إنَّنا جعلنا لنوح ثناءً وذكراً جميلاً في الأجيال والأُمم اللاحقة(98)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) بقيَ وذكره خالداً علىٰ مرِّ العصور، قالت السيدة زينب للإمام زين العابدين (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ): «وينصب بهذا الطف عَلَماً لقبر أبيك الحسين (عليه السلام) لا يُدرس أثره، ولا يعفو رسمه، علىٰ كرور الليالي والأيام، وليجتهدنَّ أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلَّا ظهوراً وأمره إلَّا علواً»(99).
- بقاء الذرية: قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ﴾ (الصافات: 77) بأنَّ كلّ أجيال البشر التي أتت بعد نوح هي من ذريته(100)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) جعل الله الإمامة في ذريته(101) وأبقاهم خالدين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- الشكر: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً﴾ (الإسراء: 3) (شَكُور) صيغة مبالغة بمعنىٰ كثير الشكر(102)، وأنَّ حقيقة الشكر هو الإخلاص في العبودية(103)، فقد قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّمَا سُمِّيَ نُوحٌ (عليه السلام) عَبْداً شَكُوراً لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَىٰ: اللهمَّ إِنَّهُ مَا أَصْبَحَ وَأَمْسَىٰ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِيَةٍ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَمِنْكَ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ بِهِ عَلَيَّ يَا رَبِّ حتَّىٰ تَرْضَىٰ»(104)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قال: «اللَّهم لك الحمد والشكر بجميع محامدك كلِّها علىٰ جميع نعمائك كلِّها حتَّىٰ ينتهي الحمد إلىٰ ما تحب ربّنا وترضىٰ»(105).
- الوصي الثالث: النبي نوح (عليه السلام) هو الوصي الثالث للنبي إدريس (عليه السلام)، وولد في عهده، وهو من سمّاه من الله، وشهد الانقلاب الأُمَّة علىٰ أوصيائه الثلاثة، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك هو وصي النبي محمد (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وشهد الانقلابات بعده من السقيفة وغيرها، وما جرىٰ بعدها من مظالم لحقتهم(106).
- الأُبوة: يعد النبي نوح (عليه السلام) هو الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان، والإمام الحسين (عليه السلام) أبو الأئمة الأطهار (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- تمصير الأمصار: بعد الفيضان قام النبي نوح (عليه السلام) وأصحاب السفينة وأخذوا بالانتشار في الأرض وتعميرها، وتشييد المدن عليها حتَّىٰ صارت أمصار جديدة؛ وهذه كربلاء لم تكن قبل الإمام الحسين (عليه السلام) شيء، فها هي اليوم بعد مجيئه (عليه السلام) صارت وطناً ومقصداً يقصده الزوار من شتَّىٰ بقاع الأرض للزيارة، والبركة، والشفاء، وقضاء الحوائج، فلولاه لم تكن كربلاء كما هي اليوم.
- المواساة: وروي أنَّ النبي نوح (عليه السلام) لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا فلما مرَّت بكربلاء أخذته الأرض، وخاف نوح الغرق فدعا ربَّه وقال: (إلهي طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض، فنزل جبرئيل وقال: يا نوح في هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء، وابن خاتم الأوصياء، فقال: ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سماوات وسبع أرضين، فلعنه)(107).
الفصل الثالث: السَّلامُ علَيكَ يا وارِثَ إبراهيمَ خليلِ اللهِ
- مقام الخلة: قوله تعالىٰ: ﴿وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾ (النساء: 125)، إِنَّ كلمة (خليل) قد تكون مشتقة من المصدر (خلّة) علىٰ وزن (حجّة) الذي يعني الصداقة، وقد يكون اشتقاقها من المصدر (خلة) علىٰ وزن (ضربة) بمعنىٰ الحاجة، والخليل أخص من الصديق فإنَّ أحد المتحابّين يسمَّىٰ صديقاً إذا صدق في معاشرته ومصاحبته ثم يصير خليلاً إذا قصر حوائجه علىٰ صديقه(108)، وورد في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ إِبْراهِيم الَذي حَبَاهُ اللهُ بِخُلَّتِهِ»، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كما ورد في زيارته: «السَّلامُ عَلىٰ خَليلِ اللهِ وَابن خَليلِه»، وقد ورد في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ خَلِيلِ الله وَنَجِيبِهِ» وهذا أعلىٰ وأكبر.
- السلام: قوله تعالىٰ: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِبْراهِيمَ﴾ (الصافات: 109) تحية منه تعالىٰ عليه، وفي تنكير سلام تفخيم له(109)، لمّا امتاز به إبراهيم (عليه السلام) من صفات حميدة، خصّه الباري (عزَّ وجلَّ) بالسلام(110)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) وقد ورد في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ خَلِيلِ الله وَنَجِيبِهِ» وهذا أعلىٰ وأكبر، وورد عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) اسْمُهُ يَاسِينُ، وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ الله: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِلْياسِينَ﴾ [الصافات: 130]»(111)، وعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) قَالَ: «يَس مُحَمَّدٌ، وَنَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ»(112).
- الاصطفاء: قال الإمام الصادق (عليه السلام): «ثُمَّ اصْطِفَاءُ الله (عزَّ وجلَّ) إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ شَهَادَتُهُ لَهُ فِي الْعَاقِبَةِ أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فِي قَوْلِهِ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ﴾، وَالصَّالِحُونَ هُمُ النَّبِيُّ وَالْأَئِمَّةُ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) الْآخِذُونَ عَنِ الله أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَالمُلْتَمِسُونَ الصَّلاَحَ مِنْ عِنْدِهِ، وَالمُجْتَنِبُونَ لِلرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ فِي دِينِهِ»(113)، نعم، إبراهيم (عليه السلام) اصطفاه الله في الدنيا ليكون الأُسوة والقدوة للصالحين(114)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد جاء عن علي بن إبراهيم في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَلامٌ عَلىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ﴾ (النمل: 59) قال: (هُمْ آلُ مُحَمَدّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ))(115)، وقال ولده أَبُو الْحَسَنِ الإمَامُ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليهم السلام): «نَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا الله»(116)، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ صَفْوَةُ الله»(117)، وجاء في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ الله وَابْنِ صَفِيِّهِ»، وورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَوْلِياءَ اللهِ وَأَصْفِيائِهِ».
- الصحف: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ) لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداً (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، قَالَ: «وَقَدْ أَعْطَىٰ مُحَمَّداً جَمِيعَ مَا أَعْطَىٰ الْأَنْبِيَاءَ وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسىٰ﴾ [الأعلىٰ: 19]»، وقَالَ (عليه السلام): «إِنَّ عِنْدَنَا صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)»(118)، (الصحف) جمع و)صحيفة(، وهي اللوح الذي يكتب عليه(119)، وصحف إبراهيم ما نزل عليه من الكتاب والجمع للإشارة إلىٰ كثرته بكثرة أجزائه(120).
- بقاء الذكر الحسن: قوله تعالىٰ: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (الصافات: 108)، المراد بالترك الإبقاء، وبالآخرين الأُمم الغابرة غير الأولين، أي إحياؤه تعالىٰ دعوة نوح (عليه السلام) إلىٰ التوحيد ومجاهدته في سبيل الله عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل إلىٰ يوم القيامة(121)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كما قال الشاعر:
كَذَبَ المُوُتُ فَالُحُسَينُ مُخَلدُ * * * كُلَمَا مَر الزَمَانَ ذكرة يَتَجَدَدَ
- اللسان: قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّاً﴾ (مريم: 50) أنَّ «اللسان» في مثل هذه الموارد يعني الذكر الذي يذكر به الإِنسان بين الناس، وعندما نضيف إِليه كلمة صدق، ونقول: ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ فإِنَّه يعني الذكر الحسن والذكرىٰ الطيبة بين الناس، وإِذا ما ضممنا إِليها ﴿عَلِيَّاً﴾ التي تعني العالي والبارز، فإِنَّها ستعني الذكرىٰ الجميلة جدّاً التي تبقىٰ بين الناس عن شخص ما(122)، أنَّ المراد بلسان صدق كذلك أن يبعث الله بعده من يقوم بدعوته ويدعو إلىٰ ملَّته وهي دين التوحيد(123)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قَالَ أَبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «نَحْنُ لِسَانُ الله»(124).
- الرفض والتحرير: قوله تعالىٰ: ﴿تَالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (الأنبياء: 57-58)، أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالمُحَاجَّةِ بِاللِّسَانِ بَلْ كَسَّرَ أَصْنَامَهُمْ فِعْلَ واثِقٍ بِالله تَعَالَىٰ، مُوَطِّنٍ نَفْسَهُ عَلَىٰ مُقَاسَاةِ المَكْرُوهِ فِي الذَّبِّ عَنِ الدِّينِ، وَالتَّاءُ فِي ﴿تَالله﴾ تَخْتَصُّ فِي الْقَسَمِ بِاسْمِ الله وَحْدَهُ، وَالْوَاوُ تَخْتَصُّ بِكُلِّ مُظْهَرٍ(125)، وقوله: ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ﴾ الكيد التدبير الخفي علىٰ الشيء بما يسوؤه، بمعنىٰ تصميمه العزم علىٰ أن يكيد أصنامهم، وقوله: ﴿بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ دلالة علىٰ أنَّهم كانوا يخرجون من البلد أو من بيت الأصنام أحياناً لعيد كان لهم أو نحوه فيبقىٰ الجو خالياً، وقوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ – جِذَاذاً بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ كِسَراً وَقِطَعاً جَمْعُ جَذِيذٍ، وَهُوَ الْهَشِيمُ(126) – فالمعنىٰ فجعل الأصنام قطعاً مكسورة إلَّا صنماً كبيراً من بينهم، والمعنىٰ فكسر الأصنام وأبقىٰ كبيرهم لعل الناس يرجعون إلىٰ إبراهيم فيحاجهم ويبكتهم ويبين بطلان ألوهية أصنامهم(127)، فإنَّ النبي إبراهيم (عليه السلام) رافض للأصنام الحجرية ومكسرها، وسعىٰ لتحرير العقل البشري من إعلام النمرود وتحطيم الأصنام وتعليق الفأس برقبته، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قد نهض ليحرِّر العقل البشري والمسلم من إعلام السلطة الحاكمة آنذاك وتحطيم الأصنام البشرية(128).
- الطهارة: قوله تعالىٰ: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (الحج: 26) أنَّ مهمّة إبراهيم (عليه السلام) كانت تطهير البيت وما حوله من أي نجس ظاهر أو باطن، ومن أي صنم أو مظهر للشرك، من أجل أن يوجِّه عباد الرحمن قلوبهم وأبصارهم إليه تعالىٰ وحده في هذا المكان الطاهر، وليقوموا بأهمّ العبادات في هذه البقعة المباركة، ألا وهو الطواف والصلاة في محيط إيماني لا يخالطه شرك(129)، والمراد بالقائمين علىٰ ما يعطيه السياق هم الناصبون أنفسهم للعبادة والصلاة، والركع جمع راكع كسجد جمع ساجد، والسجود جمع ساجد كالركوع جمع راكع(130)، قد بنىٰ النبي إبراهيم (عليه السلام) الكعبة بعد الطوفان وطهرها، فصار الناس يحجّون ويدعون فيُستجاب لهم، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) حرمه طاهر، كما جاء في زيارة الأول من رجب: «أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ طاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْر طاهِر مُطَهَّر، طَهُرْتَ وَطَهُرَتْ بِكَ الْبِلادُ وَطَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ بِها وَطَهُرَ حَرَمُكَ».
- الوصية: قوله تعالىٰ: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾ (البقرة: 132) روي أنَّ الحسين (عليه السلام) أوصىٰ إلىٰ ابنه علي بن الحسين (عليه السلام)، وسلَّم إليه الاسم الأعظم، ومواريث الأنبياء، ونصَّ عليه بالإمامة من بعده(131).
- الذرية: قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ﴾ (مريم: 58) المراد من ذرية إِبراهيم إِسحاق وإسماعيل ويعقوب (عليهم السلام)(132)، وأن أهل البيت (عليهم السلام) يرجعون إلىٰ النبي إسماعيل (عليه السلام) عن طريق جدِّهم (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ ذُرِّيَّةُ إِبْرَاهِيمَ»(133)، وقوله: ﴿رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (إبراهيم: 37) مراده (عليه السلام) ببعض ذريته ابنه إسماعيل ومن سيولد له من الأولاد(134)، قَالَ الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ وَالله بَقِيَّةُ تِلْكَ الذُّرِّيَّةِ»(135)، وَعَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إلىٰ يَحْيَىٰ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ الله، وَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَ الله مِنْ أَوَّلِهِ إلىٰ آخِرِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ، قَالَ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَنْعَامِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ حتَّىٰ بَلَغَ وَيَحْيىٰ وَعِيسىٰ، قَالَ: أَلَيْسَ عِيسَىٰ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ؟ قَالَ: صَدَقْتَ(136).
- الهوي: قوله تعالىٰ: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ (إبراهيم: 37) الهوي بمعنىٰ السقوط أي تحن وتميل إليهم بالمساكنة معهم أو بالحج إلىٰ البيت فيأنسوا بهم(137)، قال أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام): «الأَفئِدة مَنْ النَاسِ تهوي إلينا، وذلك دَعُوة إبراهيم (عليه السلام)»(138).
- النداء: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلىٰ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (الحج: 27) التأذين: الإعلام برفع الصوت ولذا فسِّر بالنداء، أي نادِ الناس بقصد البيت أو بعمل الحج(139)، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: «لمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ أَمَرَهُ الله أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ فَقَالَ الله: أَذِّنْ عَلَيْكَ الْأَذَانُ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ، وَارْتَفَعَ عَلَىٰ المَقَامِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُلْصَقٌ بِالْبَيْتِ فَارْتَفَعَ المَقَامُ حتَّىٰ كَانَ أَطْوَلَ مِنَ الْجِبَالِ فَنَادَىٰ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ شَرْقاً وَغَرْباً، يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إلىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ فَأَجَابُوهُ مِنْ تَحْتِ الْبُحُورِ السَّبْعَةِ وَمِنْ بَيْنِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ إلىٰ مُنْقَطَعِ التُّرَابِ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَمِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ أَوَ لَا تَرَوْنَهُمْ يَأْتُونَ يُلَبُّونَ فَمَنْ حَجَّ مِنْ يَوْمِئِذٍ إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(140)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كَتَبَ: «أمّا بَعد، فإنَّه مَنْ لَحِقَ بي استُشهِد، وَمَن تَخَلَّفَ لَمْ يَبلغ الفَتْح»(141)، حتَّىٰ نادىٰ في عاشوراء: «ألا من ناصر ينصرنا، ألا من مغيث يغيثنا، ألا من ذاب يذب عنا، ألا من معين يعيننا»، فأُجابوه الخُلَّص بـ(لَبَّيْكَ داعِيَ اللهِ، إِنْ كانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اسْتِغاثَتِكَ وَلِسانِي عِنْدَ اسْتِنْصارِكَ فَقَدْ أَجابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي)(142)، أيْ حتَّىٰ مُستقبلاً، فإنَّ هذا يدلُ علىٰ وجوبِ نُصرةِ الحسينِ (عليه السلام) في كلِّ مكانٍ وزمانٍ ولو بعد الشهادة.
- التلبية والتزاحم: يأتي حجاج بيت الله كل موسم لأداء المناسك بأعداد كبيرة وهم يجيبون داعي الله النبي إبراهيم (عليه السلام) يلبّون بقولهم: (لبيك اللهم لبيك)، ويأتي زوار الإمام الحسين (عليه السلام) بأفواج غفيرة يتزاحمون حول ضريحه المقدَّس، يجيبون داعي الله بـ(لبيك يا حسين) لما استنصرهم ودعاهم بمناداته: «ألا ناصر ينصرنا، ألا من مغيث يغيثنا، ألا من معين يعيننا، ألا من ذاب يذب عنا».
- الذبح والتسليم: قوله: ﴿قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرىٰ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ… فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ… وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات: 102-107)، فالمعنىٰ فلما استسلما إبراهيم وابنه لأمر الله ورضيا به وصرعة إبراهيم علىٰ جبينه(143)، ﴿وَفَدَيْناهُ﴾ مشتقّة من الفداء وتعني جعل الشيء مكان الشيء لدفع الضرر عنه(144)، والمراد بعظمة الذبح عظمة شأنه بكونه من عند الله سبحانه وهو الذي فدىٰ به الذبيح(145)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قد ذُبِحَ من قفاه قدم ما عنده لله (عزَّ وجلَّ) حتَّىٰ نفسه الزكية، وأولاده، وإخوته، وأبناء عمومته، وأنصاره، ورد أنَّ الذبح العظيم هو الإمام الحسين (عليه السلام) كما ورد في زيارته: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ اِسْماعيلَ ذَبيحِ اللهِ» فقد ورد عَنِ الإمام الرضا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أنَّهُ قَالَ: «يَا بْنَ شَبِيبٍ إِنْ كُنْتَ بَاكِياً لِشَيءٍ فَابْكِ للحسين بن علي (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ»(146).
- التحمُّل: قوله تعالىٰ: ﴿قَالُواْ حَرِّقُوهُ﴾ (الأنبياء: 68) تحمل النبي إبراهيم (عليه السلام) العذاب لله تعالىٰ، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) سلم أمره لله وتوكل عليه عندما قتلوه صبراً وعذّبوه، وسبوا أهل بيته، وحرقوا خيامه فتحمَّل ذلك وقال: «هوّنَ عليَّ ما نَزَل بي أنّهَُ بعينِ الله»(147).
- الكلمات والإمامة: قوله تعالىٰ: ﴿إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ (البقرة: 124)، سأل المفضل الإمام الصادق (عليه السلام) قَالَ: «هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ الله عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾»، فَقُلْتُ لَهُ: يَا بْنَ رَسُولِ الله فَمَا يَعْنِي (عزَّ وجلَّ) بِقَوْلِهِ: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾؟ قَالَ: «يَعْنِي فَأَتَمَّهُنَّ إلىٰ الْقَائِمِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً تِسْعَةً مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)»، قَالَ المُفَضَّلُ: فَقُلْتُ: يَا بْنَ رَسُولِ الله فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِه (عزَّ وجلَّ): ﴿وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف: 28]؟ قَالَ (عليه السلام): «يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِمَامَةَ وَجَعَلَهَا الله فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(148).
هذه الفقرة من الآية تشير إلىٰ الاختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم (عليه السلام) بنجاح، وتبيَّن من خلالها مكانة إبراهيم وعظمته وشخصيته، وبعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاح استحق أن يمنحه الله الوسام الكبير ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَاماً﴾(149)، و﴿إمَاماً﴾ أي مقتدىٰ يقتدىٰ بك الناس، ويتبعونك في أقوالك وأفعالك، فالإمام هو الذي يقتدي ويأتم به الناس(150).
- الدَّعَّاء: قوله تعالىٰ: ﴿إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ قال أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «الْأَوَّاهُ هُوَ الدَّعَّاءُ»(151)، (الحليم) هو الذي لا يعاجل العقوبة والانتقام، (والأوّاه) كثير التأوُّه مما يصيبه أو يشاهده من السوء، (والمنيب) من الإنابة وهو الرجوع والمراد الرجوع في كل أمر إلىٰ الله(152)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كان كثير الدعاء والتضرُّع لله سبحانه وتعالىٰ حتَّىٰ في آخر رمقه المبارك، وقد جاء في الزيارة الناحية «كُنْتَ حَلِيمٌ، أوَّاهٌ، مُنِيبُ».
- الملكوت: قوله تعالىٰ: ﴿وكَذَلِكَ نُرِي إبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ والأرْضِ﴾ (الأنعام: 75) الملكوت من (ملك) بمعنىٰ المالكية والحكم (والواو والتاء) أُضيفتا للتوكيد والمبالغة، فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة علىٰ عالم الوجود برمته(153)، وكذلك فعل الإمام الحسين (عليه السلام) بليلة العاشر لما رأىٰ من أصحابه العزم والصمود والثبات والإخلاص فجزَّاهم خيراً، وقال: «إِنْ كنتم كذلك، فارفعوا رُؤوسَكُمْ وَانظروا إلىٰ منازلكم فِي الجنَّة»(154).
- الأُمَّة: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلهِ﴾ (النحل: 120) أي قائماً مقام جماعة في عبادة الله، والقنوت: الإطاعة والعبادة أو دوامها(155)، الأُمَّة إنَّما تطلق علىٰ الجماعة والفرد لكونهم ذوي هدف ومقصد(156)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، فِي قَوْلِ الله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ قَالَ: «يَعْنِي الْأُمَّةَ الَّتِي وَجَبَتْ لَهَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)، فَهُمُ الْأُمَّةُ الَّتِي بَعَثَ الله فِيهَا وَمِنْهَا وَإِلَيْهَا، وَهُمُ الْأُمَّةُ الْوُسْطَىٰ، وَهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس»(157)، فمعنىٰ الآية أنَّكم خير أُمَّة أظهرها الله للناس بهدايتها لأنَّكم علىٰ الجماعة تؤمنون بالله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المعلوم أن انبساط هذا التشريف علىٰ جميع الأُمَّة لكون البعض متَّصفين بحقيقة الإيمان والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(158).
- الشكر والاجتباء: قوله تعالىٰ: ﴿شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إلىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: 121)، الاجتباء من الجباية وهو الجمع واجتباء الله الإنسان هو إخلاصه لنفسه وجمعه من التفرُّق في المذاهب المختلفة، وأنَّ حقيقة الشكر هو الإخلاص في العبودية(159)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قال: «اللّهم لك الحمد والشكر بجميع محامدك كلّها علىٰ جميع نعمائك كلّها حتَّىٰ ينتهي الحمد إلىٰ ما تحب ربّنا وترضىٰ»(160)، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ المُجْتَبَوْنَ»(161).
- تمصير الأمصار: قوله تعالىٰ: ﴿رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ (إبراهيم: 37) هذه إشارة إلىٰ أوّل دخوله أرض مكّة والتي كانت غير مزروعة ولا معمورة ولا ساكن فيها سوىٰ أُسّس بيت الله الحرام، ومجموعة من الجبال الجرداء، فإنَّها لا زالت غير صالحة للزراعة، لأنَّها من الناحية الجغرافية تقع بين جبال يابسة وقليلة المياه(162)، فبعد مجيئه صارت تُقصد للحج شيئاً فشيئاً وصَلُحت للعيش؛ وهذه كربلاء لم تكن قبل قدوم الإمام الحسين (عليه السلام) شيء ذات شأن وكانت صحراء، فها هي اليوم بعد مجيئه صارت مقصداً يقصده الزوار من شتَّىٰ البقاع للزيارة، والبركة، والشفاء، وقضاء الحوائج، إذ لولاه لم تكن كما هي اليوم بهذا الرونق.
- الإطعام: قوله تعالىٰ: ﴿يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً﴾ (الإنسان: 8)، قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «ما اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً إلَّا لإطعامه الطعام»(163). وروي أنَّه وُجِدَ عَلَىٰ ظَهَرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ يَوْمَ الطف أَثَر فَسَأَلُوا زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَذَا مِمَّا كَانَ يَنْقُلُ الْجِرَابَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إلىٰ مَنَازِلَ الْأَرَامِلِ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ»(164).
- التهديد: هدَّد آزر النبي إبراهيم (عليه السلام) ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ (مريم: 46) لأنَّه دعاه إلىٰ عبادة الله فرفض وهدَّده، والانتهاء: الكف عن الفعل بعد النهي، والرجم: الرمي بالحجارة، والمعروف من معناه القتل برمي الحجارة(165)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) هدَّده أعداءه بالقتل إذا لم يبايع أو ينزل عن حكم أميرهم الفاسق، فأبىٰ (صلوات الله عليه وسلامه)، فجاءهم الأمر أن (اقتلوا الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة)(166)، وقد أنبأهم (عليه السلام) بذلك: «والله لا يدعوني حتَّىٰ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي»(167).
- الضيافة والجود والسخاء: قوله تعالىٰ: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ﴾ (الحجر: 51)، الضيف معروف ويطلق علىٰ المفرد والجمع(168)، وقوله: ﴿هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (الذاريات: 24) والتعبير بـ(المكرمين) إمّا لأنَّ هؤلاء الملائكة كانوا مأمورين من قبل الحقّ، ولأنَّ إبراهيم (عليه السلام) أكرمهم(169)، من مزايا الإمام الحسين (عليه السلام) الجود والسخاء، فقد كان الملاذ للفقراء والمحرومين، والملجأ لمن جارت عليه الأيام، وكان يُثلِج قلوب الوافدين إليه بِهِبَاتِه وعَطَايَاه، وكان يكرم الضيف، ويمنح الطالب، ويصل الرحم، ويسعف السائل، ويكسو العاري، ويشبع الجائع، ويعطي الغارم، ويشد من الضعيف، ويشفق علىٰ اليتيم، ويغني ذا الحاجة، وإن وَصَلَه مَال إلَّا فَرَّقَه، وهذه سَجيَّة الجواد، وشِنشِنَه الكريم، وسِمَة ذي السماحة، وصفة من قد حوىٰ مكارم الأخلاق، فأفعاله المَتلُوَّة شاهدة له بِصُنعِه الكرم، ناطقةً بأنَّه متَّصف بمَحاسِن الشيَم(170).
- البشارة: قوله تعالىٰ: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (الصافات: 101)، أي فبشَّرناه أنَّا سنرزقه غلاماً حليماً، وفيه إشارة إلىٰ أنَّه يكون ذكراً ويبلغ حدّ الغلمان، وأخذ الغلومة في وصفه مع أنَّه بلغ مبلغ الرجال للإشارة إلىٰ حاله التي يظهر فيها صفة كماله وصفاء ذاته وهو حلمه الذي مكَّنه من الصبر في ذات الله(171)، وكلمة ﴿حَلِيمٍ﴾ تعني الذي لا يعجِّل في الأمر قبل وقته مع القدرة عليه، ويمكن الاستفادة من العبارات المختلفة الواردة بلغة العرب في أنَّ كلمة ﴿غُلَام﴾ تطلق علىٰ الذكر الذي اجتاز مرحلة الطفولة ولم يصل بعد إلىٰ مرحلة الشباب، وقد ولد الطفل الموعود لإبراهيم وفق البشارة الإلهيّة، وأثلج قلب إبراهيم الذي كان ينتظر الولد الصالح لسنوات طوال، اجتاز الطفل مرحلة الطفولة(172)، وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «﴿فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ﴾، يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ مِنْ هَاجَرَ»(173). وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الحجر: 53) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «وَالْغُلاَمُ الْعَلِيمُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ [مِنْ] هَاجَرَ»(174)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد بُشِّرَ به النبي محمد (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل ولادته (عليه السلام)(175).
- السقم: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ قَالَ: «حَسَبَ فَرَأَىٰ مَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ (عليه السلام)، فَقَالَ: إِنِّي سَقِيمٌ لِمَا يَحُلُّ بِالْحُسَيْنِ (عليه السلام)»(176).
- القميص: عَنِ المُفَضَّلِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: قَالَ: «أَخْبِرْنِي مَا كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ»؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لمَّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ، أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ، فَلَمْ يُصِبْهُ مَعَهُ حَرٌّ وَلاَ بَرْدٌ، فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ المَوْتُ، جَعَلَهُ فِي تَمِيمَةٍ وَعَلَّقَهُ عَلَىٰ إِسْحَاقَ، وَعَلَّقَهُ إِسْحَاقُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ، فَلَمَّا وُلِدَ لِيَعْقُوبَ يُوسُفُ، عَلَّقَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ فِي عُنُقِهِ، حتَّىٰ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، فَلَمَّا أَخْرَجَ يُوسُفُ الْقَمِيصَ مِنَ التَّمِيمَةِ، وَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ وَهُوَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ»، قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِلَىٰ مَنْ صَارَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ؟ فَقَالَ: «إلىٰ أَهْلِهِ»، ثُمَّ قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ وَرَّثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدِ انْتَهَىٰ إلىٰ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) وَكَانَ يَعْقُوبُ بِفِلَسْطِينَ وَفَصَلَتِ الْعِيرُ مِنْ مِصْرَ فَوَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الْقَمِيصِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ وَنَحْنُ وَرَثَتُهُ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)»(177).
- الأُبُوة: إنَّ النبي إبراهيم (عليه السلام) أبو الأنبياء والرسل بعد النبي نوح (عليه السلام)، والإمام الحسين (عليه السلام) أبو الأئمة والأوصياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
- الصلاة: اللهمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلىٰ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَحَنَّنْ عَلىٰ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَسَلِّمْ عَلىٰ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، كَأًفْضَلَ ما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ وَسَلَّمْتَ عَلىٰ إِبْراهيمَ وَآلِ إِبْراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.
- الابتلاء: ابتُلي كلاهما بالعيش بزمن الطاغية، فالنبي إبراهيم (عليه السلام) عاش في زمن النمرود، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) عاش في زمن يزيد.
- عدم رد الطلب: عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «إنَّما اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً لأنَّه لم يردّ أحداً»(178)، والإمام الحسين (عليه السلام) باب الله لقضاء الحوائج.
- ترك الأهل: ترك النبي إبراهيم (عليه السلام) أهله بصحراء مكة بأمر الله (عزَّ وجلَّ) فقالت له زوجه: (يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا)(179).
وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) عند وداعه دعا النساء بأجمعهنَّ، وقال لهنَّ: «استعدّوا للبلاء، واعلموا أنَّ الله حافظكم وحاميكم، وسينجيكم من شرّ الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلىٰ خير، ويعذِّب أعاديكم بأنواع العذاب، ويعوّضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشْكُوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم»(180).
- المواساة: ورد أنَّ النبي إبراهيم (عليه السلام) مرَّ في أرض كربلاء وهو راكب فرساً، فعثرت به وسقط (عليه السلام) وشجّ رأسه وسال دمه، فأخذ في الاستغفار، وقال: إلهي أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه، قال: يا جبرئيل ومن يكون قاتله؟ قال: اللعين يزيد، والقلم جرىٰ علىٰ اللوح بلعنه بغير إذن ربِّه، فأوحىٰ الله إلىٰ القلم أنَّك استحقيت الثناء بهذا اللعن، فرفع إبراهيم (عليه السلام) يديه ولعن يزيد لعناً كثيراً وأمَّن فرسه بلسان فصيح، فقال إبراهيم لفرسه: أي شيء عرفت حتَّىٰ تؤمِّن علىٰ دعائي؟ فقال: يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك عليَّ، فلما عثرت وسقطت عن ظهري أخجلني، وكان سبب ذلك من يزيد(181).
الفصل الرابع: السَّلامُ علَيكَ يا وارِثَ موسىٰ كليِم اللهِ
- التكليم: قوله تعالىٰ: ﴿وَكَلَّمَ الله مُوسَىٰ تَكْلِيماً﴾ (النساء: 164)، والمراد بالكلام هو ما شافه به الله سبحانه من غير واسطة ملك، وبعبارة أخرىٰ هو ما يكشف به عن مكنون الغيب، أمّا أن يكون من نوع الكلام الدائر بيننا معاشر الإنسان فلا(182)، وكلَّم الله الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله (عزَّ وجلَّ): ﴿يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلىٰ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر: 27)، وروي أنَّه لما قتل رضيعه (عليه السلام) نودي: «دَعه يا حسين فإنَّ له مرضعاً في الجنَّة»(183).
- الاصطفاء: قوله تعالىٰ: ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلامِي﴾ (الأعراف: 144) (اصطفىٰ) أصله اصتفىٰ وهو افتعل من صفا يصفو انقلبت التاء طاء لمكان الصاد، ومعناه تخيرتك وخصصتك، ولا تستعمل إلَّا في الخير والمنن، لا يقال اصطفاه لشرٍّ، وقوله عَلَىٰ النَّاسِ عام والمراد الخصوص فيمن شارك موسىٰ في الإرسال(184)، والمراد بالرسالات هو ما حمل من الأوامر والنواهي الإلهية من المعارف والحكم والشرائع ليبلغه الناس(185)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد جاء عن علي بن إبراهيم في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَلامٌ عَلىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ﴾ (النمل: 59) قال: هُمْ آلُ مُحَمَدّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)(186)، وقال ولده أَبُو الْحَسَنِ الإمَامُ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): «نَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا للهُ»(187)، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ صَفْوَةُ الله»(188)، وجاء في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ الله وَابْنِ صَفِيِّهِ»، وورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَوْلِياءَ اللهِ وَأَصْفِيائِهِ».
- المحبة: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (طه: 39) معنىٰ إلقاء محبة منه عليه كونه بحيث يحبّه كل من يراه كأنَّ المحبَّة الإلهية استقرَّت عليه فلا يقع عليه نظر ناظر إلَّا تعلَّقت المحبَّة بقلبه وجذبته إلىٰ موسىٰ، وليحسن إليك علىٰ عيني أي بمرأىٰ مني فإنّي معك أراقب حالك ولا أغفل عنك لمزيد عنايتي بك وشفقتي عليك(189)، فَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: «أَلْقَىٰ الله فِي قَلْبِ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ مَحَبَّةً شَدِيدَةً، وَكَذَلِكَ فِي قَلْبِ آسِيَةَ»(190)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كما ورد في زيارته: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبيبَ اللهِ وابْنَ حَبيبِهِ»، وقَالَ أَبو جَعْفَر (عليه السلام): «نَحْنُ عَيْنُ الله»(191).
- الصنائع: قوله تعالىٰ: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ الاصطناع افتعال من الصنع بمعنىٰ الإحسان، المراد بالاصطناع الاختيار، ومعنىٰ اختياره لنفسه جعله حجة بينه وبين خلقه كلامه ودعوته، وأنَّ المراد بقوله: ﴿لِنَفْسِي﴾ لوحيي ورسالتي(192)، (اصطناع) من مادة (صنع) بمعنىٰ الإصرار والإقدام الأكيد علىٰ إصلاح شيء، ويعني أنّني قد أصلحتك من كل الجهات وكأنني أريدك لي، وهذا الكلام هو أكثر ما يمكن أن يقال في تصوير محبَّة الله لهذا النّبي العظيم(193)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قال أميرُ المؤمنينَ (عليه السلام): «إنَّا صَنَائِعُ رَبِّنا»(194).
- السلام: قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (الصافات: 120) سلام من عند الله العظيم والرحيم، السلام الذي هو رمز لسلامة الدين والإيمان والرسالة والاعتقاد والمذهب، السلام الذي يوضِّح النجاة والأمن من العقاب والعذاب في هذه الدنيا وفي الآخرة(195)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) اسْمُهُ يَاسِينُ، وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ الله: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِلْياسِينَ﴾ [الصافات: 130]»(196)، وعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) قَالَ: «يَس مُحَمَّدٌ، وَنَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ»(197).
- الوجيه: قوله تعالىٰ: ﴿كَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهاً﴾ (الأحزاب: 69)، أي ذا جاه ومنزلة(198)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد في دعاء التوسل: «يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، يَا حُجَّةَ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إلىٰ اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللهِ».
- باب حطَّة: قوله تعالىٰ: ﴿ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ (البقرة: 58)، كلمة (حطَّة) في اللغة، تأتي بمعنىٰ التناثر والمراد منها في هذه الآية الشريفة، نطلب منك أن تحطّ ذنوبنا وأوزارنا، أمرهم الله سبحانه أن يردّدوا من أعماق قلوبهم عبارة الاستغفار المذكورة، ويدخلوا الباب(199)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) هو باب حطة فقد جاء في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ حِطَّةٍ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كانَ مِنَ الآمِنِينَ»، وقَالَ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ»(200)، «نَحْنُ بَابُ حِطَّتِكُمْ كَبَابِ حِطَّةِ بَنِي إِسْرَائِيل»(201).
- الأُخوة: قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِياً﴾ (مريم: 53) ليكون معينه ونصيره، فقد كان يسعىٰ جنباً إلىٰ جنب مع أخيه في أداء هذه الرسالة الثقيلة(202)، وأنَّ النبي هارون (عليه السلام) عاش في زمن أخيه وتوفي قبله(203)؛ وأعطىٰ الله الإمام الحسين (عليه السلام) العباس (عليه السلام) الأخ المخلص والمواسي، وقد ورد في زيارته عن الإمام الصادق (عليه السلام) قائلاً: «فَنَعَمْ الْأَخُ المَوَاسِي لِأَخِيهِ»، وقد استشهد قبله في الطف.
- إضاءة أعضاء الجسد: قوله تعالىٰ: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ (الأعراف: 108)، إشارة إلىٰ أن بياض اليد ليس من برص ونحوه، بل هو بياضٌ نوراني يلفت النظر، وهو بنفسه كاشف عن إعجاز وأمر خارق للعادة(204)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد روىٰ السيد ابن طاووس (أنَّ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَان إِذَا جَلَسَ فِي اَلمَكَانِ اَلمُظْلِمِ يَهْتَدِي إِلَيْهِ اَلنَّاسُ بِبَيَاضِ جَبِينِهِ ونَحْرِهِ)(205). وورد أن رأسه الشريف كان يضيء لحملة الرؤوس الفساق وطريقهم المظلم إلىٰ الشام ويزيد الفاجر.
- الحجر: قوله تعالىٰ: ﴿اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ﴾ (البقرة: 60)، وقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إلىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً﴾ (الأعراف: 160)، ورد الفعل (انفجر) ليعبِّر عن تدفق الماء من الحجر، بينما ورد الفعل (انبجس) ليشير إلىٰ نفس الحقيقة مع فارق هو أنَّ الأول يفصح عن شدَّة تدفّق الماء، والثاني عن سيلانه بشكل هادئ(206)، كذلك حال الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ذكرت الروايات أنَّه لما قتل الحسين (عليه السلام) ما رفع حجر في الدنيا إلَّا وتحته دم عبيط(207).
- العصا: قوله تعالىٰ: ﴿ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسىٰ﴾ (طه: 17) فأجاب موسىٰ: ﴿قَالَ هِيَ عَصايَ﴾ ولما كان راغباً في حديثه مع محبوبه الذي فتح الباب بوجهه لأوّل مرّة، وربّما كان يظن أيضاً أنَّ قوله: ﴿هِيَ عَصايَ﴾ غير كاف، فأراد أن يبيِّن آثارها وفوائدها فأضاف: ﴿أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرىٰ﴾ (طه: 17-18)(208)، (العصا) معروفة وهي من المؤنثات السماعية، والتوكي والاتِّكاء علىٰ العصا الاعتماد عليها، (والهش) هو خبط ورق الشجرة وضربه بالعصا لتساقط علىٰ الغنم فيأكله، (والمآرب) جمع مأربة مثلثة الراء وهي الحاجة، والمراد بكون مآربه فيها تعلق حوائجه بها من حيث إنَّها وسيلة رفعه(209)، والإمام الحسين (عليه السلام) وارثها فقد قال ولده الإمام الباقر (عليه السلام): «عَصَا مُوسَىٰ عِنْدَنَا، ونَحْنُ وَرَثَةُ النَّبِيِّينَ» (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)» (210).
- الألواح والصحف: قوله تعالىٰ: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: 145)، اللوح صحيفة معدة للكتابة فيه لأنَّه يلوح ويظهر بما فيه من الخط(211)، عن علي بن إبراهيم القمي قال: أَنْزَلَ الله عَلَىٰ مُوسَىٰ الْأَلْوَاحَ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْأَخْبَارِ وَالسُّنَنِ وَالْقِصَصِ(212)، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: قَالَ لِي: «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ) لَمْ يُعْطِ الْأَنْبِيَاءَ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ أَعْطَاهُ مُحَمَّداً (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)»، قَالَ: «وَقَدْ أَعْطَىٰ مُحَمَّداً جَمِيعَ مَا أَعْطَىٰ الْأَنْبِيَاءَ وَعِنْدَنَا الصُّحُفُ الَّتِي قَالَ الله (عزَّ وجلَّ) ﴿صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسىٰ﴾ [الأعلىٰ: 19]»(213)، قال الإمام الباقر (عليه السلام): «أَلْوَاحُ مُوسَىٰ (عليه السلام) عِنْدَنَا…، ونَحْنُ وَرَثَةُ النَّبِيِّينَ (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(214).
- القبلة: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إلىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (يونس: 87)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) هو قبلة فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): «نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ، وَنَحْنُ كَعْبَةُ الله، وَنَحْنُ قِبْلَةُ الله»(215)، قَالَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «إِنَّ الله أَوْحَىٰ إلىٰ نَبِيِّهِ مُوسَىٰ أَنِ ابْنِ لِي مَسْجِداً طَاهِراً لاَ يَسْكُنُهُ إلَّا أَنْتَ وَهَارُونُ وَابْنَا هَارُونَ، وَإِنَّ الله أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِداً طَاهِراً لاَ يَسْكُنُهُ إلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَا عَلِيٍّ»(216)، وقد ورد في زيارته: «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ»، وها هي كربلاء ومراقد أهل البيت (عليهم السلام) أمست قبلة ومقصداً للزائرين والمحبين.
- الآيات التسع: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ وهي: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفدع والدم والسنون ونقص من الثمرات فالظاهر أنَّها هي المرادة(217)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) آتاه الله تسع أئمة آيات بيِّنات أئمة حق من ذريته (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- السير بالأهل: قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ (القصص: 29) لما سئل الإمام الحسين (عليه السلام) قائلاً: فما معنىٰ حملِكَ هؤلاءِ النساءِ معكَ؟ قالَ: «شاءَ اللهَ أن يراهنَّ سبايا»(218).
- القلة: قوله تعالىٰ: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ﴾ (يونس: 83)، إِنّ هذه المجموعة الصغيرة القليلة، والتي كان الشباب والأشبال يشكّلون أكثريتها بمقتضىٰ ظاهر كلمة ذرية، كانت تواجه ضغوطاً شديدة من فرعون وأتباعه(219)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) لم يكن معه إلَّا القليل.
- الجوع والعطش: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ… فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 22-24) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، أَنَّهُ قَالَ: … رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلىٰ شِقِّ تَمْرَةٍ(220)، سؤال طعام يسد به الجوع(221)، أجل إنَّه متعب وجائع، ولا أحد يعرفه في هذه المدينة، فهو غريب(222)، كذلك الإمام الحسين فقد قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّ الحُسَينَ (عليه السلام) قُتِلَ حَزيناً مَكروباً، شَعِثاً مُغبَراً، جائِعاً عَطشاناً»(223).
- الخوف علىٰ الدين: قوله تعالىٰ: ﴿فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (القصص: 21) فقد روي أنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) فخرجَ من تحتِ ليلتِه وهي ليلةُ الأحدِ ليومين بَقِيا من رجبٍ متوجِّهاً نحوَ مكّةَ ومعَه بنوه وإخوتُه وبنو أخيه وجُلُّ أهلِ بيتهِ(224).
- النجاة: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (الشعراء: 65) بمقتل الإمام الحسين (عليه السلام) نجىٰ دين الله والبشرية من الضلال، وأُرشدوا للحق وسبيل الرشاد.
- النصر: قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (الشعراء: 61) أي أنَّ الله معه يحفظه وينصره وهي التي وعدها له ربه(225)، إذ كان موسىٰ يعلم أنَّ الله معه في كل مكان، وخاصّة تعويله في كلامه علىٰ كلمة (ربّي) أي الله المالك والمربّي(226)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قَالَ الإمام الباقر (عليه السلام): «الْحُسَيْنُ (عليه السلام) قُتِلَ وَلَمْ يُنْصَرْ بَعْدُ»(227).
- النصيحة: قدم النبي موسىٰ النصح لقومه بقوله: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىٰ بَارِئِكُمْ﴾ (البقرة: 54) وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) نصح كما جاء في زيارة الأربعين «مَنَحَ النُّصحَ، وَبَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ لِيَستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الجَهالَةِ وَحَيرَةِ الضَّلالَةِ».
- الطاغية: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ… إِنَّهُ كانَ مِنَ المُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 4) فقد كان عبداً ضعيفاً، وعلىٰ أثر جهله وعدم معرفته أضاع شخصيته ووصل إلىٰ مرحلة من الطغيان حتَّىٰ أنَّه ادَّعىٰ الربوبية(228)، العلو في الأرض كناية عن التجبُّر والاستكبار(229)، ابتُلي كلاهما بالعيش بزمن الطاغية، فالنبي موسىٰ (عليه السلام) عاش في زمن فرعون، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) عاش في زمن يزيد.
- الاستحياء: قوله تعالىٰ: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: 49) روي أنَّ سيد الساجدين (عليه السلام) خرج يوماً يمشي في أسواق دمشق فاستقبله المنهال بن عمرو فقال: كيف أمسيت يا بن رسول الله، قال: «أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم»(230).
- التيه والحيرة والضلال: قوله تعالىٰ: ﴿يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (المائدة: 26)، التيه التحيُّر(231)، وهذه إشارة إلىٰ أنَّ كثيراً من الناس يتيهون في الأسباب وينسون قدرة الله سبحانه وتعالىٰ(232)، قَالَ أَميرُ المُؤمِنينَ (عليه السلام): «لعمري لَيُضعَفَنَ عليكُمُ التِّيْهُ مِنْ بَعْدِي بِاضطِهَادِكُم ولدِي ضِعفَ ما تَاهَتْ بَنُو إسرائيل»(233)، وقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «لمَّا ضُرِبَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ رَأْسُهُ، ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ، نَادَىٰ مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ العَرْشِ: أَلا أَيَّتُهَا الأُمَّةُ المُتَحَيِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّها، لا وَفَّقَكُمُ اللهُ لأَضْحىٰ وَلا لِفِطْرٍ»، قال: ثُمَّ قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ (عليه السلام): «فَلا جَرَمَ وَاللهِ مَا وُفِّقُوا وَلا يُوَفَّقُونَ حتَّىٰ يَثْأرَ ثَائِرُ الحُسَيْنِ (عليه السلام)»(234)، وَقَالَ أَميرُ المُؤمِنينَ (عليه السلام): «وَالَّذِي نَفْسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَعْدَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ ابْنِي فِي ضَلَالٍ وَظُلْمٍ وَعَسْفٍ وَجَوْرٍ وَاخْتِلَافٍ فِي الدِّينِ وَتَغْيِيرٍ وَتَبْدِيلٍ لِمَا أَنْزَلَ الله فِي كِتَابِهِ وَإِظْهَارِ الْبِدَعِ وَإِبْطَالِ السُّنَنِ وَاخْتِلَالٍ وَقِيَاسِ مُشْتَبِهَاتٍ وَتَرْكِ مُحْكَمَاتٍ حتَّىٰ تَنْسَلِخَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَتَدْخُلَ فِي الْعَمَىٰ وَالتَّلَدُّدِ وَالتَّسَكُّعِ»(235).
- الإفساد: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَقَضَيْنا إلىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ (الإسراء: 4) قَالَ: «قَتْلُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)، وَطَعْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) ﴿وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً﴾ قَالَ: قَتْلُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)»(236).
- الأذىٰ: قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ﴾ (الصف: 5) إشارة إلىٰ إيذاء بني إسرائيل رسولهم موسىٰ (عليه السلام) ولجاجهم حتَّىٰ آل إلىٰ إزاغة الله قلوبهم(237)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد آذوه أشد أذية فقد قال الإمام الباقر (عليه السلام): «لَقَد قُتِلَ بِالسَّيفِ وَالسِّنانِ، وبِالحِجارَةِ وبِالخَشَبِ وبِالعِصِيِّ، ولَقَد أوطَؤوهُ الخَيلَ بَعدَ ذلِكَ»(238)، وقد جاء في الزيارة الناحية: «نَكَّسُوكَ عَنْ جَوَادِكَ، فَهَوَيْتَ إلىٰ الأرْضِ جَرِيْحاً، تَطَؤُكَ الخُيولُ بِحَوَافِرِهَا، وَتَعْلُوكَ الطُّغَاةُ بِبَوَاتِرِها».
- الاستكبار والتكذيب والقتل: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: 87] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «ذَلِكَ مِثْلُ مُوسَىٰ وَالرُّسُلِ مِنْ بَعْدِهِ وَعِيسَىٰ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، ضَرَبَ مَثَلاً لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، فَقَالَ الله لَهُمْ: فَإِنْ جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ بِمُوَالاَةِ عَلِيٍّ اسْتَكْبَرْتُمْ؛ فَفَرِيقاً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ كَذَّبْتُمْ، وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ، فَذَلِكَ تَفْسِيرُهَا فِي الْبَاطِنِ»(239).
- العِجل: قوله تعالىٰ: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ﴾ وقوله: ﴿لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً﴾ كما أنَّ النبي موسىٰ (عليه السلام) حطم العجل ونسفه وقاتل السامري بأهله وقومه، فقد ورد أنَّ العجل في زمن الإمام الحسين (عليه السلام) تأويلاً هو يزيد فقد قاتله (عليه السلام) بأهل بيته وأصحابه وأيقظ الأُمَّة من سباتها، ونبهها من غفلتها، ونسفه بدمه الزكي(240).
- انتقام الله: قوله تعالىٰ: ﴿فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ﴾ (الأعراف: 133) انتقم الله (عزَّ وجلَّ) من الظالمين بأحد آياته وهو الدم، وثورة الإمام الحسين (عليه السلام) هي ثورة انتصار دم المظلوم علىٰ الظالم.
- المسخ: قوله تعالىٰ: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (البقرة: 65) أي صاغرين(241)، إشارة إلىٰ فورية المسخ الذي تمّ بأمر إلهي واحد(242)، مسخ الله (عزَّ وجلَّ) العاصين من بني إسرائيل جسدياً فحولهم إلىٰ قردة وخنازير؛ ومسخ الله قلوب أعداء الإمام الحسين (عليه السلام) وقد قال: «كأني بأوصالي تقطّعه عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء»(243)، وجاء في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ الأجْسَامِ العَارِيَةِ في الفَلَوَاتِ، تَنْهَشُهَا الذِّئَابُ العَادِيَاتُ».
- الإجابة: قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ من سؤال العذاب الأليم لفرعون وملئه(244)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) وقد مرَّ بيان إجابة دعائه في استئصال النبي نوح (عليه السلام) لقومه.
- التصدّي للانحراف: تصدَّىٰ النبي موسىٰ (عليه السلام) لتصحيح انحراف الظالمين والإعلام الفرعوني، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) تصدّي لتصحيح انحراف ظالمي زمانه وإعلامهم(245).
- المواساة: إنَّ النبي موسىٰ (عليه السلام) كانَ ذاتَ يومٍ سائراً ومعهُ يوشعُ بنُ نون، فلمّا جاءَ إلىٰ أرضِ كربلاءَ انخرقَ نعله، وانقطعَ شِراكه، ودخلَ الحسكُ في رجليه، وسالَ دمُه، فقالَ: إلهي أيُّ شيء حدثَ منّي فأُوحي إليهِ: «إنَّ هُنا يُقتلُ الحُسينُ، وهُنا يُسفكُ دمُه، فسالَ دمُك موافقةً لدمِه، فرفعَ موسىٰ يديهِ ولعنَ يزيد ودعا عليهِ، وأمَّنَ يوشعُ بنُ نون علىٰ دعائه»(246).
الفصل الخامس: السَّلامُ علَيكَ يا وارِثَ عيسىٰ روُحِ الله
- روح الله وكلمته: قوله: ﴿كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ (النساء: 171)، هذه إِشارة إلىٰ كون المسيح مخلوقاً بشرياً، إِذ إنَّ الكلمات مخلوقة من قبل الله، كما أنَّ الموجودات في الكون من مخلوقاته (عزَّ وجلَّ)، وقوله: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ تدل علىٰ عظمة تلك الروح التي خلقها الله تعالىٰ وأودعها في أفراد البشر بصورة عامّة، وفي المسيح (عليه السلام) وسائر الأنبياء بصورة خاصّة(247)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قال جدّه رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «نَحْنُ كَلِمَةُ الله»(248)، وقال أَميرُ المُؤمِنينَ (عليه السلام): «نَحْنُ رُوْحُ اللهِ وكَلِماتُه»(249).
- البشارة: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ يُبَشِّـرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَـىٰ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (البقرة: 253)، أي يبشركِ ببشارة هي أنَّكِ ستلدين عيسىٰ من غير مس بَشَرَ(250)، قبل ولادته وكذلك والإمام الحسين (عليه السلام) بُشِّرَ به النبي محمد (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل ولادته(251).
- النطق: قوله تعالىٰ: ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً﴾ (المائدة: 110)، أي أنَّ كلامك في المهد، مثل كلامك وأنت كهل، كلام ناضج ومحسوب، لا كلام طفل غر(252)، ورد أنَّ نحر الإمام الحسين (عليه السلام) نطق، ورأسه المبارك نطق سبع مرات وهو فوق السنان(253).
- البركة: قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ﴾ (مريم: 31)، كونه (عليه السلام) مباركاً أين ما كان هو كونه محلّاً لكل بركة والبركة نماء الخير كان نفّاعاً للناس يعلمهم العلم النافع ويدعوهم إلىٰ العمل الصالح ويربّيهم تربية زاكية ويبرئ الأكمه والأبرص ويصلح القوي ويعين الضعيف(254)، كذلك هو الإمام الحسين (عليه السلام) لما ورد في الزيارة الجامعة: «السَّلامُ عَلىٰ مَساكِنِ بَرَكَةِ الله».
- روح القدس: قوله تعالىٰ: ﴿أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (المائدة: 110) قَالَ الْإِمَامُ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): «وَهُوَ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام)»(255)، إن (روح القدس(هو القوّة الغيبية التي أيَّدت عيسىٰ (عليه السلام)، وبهذه القوة الخفية الإلهية كان عيسىٰ يحيي الموتىٰ(256)، وقالَ الإمام الباقر (عليه السلام): «فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ خَمْسَةُ أَرْوَاحٍ رُوحُ الْبَدَنِ وَرُوحُ الْقُدُسِ وَرُوحُ الْقُوَّةِ وَرُوحُ الشَّهْوَةِ وَرُوحُ الْإِيمَانِ»(257)، وَقَالَ الإمام الرِّضَا (عليه السلام): «إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ) قَدْ أَيَّدَنَا بِرُوحٍ مِنْهُ مُقَدَّسَةٍ مُطَهَّرَةٍ»(258).
- إقامة الصلاة: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴾ (مريم: 31)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) لما ورد في زيارته: «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَآتَيْتَ الزَّكاةَ وَأَمَرْتَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ».
- الحنين الرؤوف: قوله تعالىٰ: ﴿وَبَرّاً بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً﴾ أي جعلني حنيناً رؤوفاً بالناس ومن ذلك أنّي برّ بوالدتي ولست جبّاراً شقيّاً بالنسبة إلىٰ سائر الناس، والجبار هو الذي يحمل الناس ولا يتحمَّل منهم(259)، بل كان متواضعاً، عارفاً بالحق، وسعيداً(260)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام).
- المقرَّبين: قوله تعالىٰ: ﴿وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ (آل عمران: 45) الوجاهة هي المقبولية، وكونه (عليه السلام) مقبولاً في الدنيا مما لا خفاء فيه، وكذا في الآخرة بنص القرآن، ومعنىٰ المقرّبين ظاهر فهو مقرَّب عند الله داخل في صف الأولياء والمقربين من الملائكة من حيث التقريب وذلك قوله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ المُقَرَّبُونَ﴾ (الواقعة: 11)، وأنت إذا تأملت كون المقربين صفة الأفراد من الإنسان وصفة الأفراد من الملائكة علمت أنَّه لا يلزم أن يكون مقاماً اكتسابياً فإنَّ الملائكة لا يحرزون ما أحرزوه من المقام عند الله سبحانه بالكسب فلعله مقام تناله المقربون من الملائكة بهبة إلهية والمقربون من الإنسان بالعمل(261)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد في دعاء التوسل: «يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، يَا حُجَّةَ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إلىٰ اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللهِ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللهِ».
- الحياة: قوله تعالىٰ: ﴿وما قَتَلُوهُ يَقِيناً بَلْ رَفَعَهُ الله﴾ (النساء: 157-158)، أي ما قتلوه قتل يقين أو ما قتلوه أخبرك خبر يقين(262)، يؤكّد القرآن الكريم علىٰ أنَّ المسيح (عليه السلام) لم يقتل ولم يصلب(263)، وبقي حياً، لكن الإمام الحسين (عليه السلام) قتلوه بجسده وسحقوه بخيولهم، لكنه بقي حياً في القلوب والضمائر، وقد ورد عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ يَمُوتُ مِنَّا وَلَيْسَ بِمَيِّتٍ وَيَبْلَىٰ مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَلَيْسَ بِبَالٍ»(264)، أي مصداقاً لقوله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (البقرة: 154).
- الهداية: قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ المَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ الله﴾ (المائدة: 72)، إنَّ هداية الخلق من وظائف الأنبياء والأئمة، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك كما جاء في الزيارة الجامعة «السَّلَامُ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ».
- الإبراء والإحياء: قوله تعالىٰ: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي المَوْتَىٰ بِإِذْنِ الله﴾ (آل عمران: 49) كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد أحيا القلوب والضمائر الميتة، وشفيت العديد الأمراض ببركته وتربته.
- الصديقة: قوله تعالىٰ: ﴿أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ (المائدة: 75) كلاهما أمهاتهم صدّيقة، ويدَّعيان باسم أُمَّهاتهم، فالنبي عيسىٰ (عليه السلام) ابن مريم الصدّيقة، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد في زيارته: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ».
- المطهرة وسيدة النساء: قوله تعالىٰ: ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: 42) أي اصطفاك لذرية الأنبياء اختارك لتكوني ذرية صالحة جديرة للانتساب إلىٰ الأنبياء، ومعنىٰ قوله: ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ أي من السفاح أعطاك العصمة منه(265)، فإنَّ كلاهما أُمَّهاتهم سيدة نساء العالمين ومطهَّرات، فالنبي عيسىٰ (عليه السلام) أُمّه مريم سيدة نساء العالمين في زمانها، والإمام الحسين (عليه السلام) ابنُ سيدة نساء العالمين أجمعين من الأولين والآخرين، فقد ورد في زيارته: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ».
- آية: قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 91) أفرد الآية فعدَّهما أعني مريم وعيسىٰ (عليه السلام) معاً آية واحدة للعالمين؛ لأنَّ الآية هي الولادة وكفىٰ لها فخراً أن يدخل ذكرها في ذكر الأنبياء (عليهم السلام) في كلامه تعالىٰ وليست منهم(266)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) وذريته وأُمّه الصديقة آيات للعالمين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- الأنصار: قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلىٰ الله قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (الصف: 14) لما انقسم المجتمع إلىٰ كافر ومؤمن، نهض النبي عيسىٰ (عليه السلام) بحوارييه، وهم أصحاب جدّه عمران، وزكريا ابن عم عمران وصهره، ويحيىٰ سبط عمران، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) لما انقسموا نهض بأنصاره، وهم أصحاب جده محمد (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، وأبيه علي (عليه السلام) ابن عم النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وصهره، وأخيه الحسن السبط (عليه السلام)(267).
- المسخ: قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَـىٰ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ… قالَ اللهُ إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ﴾ (المائدة: 112-115) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، قَالَ: «إِنَّ الْخَنَازِيرَ مِنْ قَوْمِ عِيسَىٰ، سَأَلُوا نُزُولَ المَائِدَةِ فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا، فَمَسَخَهُمُ الله خَنَازِيرَ»، وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) يَقُولُ: «كَانَتِ الْخَنَازِيرَ قَوْمٌ مِنَ الْقَصَّارِينَ، كَذَّبُوا بِالْمِائَدَةِ، فَمُسِخُوا خَنَازِيرَ»(268)، ومسخ الله قلوب أعداء الإمام الحسين (عليه السلام) وقد قال: «كأني بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء»(269)، وجاء في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ الأجْسَامِ العَارِيَةِ في الفَلَوَاتِ، تَنْهَشُهَا الذِّئَابُ العَادِيَاتُ».
- الصحف: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَرِثْتُهَا عَنْ آبَائِي»(270).
- مدَّة الحمل: قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «لم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين (عليه السلام)، وعيسىٰ بن مريم (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)»(271)، وَقَالَ (عليه السلام): «لَمْ يُولَدْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(272).
- الخامس: إن النبي عيسىٰ (عليه السلام) خامس آل عمران، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك، فهو خامس أصحاب الكساء المطهرين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)(273).
- الزهد: روي أنَّ النبي عيسىٰ (عليه السلام): «كَانَ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرَ وَظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا»(274)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كما في الزيارة الناحية: «كُنْتَ زاهِداً في الدُّنيَا زُهْدَ الرَّاحِلِ عَنْها، نَاظِراً إِلَيها بِعَينِ المُسْتَوحِشِينَ مِنْها آمَالُكَ عَنْها مَكفُوفَةٌ، وهِمَّتُكَ عَنْ زِينَتِهَا مَصْرُوفَةٌ، وَأَلحَاظِكَ عَن بَهْجَتِهَا مَصرُوفَةٌ، وَرَغْبَتِكَ فِي الآخِرَة مَعرُوفَةٌ».
- اللباس الخشن: قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «كَانَ عِيسَىٰ (عليه السلام) يَتَوَسَّدُ الحَجَرَ ويَلبَسُ الخَشِنَ»(275)، لزهده في الدنيا، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) لما قال: «ائتوني بثوب لا يرغب فيه، ألبسه غير ثيابي لا أجرد فإني مقتول مسلوب»(276)، لكنهم جردوه وسلبوه، وبَقيَ جسده موسداً علىٰ رمضاء كربلاء تحت لهيب الشمس لثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن ولا دفن.
- المواساة: روىٰ أنَّ النبي عيسىٰ (عليه السلام) كان سائحاً في البراري، ومعه الحواريون، فمروا بكربلاء فرأوا أسداً كاسراً قد أخذ الطريق، فتقدَّم عيسىٰ إلىٰ الأسد، فقال له: لم جلست في هذا الطريق؟ وقال: لا تدعنا نمر فيه؟ فقال الأسد بلسان فصيح: إني لم أدع لكم الطريق حتَّىٰ تلعنوا يزيد قاتل الحسين (عليه السلام)، فقال عيسىٰ (عليه السلام): ومن يكون الحسين؟ قال: هو سبط محمد النبي الأُمّي وابن علي الولي. قال: ومن قاتله؟ قال: قاتله لعين الوحوش والذئاب والسباع أجمع خصوصاً أيام عاشوراء. فرفع عيسىٰ (عليه السلام) يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمَّن الحواريون علىٰ دعاءه فتنحىٰ الأسد عن طريقهم ومضوا إلىٰ شأنهم(277).
الفصل السادس: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وارِثَ مُحَمَّد حَبيبِ اللهِ
- حبيب الله: النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) هو حبيب الله كما ورد في الزيارة الناحية «السَّلامُ عَلىٰ مُحمَّدٍ حَبيبِ اللهِ وصَفْوتِهِ» كذلك وسبطه (عليه السلام) كما ورد في زيارة وارث «السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وارِثَ مُحَمَّد حَبيبِ اللهِ» وورد في زيارته أيضاً «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبيبَ اللهِ وابْنَ حَبيبِهِ»، وورد في الزيارة الجامعة «اَلسَّلامُ عَلىٰ أُمَناءِ اللهِ وَأَحِبّائِهِ»، وورد في زيارة الأربعين «اَلسَّلامُ عَلَىٰ وَلِيِّ الله وَحَبِيبِهِ».
- الرحمة: قوله تعالىٰ: ﴿وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107)، أي أنك رحمة مرسلة إلىٰ الجماعات البشرية كلهم(278)، قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «إنَّما أنا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ»(279)، وجاء في زيارة سبطه (عليه السلام): «السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَحمَةَ اللهِ الواسِعة»، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ رَحْمَةُ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ»(280).
- الشفاعة: قوله تعالىٰ: ﴿عَسَـىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ (الإسراء: 79) لا ريب فإِنَّ المقام المحمود هو مقام مرتفع جدّاً يستثير الحمد، حيث إنَّ (محمود) مأخوذة مِن (الحمد)، أنَّ المقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرىٰ. فالنّبي (صلىٰ الله عليه وآله وسلم) هو أكبر الشفعاء في ذلك العالم(281)، قَالَ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يَا عَلِيُّ، إِنَّ رَبِّي (عزَّ وجلَّ) مَلَّكَنِي الشَّفَاعَةَ فِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنْ أُمَّتِي، وَحَظَرَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ نَاصَبَكَ أَوْ نَاصَبَ وُلْدَكَ مِنْ بَعْدِكَ»(282)، وسبطه (عليه السلام) شَفِيعَ المُذنِبِين.
- الأدب: قال الامام الصادق (عليه السلام): «إِنَّ الله أَدَّبَ نَبِيَّهُ عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم﴾ [القلم: 4]»(283)، الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة وينقسم إلىٰ الفضيلة وهي الممدوحة كالعفة والشجاعة، والرذيلة وهي المذمومة كالشره والجبن لكنه إذا أطلق فهم منه الخلق الحسن(284)، تلك الأخلاق التي لا نظير لها، ويحار العقل في سموّها وعظمتها من صفاء لا يوصف، ولطف منقطع النظير، وصبر واستقامة وتحمّل لا مثيل لها، وتجسيد لمبادئ الخير حيث يبدأ بنفسه أوّلاً فيما يدعو إليه، ثمّ يطلب من الناس العمل بما دعا إليه والالتزام به(285)، كذلك سبطه (عليه السلام) وارثه.
- أهل البيت المطهرين: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب: 33)، دليل علىٰ إرادته الحتمية، وخاصّة بوجود كلمة (إنَّما) الدالّة علىٰ الحصر والتأكيد، بأن يكون أهل البيت منزَّهين عن كلّ رجس وخطأ، وهذا هو مقام العصمة(286)، وقد ورد في الزيارة الجامعة: «عَصَمَكُمُ الله مِنَ الزَّلَلِ وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَطَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرجس أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً»، قَالَ الإمام الصَادِق (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ، وَأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَفَاطِمَةَ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، فَلَمَّا قَبَضَ الله (عزَّ وجلَّ) نَبِيَّهُ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) كَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِمَاماً، ثُمَّ الْحَسَنُ (عليه السلام)، ثُمَّ الْحُسَيْنُ (عليه السلام)، ثُمَّ وَقَعَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله﴾ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِمَاماً، ثُمَّ جَرَتْ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ الْأَوْصِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، فَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ الله، وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ الله (عزَّ وجلَّ)»(287).
- الصلاة والتسليم: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (الأحزاب: 56)، إنَّ مقام النّبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) ومنزلته من العظمة بمكان، بحيث إنَّ خالق عالم الوجود، وكَّل الملائكة الموكّلين بتدبير أمر هذا العالم بأمر الله سبحانه يصلّون عليه، (الصلاة) وجمعها (صلوات)، كلّما نسبت إلىٰ الله سبحانه فإنَّها تعني (إرسال الرحمة)، وكلّما نسبت إلىٰ الملائكة فإنَّها تعني طلب الرحمة، وأنَّ التعبير بـ﴿يُصَلُّونَ﴾ وهو فعل مضارع يدلّ علىٰ الاستمرار، يعني أنَّ الله وملائكته يصلّون عليه دائماً وباستمرار صلاة دائمة خالدة، أمّا ﴿سَلِّمُوا﴾ فتعني التسليم لأوامر نبي الإسلام الأكرم(288)، أنَّ أصل الصلاة – تعني – الانعطاف فصلاته تعالىٰ انعطافه عليه بالرحمة انعطافاً مطلقاً لم يقيّد في الآية بشيء دون شيء وكذلك صلاة الملائكة عليه انعطاف عليه بالتزكية والاستغفار وهي من المؤمنين الدعاء بالرحمة (289)، كذلك سبطه (عليه السلام)، فقد قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «وَكَّلَ اللهُ تَعَالَىٰ بِالحُسَيْنِ (عليه السلام) سَبْعِينَ أَلْف مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ»(290)، وصلاة المؤمنين «اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلىٰ الحُسَينِ المَظلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ العَبَراتِ وَأَسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَةً زاكِيَةً مُبارَكَةً يَصعَدُ أَوَّلُها وَلا يَنفَد آخِرُها أَفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِن أَولادِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينَ يا رَبَّ العالَمِينَ. اللّهمَّ صَلِّ عَلىٰ الإمام الشَّهِيدِ المَقتُولِ المَظلُومِ المَخذُولِ وَالسَيِّدِ القائِدِ وَالعابِدِ وَالزَّاهِدِ»(291).
- الوحي: قوله تعالىٰ: ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحىٰ﴾ (النجم: 3)، المراد بقرينة المقام أنَّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) ما ينطق فيما يدعوكم إلىٰ الله أو فيما يتلوه عليكم من القرآن عن هوىٰ نفسه ورأيه بل ليس ذلك إلَّا وحياً يوحىٰ إليه من الله سبحانه(292)، كذلك سبطه (عليه السلام) فقد قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ): «كُلُّ إِمَامٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتَ مُحَدَّثٌ»(293)، وورد عن الإمام الرضَا (عليه السلام): «الإِمَامُ يَسْمَعُ وَلَا يَرَىٰ الشَّخْصَ»(294).
- التفويض: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ) أَدَّبَ نَبِيَّهُ (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) حتَّىٰ قَوَّمَهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَ، ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَقَالَ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، فَمَا فَوَّضَ الله إلىٰ رَسُولِهِ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَيْنَا»(295)، والمراد بتفويضه أمر خلقه كما يظهر من الروايات إمضاؤه تعالىٰ ما شرعه النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) لهم وافتراض طاعته في ذلك، وولايته أمر الناس وأمّا التفويض بمعنىٰ سلبه تعالىٰ ذلك عن نفسه وتقليده (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) لذلك فمستحيل(296)، أنَّ محتوىٰ الآية حكم عام في كلّ المجالات، ومدرك واضح علىٰ حجيّة سُنَّة الرسول (صلىٰ الله عليه وآله وسلم)(297).
- الداعي: قوله تعالىٰ: ﴿دَاعِياً إلىٰ الله﴾ (الأنبياء: 46) دعوته إلىٰ الله هي دعوته الناس إلىٰ الإيمان بالله وحده، ولازمه الإيمان بدين الله وتقيّد الدعوة بإذن الله يجعلها مساوقة للبعثة(298)، كذلك سبطه (عليه السلام) ورد في دعاء الندبة «إِلَىٰ الله تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ».
- الدعاة: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إلىٰ الله عَلىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ (يوسف: 108) قَالَ: «ذَاكَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَالْأَوْصِيَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ»(299)، فقوله: ﴿هذِهِ سَبِيلِي﴾ إعلان لسبيله، وقوله: ﴿أَدْعُوا إلىٰ اللهِ عَلىٰ بَصِيرَةٍ﴾ بيان للسبيل، وأمّا قوله ﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ فتوسعة وتعميم لحمل الدعوة وأنَّ السبيل وإن كانت سبيل النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) مختصة به لكن حمل الدعوة والقيام به لا يختص به بل من اتَّبعه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) يقوم بها لنفسه(300).
- الهجرة: قوله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ الله يَجِدْ في الاْرْضِ مُرَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً﴾ (النساء: 100)، تشير هذه الآية إلىٰ نِعَم وبركات الهجرة في الحياة الدنيا، فتقول إنَّ الذي يهاجر في سبيل الله إلىٰ أي نقطة من نقاط هذه الأرض الواسعة، سيجد الكثير من النقاط الآمنة الواسعة ليستقر فيها، ويعمل هناك بالحقّ ويرغم أنف المعارضين(301)، أي طلباً لمرضاته في التلبُّس بالدين علماً وعملاً يجد في الأرض مواضع كثيرة كلما منعه مانع في بعضها من إقامة دين الله استراح إلىٰ بعض آخر بالهجرة إليه لإرغام المانع وإسخاطه أو لمنازعته المانع ومساخطته، ويجد سعة في الأرض(302)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد روي أنَّه قد خرجَ من تحتِ ليلتِه وهي ليلةُ الأحدِ ليومين بَقِيا من رجبٍ متوجِّهاً نحوَ مكّةَ ومعَه بنوه وإخوته وبنو أخيه وجُلُّ أهلِ بيتهِ(303)، قائلاً: «مَنْ كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتَهُ ومُوَطِّناً عَلَىٰ لِقَاءِ الله نَفْسَهُ، فَلْيَرْحَلْ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحاً، إِنْ شَاءَ اللهُ»(304).
- صلابة الموقف: قوله تعالىٰ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضـىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ (الأحزاب: 23)، من دون أن يتزلزل أو ينحرف ويبدِّل العهد ويغيّر الميثاق الذي قطعه علىٰ نفسه، وإنّهم لم ينحرفوا قيد أُنملة عن خطّهم، ولم يألوا جهداً في سبيل الله، ولم يتزلزلوا لحظة(305)، قالَ رَسولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «واللهِ لَو وَضعوا الشَّمسَ في يميني والقمرَ في شمالِي علَىٰ أن أتركَ هذا الأمرَ حتَّىٰ يُظهرَه اللهُ أو أهلِكَ فيه ما تركتُهُ»(306)، كذلك سبطه (عليه السلام) فقد قال عند ما طلب – اللعين – البيعة منه ليزيد: «مثلي لا يبايع مثله»(307)، «لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد»(308).
- الصدع: قوله تعالىٰ: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ (الحجر: 94) أعلن الدعوة وأظهر الحق(309)، وسبطه (عليه السلام) صدع لله بالحق كما قد ورد في الزيارة الناحية: «صَدَعْتَ بِالحَقِّ وَالبَيِّنَةِ».
- الجهاد: قوله تعالىٰ: ﴿أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ﴾ (التوبة: 73)، جهاد القوم ومجاهدتهم بذل غاية الجهد في مقاومتهم وهو يكون باللسان وباليد حتَّىٰ ينتهي إلىٰ القتال(310)، كذلك سبطه (عليه السلام) فقد جاء في زيارته «أَشْهَدُ اَنَّكَ جاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ».
- الفتح: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً﴾ (الفتح: 1)، أي أنّنا هيّأنا لك نصراً واضحاً(311)، كلام واقع موقع الامتنان، وتأكيد الجملة بـ(أن) ونسبة الفتح إلىٰ نون العظمة وتوصيفه بالمبين كل ذلك للاعتناء بشأن الفتح الذي يمتن به(312)، قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) لمّا قَدِمَ عَليُّ بنُ الحُسَينِ (عليه السلام) وقَد قُتِلَ الإمام الحُسَين (عليه السلام) استَقبَلَهُ أحدَهُم، وقال: يا عَليَّ بنَ الحُسَين مَن غَلَب؟ وكان (عليه السلام) مُغَطّىٰ الرّأس، وهو في المَحمِل فأجابه (عليه السلام): «إذا أرَدتَ أن تَعلَمَ مَن غَلَب، ودَخَلَ وَقتُ الصَّلاة، فَأذِّن ثُمَّ أقِم»(313). وقال السبط (عليه السلام): «مَنْ لَحِقَ بي استُشهِد، وَمَن تَخَلّفَ لَمْ يَبلغ الفَتْح»(314).
- الرضا: قوله تعالىٰ: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (البقرة: 144) قَالَ سبطه (عليه السلام): «رضا الله رضانا أهل البيت»(315).
- الأمان: قوله تعالىٰ: ﴿ما كانَ الله لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (الأنفال: 33)، والمعنىٰ: لا يعذب الله هذه الأُمَّة وأنت فيهم(316)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد قَالَ النَّبِيُّ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ»(317).
- الارتضاء: قوله تعالىٰ: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ (الجن: 27)، يفيد أنَّ الله تعالىٰ يظهر رسله علىٰ ما شاء من الغيب المختص به(318)، فَعَنَ الإمَام الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) أنَّهُ قَالَ: «رَسُولُ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) الَّذِي عِنْدَ الله مُرْتَضىٰ، وَنَحْنُ وَرَثَة ذَلِكَ الرسول الذِي أَطْلَعَهُ الله عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ، فَعَلِمْنَا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إلىٰ يوْمِ الْقِيَامَةِ»(319).
- الحكمة: قوله تعالىٰ: ﴿ادْعُ إلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (النحل: 125)، (الحكمة) بمعنىٰ العلم والمنطق والاستدلال، فأوَّل خطوة علىٰ طريق الدعوة إلىٰ الحقّ هي التمكُّن من الاستدلال وفق المنطق السليم، أو النفوذ إلىٰ داخل فكر الناس ومحاولة تحريك وإِيقاظ عقولهم، كخطوة أُولىٰ في هذا الطريق، و(الموعظة الحسنة) هي الخطوة الثانية في طريق الدعوة إلىٰ الله، بالاستفادة من عملية تحريك الوجدان الإِنساني، وذلك لما للموعظة الحسنة من أثر دقيق وفاعل علىٰ عاطفة الإِنسان وأحاسيسه، وتوجيه مختلف طبقات الناس نحو الحقّ، وفي الحقيقة فإِنَّ الحكمة تستثمر البُعد العقلي للإِنسان، والموعظة الحسنة تتعامل مع البُعد العاطفي له، وإِنَّ تقييد الموعظة بقيد الحسنة لعلّه إِشارة إلىٰ أنَّ النصيحة والموعظة إِنَّما تؤدّي فعلها علىٰ الطرف المقابل إذا خليت من أيّةِ خشونة أو استعلاء وتحقير التي تثير فيه حسّ العناد واللجاجة وما شابه ذلك(320)، والتأمل في هذه المعاني يعطي أنَّ المراد بالحكمة والله أعلم الحجة التي تنتج الحق الذي لا مرية فيه ولا وهن ولا إبهام والموعظة هو البيان الذي تلين به النفس ويرق له القلب، لما فيه من صلاح حال السامع من الغبر والعبر وجميل الثناء ومحمود الأثر ونحو ذلك(321)، وسبطه (عليه السلام) كذلك كما في زيارة الأول من رجب الأصب: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بابَ حِكْمَةِ رَبِّ الْعالَمينَ»، وفي الزيارة الناحية: «دَعَوتَ إلىٰ الله بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»، والزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلَىٰ الدُّعاةِ إلىٰ اللهِ».
- المقربون: قوله تعالىٰ: ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا المُقَرَّبُونَ﴾ (المطففين: 28) المقرّبون هم النمط الأعلىٰ من أهل السعادة(322)، عن الإمام الصادق (عليه السلام): «هُمْ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأَئِمَّةُ (عليهم السلام)»(323).
- الخاشعين: قوله تعالىٰ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: 1-2) قَالَ الإمام الكاظِم (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي رَسُولِ الله وَفِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»(324)، ﴿خاشِعُونَ﴾ مشتقّة من خشوع، بمعنىٰ التواضع وحالة التأدّب يتَّخذها الإنسان جسماً وروحاً بين يدي شخصية كبيرة، أو حقيقة مهمّة تظهر في الإنسان وتبدو علاماتها علىٰ ظاهر جسمه(325)، وبمعنىٰ آخر هو تأثرٌ خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه والظاهر أنَّه من صفات القلب ثم ينسب إلىٰ الجوارح أو غيرها بنوع من العناية(326).
- الشهداء: قَالَ أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِنَّ الله إِيَّانَا عَنَىٰ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَىٰ النَّاسِ﴾ فَرَسُولُ الله شَاهِدٌ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ شُهَدَاءُ الله عَلَىٰ النَّاسِ»(327)، وجاء في زيارته الرابعة: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ في أَرْضِهِ، وشاهِدَهُ عَلىٰ خَلْقِهِ»، والشهيد هو الشاهد، وهي كلمة مشتقّة من شهود، بمعنىٰ اطِّلاع المرء علىٰ أمر أو حدث شهده بنفسه(328).
- العوض والذرية: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَر﴾ (الكوثر: 1) قال الإمام الصادق (عليه السلام): «الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ أَعْطَىٰ الله مِحَمَّداً عِوَضاً عَنِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ»(329)، وعوَّض اللهُ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) الذرية الصالحة من ابنته الزهراء البتول (عليها السلام)، كذلك سبطه (عليه السلام) فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنَّه قال: «إنَّ الله عوَّض الحسين (عليه السلام) من قتله أن جعل الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره»(330)، عبارة ﴿أَعْطَيْناكَ﴾ تعني هبة الله سبحانه لنبيّه هذا الكوثر، ولم يقل آتيناك، وهذه بشارة كبيرة للنّبي تسلي قلبه أمام تخرّصات الأعداء، وتثبت قدمه وتبعد الوهن عن عزيمته؛ وليعلم أنَّ سنده هو الله مصدر كلّ خير وواهب ما عنده من خير كثير، و﴿الْكَوْثَر﴾ له معنىٰ واسع يشمل كل خير وهبه الله لنبيّه (صلىٰ الله عليه وآله وسلم)، ومصاديقه كثيرة، لكن كثيراً من علماء الشيعة ذهبوا إلىٰ أنَّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) من أوضح مصاديق الكوثر(331).
- نقض العهود: قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾ (الأنفال: 56) من أبرز العهود والذمم التي نقضوها مع النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) هي ببيعة الغدير، وكذلك مع سبطه (عليه السلام) كما ورد في الزيارة الناحية: «السَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ نُكِثَتْ ذِمَّتُهُ، السَّلَامُ عَلَىٰ المُضَامِ المُسْتَبَاحِ».
- الأذىٰ: قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ (التوبة: 61)، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً﴾ (الأحزاب: 57) قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «ما أوذيَ أحدٌ ما أوذيتُ في الله»(332)، إيذاء نبي الإسلام (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) له معنىٰ واسع، ويشمل كلّ عمل يؤذيه، سواء كان الكفر والإلحاد ومخالفة أوامر الله والافتراءات والتُهَم، أنَّ إيذاء أهل بيت النبي وخاصّة علي وفاطمة (عليهما السلام) يدخل ضمن الآية(333)، كذلك سبطه (عليه السلام) فقد جاء في الزيارة الناحية: «قَاتَلُوكَ بِكَيْدِهِمُ وَشَرِّهِمُ، وَمَنَعُوكَ المَاءَ وَوُرُودَهُ، ونَاجَزُوكَ القِتَالَ، وَعَاجَلُوكَ النِّزَالَ، وَرَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَالنِّبَالِ، وبَسَطُوا إِلَيكَ أَكُفَّ الاِصْطِلاَمِ، وَلَمْ يَرْعَوْا لَكَ ذِمَاماً، وَلا رَاقَبُوا فِيْكَ أثَاماً، فِي قَتْلِهِمُ أوْلِيَاءَكَ، وَنَهْبِهِمُ رِحَالَكَ، وَأنْتَ ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ».
- المنافقين: قوله تعالىٰ: ﴿وَالله يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَاذِبُون﴾ (المنافقين: 1) المنافق اسم فاعل من النفاق وهو في عرف القرآن إظهار الإيمان وإبطان الكفر؛ والكذب خلاف الصدق وهو عدم مطابقة الخبر للخارج(334)، قال نافع بن هلال للإمام الحسين (عليه السلام): «أنت تعلم أنَّ جَدَّك رسولَ الله لم يَقْدِر أن يُشرِبَ الناس مَحبّتَه، ولا أن يَرجِعوا إلىٰ أمره ما أحَبّ، وقد كان منهم منافقون يَعِدونه بالنصر، ويُضمِرون له الغَدْر، يَلْقَونه بأحلىٰ من العسل، ويُخلِفونه بأمَرَّ مِن الحَنظَل، حتَّىٰ قَبَضَه الله إليه، وأنَّ أباك عليّاً كان في مِثْل ذلك، فقَومٌ قد أجمعوا علىٰ نصره وقاتَلوا معه الناكثين والقاسطين والمارقين، حتَّىٰ أتاه أجَلُه فمضىٰ إلىٰ رحمة الله، وأنت اليومَ عندنا في مِثْل تلك الحالة، فمَن نَكَث عهدَه وخلَعَ بيعتَه، فلن يَضُرّ إلَّا نَفْسَه، واللهُ مُغْنٍ عنه، فسِرْ بنا راشداً مُعافىٰ، مُشَرِّقاً إنْ شئتَ أو مُغَرِّباً»(335).
- الردّة: قوله تعالىٰ: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 144)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ أَهْلَ رِدَّةٍ بَعْدَ النَّبِيِّ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) إِلَّا ثَلاَثَةً»(336)، وَقَالَ أَبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «ارْتَدَّ النَّاسُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ إِلَّا ثَلاَثَةً»(337).
- التواضع: قوله تعالىٰ: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ (الشعراء: 215)، تعبير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بالمحبة واللطف(338)، واشتغل بالمؤمنين بك وأجمعهم وضمهم إليك بالرأفة والرحمة(339)، وسبطه (عليه السلام) شديد التواضع، ومخالطة الفقراء والمساكين والضعفاء، ويجالسهم، ويأكل معهم، ويكرمهم، ويدعوهم إلىٰ منزله.
- الأُبوة: قوله تعالىٰ: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ (البقرة: 83)، تشير إلىٰ حقّ الوالدين وتوصي بالإِحسان إِليهما ولا شك أنَّ حقّ الوالدين من القضايا التي يهتمّ بها القرآن الكريم كثيراً، وقلّما حظىٰ موضوع بمثل هذا الاهتمام والعناية(340)، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ): «إِنْ كَانَ الْأَبَوَانِ إِنَّمَا عَظُمَ حَقُّهُمَا عَلَىٰ الْأَوْلاَدِ لِإِحْسَانِهِمَا إِلَيْهِمْ، فَإِحْسَانُ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) إلىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ، فَهُمَا بِأَنْ يَكُونَا أَبَوَيْهِمْ أَحَقُّ»(341)، وسبطه (عليه السلام) أبو الأئمة (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- حملة العرش: قَالَ أَبو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلُهُ (عزَّ وجلَّ): ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ حَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (غافر: 7): «يَعْنِي الرَسُول والأوصِياء مِنْ بَعدِه»(342)، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): «الْعَرْشُ لَيْسَ هُوَ الله، وَالْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ، وَالْعَرْشُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، ثُمَّ أَضَافَ الْحَمْلَ إلىٰ غَيْرِهِ، خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ»(343).
- التزكية: قوله تعالىٰ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103) كذلك سبطه (عليه السلام)، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): «جارية هي في الإمام بعد رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)»(344)، التطهير إزالة الأوساخ والقذارات من الشيء ليصفىٰ وجوده ويستعد للنشوء والنماء وظهور آثاره وبركاته، والتزكية إنماؤه وإعطاء الرشد له بلحوق الخيرات وظهور البركات كالشجر يقطع الزوائد من فروعها فتزيد في حسن نموها وجودة ثمرتها(345).
- المتوسِّمين: قَالَ الإمام عَلِيُّ بْنُ مُوسَىٰ الرِّضَا (عليه السلام): «قَالَ الله تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ أَوَّلُ المُتَوَسِّمِينَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) ثُمَّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(346)، أي العقلاء الذين يفهمون الأحداث بفراستهم وذكائهم ونظرهم الثاقب ويحملون من كل إِشارة حقيقة ومن كل تنبيه درساً(347).
- عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (الإسراء: 57) قَالَ: «هُمُ النَّبِيُّ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ»(348).
- المثاني: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ المَثانِي﴾ قال أبو جَعْفَر (عليه السلام): «نَحْنُ المَثَانِي الَّتِي أُعْطِيَ نَبِيُّنَا (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ)»(349).
- أهل الإيمان: قَالَ أبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ النَّبِيُّ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَالذُّرِّيَّةُ»(350)، كذلك قوله تعالىٰ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا﴾ (البقرة: 285)، تصديق لإيمان الرسول والمؤمنون، وإنما أفرد رسول الله عنهم بالإيمان بما أنزل إليه من ربِّه ثم ألحقهم به تشريفاً له(351)، فلا يرون تفاوتاً بين رسل الله من جهة أنَّهم مرسلون من قبل الله تعالىٰ، ويحترمونهم ويقدّسونهم جميعاً(352).
- الذكر وأهله: عنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): اَلذِّكْرُ أَنَا، وَالْأَئِمَّةُ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، أَهْلُ الذِّكْرِ»(353).
- الرجعة: قَالَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إلىٰ مَعاد﴾، قَالَ: «يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، وَأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَالْأَئِمَّةُ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(354).
- الصادقين: قَوْله تعالىٰ: ﴿كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ المعية هي المصاحبة في العمل وهو الاتِّباع(355)، يَعْنِي مَعَ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)(356).
- الراسخون: وقوله تعالىٰ: ﴿ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: 7) كذلك سبطه (عليه السلام)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أَفْضَلُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، فَقَدْ عَلِمَ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ مِنَ التَّنْزِيلِ وَالتَّأْوِيلِ، وَمَا كَانَ الله لِيُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ، وَأَوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ»(357).
- فضل الله ورحمته: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ قَال: «الْفَضْلُ: رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)، ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»، وَعَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام)، قَالَ: «الرَّحْمَةُ: رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، وَ(الْفَضْل): عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»(358)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فهو رحمة الله الواسعة.
- التكذيب: قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ (الأنعام: 34)، وقوله: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ (فاطر: 4) كذلك سبطه (عليه السلام) كما جاء في المقاتل.
- الصبر: قوله تعالىٰ: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور﴾ (لقمان: 17) كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كان صابراً إلَّا أنَّه فاق صبره الحدود حتَّىٰ جاء في زيارة الناحية: «وَأنْتَ مُقْدَّمٌ في الهَبَوَاتِ، ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ، قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ، فَأحْدَقُوا بِكَ مِنْ كِلِّ الجِّهَاتِ، وأثْخَنُوكَ بِالجِّرَاحِ، وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَينَ الرَّوَاحِ، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، وَأنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ»، وقال (عليه السلام) في دعائه: «صَبراً علىٰ قضائِكَ يا ربِّ، لا إلهَ سِواكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ، ما لي ربٌّ سِواكَ ولا معبودٌ غيرُكَ، صبراً علىٰ حُكْمِك، يا غِياثَ من لا غِيَاثَ له»(359).
- الرقابة: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾: «المُؤْمِنُونَ هُنَا الْأَئِمَّةُ الطَّاهِرُونَ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(360).
- الاعتزال ثم القيام: كان النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) يعتزل الناس ويتعبَّد في غار حراء، وبعدها قام بالرسالة والقاتل، كذلك سبطه (عليه السلام) اعتزل للعبادة بعد استشهاد أخيه (عليه السلام) وقام بعدها للقتال.
- حجج الله: روىٰ أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أنَّه قال: «أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين حجج الله علىٰ خلقه، أعداؤنا أعداء الله، وأولياؤنا أولياء الله»(361)، وجاء في زيارته: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ».
- ترك البدء بالقتال: ما بدأ الإمام الحسين (عليه السلام) القتال معللاً بـ«ما كنت لأبدأهم بالقتال»(362)، كجدِّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم).
- العلم والسلاح: قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «لما قبض رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) ورث علي (عليه السلام) علمه وسلاحه ثم صار إلىٰ الحسن والحسين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(363)، وورد في الزيارة الجامعة: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا خُزَّانَ العِلْمِ» ابن عباس: إِنَّ الحُسين (عليه السلام) مِن بيت النبوَّة، وَهُم وَرَثَة العلم(364).
- الخصال: قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «أمّا الحسين فإنَّ له شجاعتي، وجرأتي، وجودي، سخائي، والرحمة»(365)، و«أنْحَلُ الحُسَيْنَ السماحَةَ والحُرْمَةَ، ونَحَلْتَ الصَّغِيرَ المَحَبَّةَ والرِّضا»(366).
- الشبه: قَالَ النَبِي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ»(367)، عَنْ وَأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ (صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ) مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إلىٰ كَعْبِهِ خَلْقاً ولَوْناً فَلْيَنْظُرْ إلىٰ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ»(368)، وعن أبو هريرة قال: (دخل الحسين بن علي (عليه السلام) وهو معتم فظننت أنَّ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) قد بُعث)(369).
- البلاء: اجتمع عليهما أنواع البلاء النفسي والبدني، والروحي، وقتل الذرية، وغيرها.
- الوراثة المادية: قال السبط (عليه السلام) لأعدائه: «هل تعلمون أنَّ هذا سيف رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أنا متقلده»؟ قالوا: اللهم نعم، قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنَّ هذه عمامة رسول الله أنا لابسها»؟ قالوا: اللهم نعم(370).
- السيادة: إنَّ النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) هو سيد الأنبياء والمرسلين بأجمعهم، كما قال: «إن الله تبارك وتعالىٰ فضَّلني علىٰ جميع النبيين والمرسلين»(371)، وكذلك سبطه (عليه السلام) فقد قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إنَّه سيِّد الشُّهداء مِن الأُوَّلين والآخرين في الدُّنيا والآخِرة»(372).
- الدعاء عند النظر إلىٰ كثرة الأعداء: قال سيّد الساجدين (عليه السلام): «لمَّا صَبَّحَتِ الْخَيْلُ ونظر الْحُسَيْن (عليه السلام) إلىٰ جمعهم كأنَّهم سيل منحدر، رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ»(373)، وهذا دعاء جدّه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) يوم بدر.
- الشجاعة: قال أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «كُنَّا إذا احمرَّ البأس، اتَّقَيْنا برسولِ اللهِ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)(374)، فما يكونُ منَّا أحَدٌ أَدْنىٰ منَ القومِ منه»، وسبطه (عليه السلام) كذلك وقد قالَ الراوي: «إنَّ الرِّجالَ كانَت لَتَشُدُّ عَلَيهِ فَيَشُدُّ عَلَيها بِسَيفِهِ، فَتَنكَشِفُ عَنهُ انكِشافَ المِعزىٰ إذا شَدَّ فيهَا الذِّئبُ، ولَقَد كانَ يَحمِلُ فيهِم وقَد تَكَمَّلوا ثَلاثينَ ألفاً، فَيُهزَمونَ بَينَ يَدَيهِ كَأَنَّهُمُ الجَرادُ المُنتَشِرُ»(375).
- بقاء الذكر: ذكر النبي محمد (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) بقي مع كل أذان وصلاة، وقال السبط (عليه السلام):
«شيعتي ما إن شربتم عذب ماءٍ فاذكروني * * * أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني»(376).
- العطاء: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فيه (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «كانَ أَجْوَدَ النّاسِ كَفَّاً»(377)، كذلك سبطه (عليه السلام) سقىٰ أعدائه الماء وهم بحاجته، وورد أنَّ أعرابياً قصده (عليه السلام) فأعطاه حاجته، فبكىٰ الأعرابي، فقال له (عليه السلام): «لعلك استقللت ما أعطيناك»، قال: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك(378).
- والاحتساب علىٰ فقد الأولاد: قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) عند فقد ولده إبراهيم: «إنَّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلَّا ما يرضي ربَّنا، وأنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»(379)، وكذلك سبطه (عليه السلام) عندما فقد أولاده، قال: «صبراً علىٰ قضائك يا رب، لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي ربٌّ سواك، ولا معبود غيرك، صبراً علىٰ حكمك يا غياث من لا غياث له»(380).
- الدفن: كلاهما تأخر دفنهما ثلاثة أيام.
- البذل: بذل النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) كل شيء لتثبيت دين الله، كذلك سبطه (عليه السلام) بذل كل ما عنده لحفظ دين الله وبقائه وتصحيحه بعد انحرافه.
- التوسل بهما: «اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيكَ نَبي الرحمة مُحمدٍ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)، يا أبا الْقاسم يا رَسُولَ الله يا إمامَ الرحْمَةِ، يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَّمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله… يا أبا عَبْدِ الله يا حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أيُها الشَهِيدُ يا بْنَ رَسُول الله يا حُجَةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَّمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله».
- الزهد: كان رسولُ اللهِ (صلَّىٰ اللهُ عليه وآله وسلَّم) أزهَدَ النَّاسِ فيما عندَ النَّاسِ، مُكتفِياً بالبلاغِ؛ وقد آتاه اللهُ مفاتيحَ خِزائِنِ الأرضِ، فأبىٰ أن يقبَلَها، واختار الآخِرةَ عليها، وكذلك سبطه (عليه السلام) كما في الزيارة الناحية: «كُنْتَ زاهِداً في الدُّنيَا زُهْدَ الرَّاحِلِ عَنْها، نَاظِراً إِلَيها بِعَينِ المُسْتَوحِشِينَ مِنْها آمَالُكَ عَنْها مَكفُوفَةٌ، وهِمَّتُكَ عَنْ زِينَتِهَا مَصْرُوفَةٌ، وَأَلحَاظِكَ عَن بَهْجَتِهَا مَصرُوفَةٌ، وَرَغْبَتِكَ فِي الآخِرَة مَعرُوفَةٌ».
- التخيير: قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يا ملك الموت جئتني زائراً أم قابضاً؟ قال: جئتك زائراً وقابضاً، وأمرني الله (عزَّ وجلَّ) أن لا أدخل عليك إلَّا بإذنك، ولا أقبض روحك إلَّا بإذنك»، قال الإمام الصادق (عليه السلام): «أُنزلَ النصرُ حتَّىٰ رفرفَ علىٰ رأسِ الحُسين (عليه السلام) ثمَّ خُيّرَ بينَ النصرِ علىٰ أعدائِه وبينَ لقاءِ اللهِ تعالىٰ، فاختارَ لقاءَ اللهِ تعالىٰ»(381)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «لمَّا نَزَلَ النَّصْرُ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حتَّىٰ كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ خُيِّرَ النَّصْرَ أَوْ لِقَاءَ الله فَاخْتَارَ لِقَاءَ الله»(382).
- التهديد: هدَّد مشركي قريش النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) بقتله وأرسلوا من يقتله، وكذلك سبطه (عليه السلام) أرسل يزيد من يقتله ولو كان معلقاً بأستار الكعبة عندما رفض البيعة(383).
- مواجه الظلمة: واجه النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أبي لهب وأبي جهل وأبا سفيان وغيرهم، أمّا سبطه (عليه السلام) فقد واجه حفيد أبي سفيان يزيد وجيشه وأتباعه الظلمة.
- الثورة الإنقاذية: ثورة النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) تأسيسية والإنقاذ من شرك براثن الجاهلية، وثورة سبطه (عليه السلام) تصحيحية فإنَّ الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء والاستدامة.
- الأبوة: قالَ رَسولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يا عَلِيُّ، أنَا وأنتَ أبَوا هذِهِ الأُمَّةِ، فَمَن عَقَّنا فَعَلَيهِ لَعنَةُ الله»(384)، كذلك سبطه (عليه السلام) أبو الأئمة (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
- كلاهما استمرت ذريتهما، فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام): «جعل الله الإمامة في ذريته»(385)، وأبقاهم خالدين (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ).
الفصل السابع: السَّلامُ علَيكَ يا وارِثَ أَميرِ المُؤمِنينَ وَلَيِ اللهِ
- الولي: قد وَرَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ قَالَ: «إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلَىٰ بِكُمْ، أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ وَبِأُمُورِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ الله وَرَسُولُهُ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ يَعْنِي عَلِيّاً وَأَوْلاَدَهُ الْأَئِمَّةَ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) إلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، ثُمَّ وَصَفَهُمُ الله (عزَّ وجلَّ) فَقَالَ: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ﴾ (المائدة: 55)، وقد ورد في زيارة الأربعين «اَلسَّلامُ عَلَىٰ وَلِيِّ الله وَحَبِيبِهِ»، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «نَحْنُ وُلاَةُ أَمْرِ الله فِي عِبَادِهِ»(386).
- أُولي الأمر: قَدَ جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، فِي قَوْلِهِ: ﴿أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: «هِيَ فِي عَلِيٍّ وَفِي الْأَئِمَّةِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) جَعَلَهُمُ الله مَوَاضِعَ الْأَنْبِيَاءِ»(387)، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «نَحْنُ وَالله الَّذِينَ أَمَرَ الله الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِمْ»(388) وقال (عليه السلام): «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ الله طَاعَتَنَا»(389)، إنَّ المراد بالأمر في ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ هو الشأن الراجع إلىٰ دين المؤمنين المخاطبين بهذا الخطاب أو دنياهم(390).
- أهل البيت المطهرين: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب: 33)، دليل علىٰ إرادته الحتمية، وخاصّة بوجود كلمة (إنَّما) الدالّة علىٰ الحصر والتأكيد، بأن يكون أهل البيت منزَّهين عن كلّ رجس وخطأ، وهذا هو مقام العصمة(391)، وقد ورد في الزيارة الجامعة: «عَصَمَكُمُ الله مِنَ الزَّلَلِ وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَطَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرجس أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً»، قَالَ الإمام الصَادِق (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ، وَأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَفَاطِمَةَ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، فَلَمَّا قَبَضَ الله (عزَّ وجلَّ) نَبِيَّهُ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) كَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِمَاماً، ثُمَّ الْحَسَنُ (عليه السلام)، ثُمَّ الْحُسَيْنُ (عليه السلام)، ثُمَّ وَقَعَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله﴾ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِمَاماً، ثُمَّ جَرَتْ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ الْأَوْصِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، فَطَاعَتُهُمْ طَاعَةُ الله، وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَةُ الله (عزَّ وجلَّ)»(392).
- النقطة: قوله تعالىٰ: ﴿بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (الفاتحة: 1) قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «عِلمُ ما كان وما يكون في القرآن، وعِلمُ القرآن كله في سورة الفاتحة، وعِلم الفاتحة في البسملة، وعِلم البسملة في الباء منها، وأنا النقطة تحت الباء»(393)، وكذلك شبله (عليه السلام).
- الود: عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً﴾ (مريم: 96) قَالَ: «لَا تَلْقَىٰ مُؤْمِناً إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ وُدٌّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلِأَهْلِ بَيْتِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(394)، الودّ: المودَّة والمحبّة وفي الآية وعد جميل منه تعالىٰ أنَّه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات مودَّة في القلوب ولم يقيده بما بينهم أنفسهم ولا بغيرهم ولا بدنيا ولا بآخره أو جنَّة فلا موجب لتقييد بعضهم ذلك بالجنة وآخرين بقلوب الناس في الدنيا إلىٰ غير ذاك(395).
- المؤمن: قوله تعالىٰ: ﴿كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة: 19) قَالَ أَبو جَعْفَر (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام)»(396)، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، قَالَ: «فَهُوَ المُؤْمِنُ بِالله، وَالمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله حَقّاً، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»(397) وشبله (عليه السلام) مثله ووارثه.
- الهُداة: قَالَ أبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «الْهَادِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَاَلْأَئمَّةُ(398) – صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ – وَهُوَ قَولُهُ: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7]»، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وَنَحْنُ مَصَابِيحُ الدُّجَىٰ، وَنَحْنُ مَنَارُ الْهُدَىٰ»(399).
- الإحياء: قوله تعالىٰ: ﴿الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله﴾ (التوبة: 112)، أي حفظ الحدود الإلهية وإجراء قوانين الله، وإقامة الحق والعدالة(400)، فقد أحيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فريضة حج التمتع التي أماتها الظالمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(401)، كذلك شبله (عليه السلام) أحيا الدين بمقتله، وجاء في الزيارة الناحية: «أمَرْتَ بِإِقَامَةِ الحُدُودِ، والطَّاعَةِ لِلمَعْبُودِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الخَبَائِثِ وَالطُّغْيَانِ»، وجاء في زيارته: «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ حَلَّلْتَ حَلالَ الله وَحَرَّمْتَ حَرامَ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَمَرْتَ بِالقِسْطِ وَالعَدْلِ».
- خير أُمَّة: قوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ﴾ (آل عمران: 110)، الأُمَّة إنَّما تطلق علىٰ الجماعة والفرد لكونهم ذوي هدف ومقصد(402)، وَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ»(403)، ﴿كُنْتُمْ﴾ لا تعني الماضي هنا، بل هي بيان لثبوت واستمرار هذه الصفات(404).
- الوسيلة: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾: «أَنَا وَسِيلَتُهُ»(405)، وكذلك شبله (عليه السلام)، فقد قالت أُمُّه سيدة نساء العالمين (عليها السلام): «نحن وسيلته – الله – في خلقه»(406)، عن علي بن إبراهيم، قال: «تقربوا إليه بالإمام»(407)، إِنَّ الوسيلة تعني التقرب أو النتيجة التي يمكن الحصول عليها مِن التقرُّب، علىٰ هذا الأساس فإنَّ هُناك مفهوماً واسعاً جدّاً لكلمة الوسيلة يشمل كل عمل جميل ولائق، وتدخل في مفهومها كل صفة بارزة أُخرىٰ، لأنَّ كل هَذِهِ الأُمور تكون سبباً في التقرب مِن الله(408).
- الأُذن الواعية: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: لمَّا نَزَلَتْ ﴿وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ﴾ قَالَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «لِعَلِيٍّ وَآلِهِ»(409)، الوعي جعل الشيء في الوعاء، والمراد بوعي الأذن لها تقريرها في النفس وحفظها فيها لترتب عليها فائدتها وهي التذكر والاتِّعاظ(410).
- نفس الله ويمينه: قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «عَلِيٌ هُوَ نَفْسُ الله وَيَمِينُ الله» قَوْلُهُ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ﴾ (آل عمران: 28) وقَوْلُهُ: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾(411)، كناية عن ثبوت القدرة(412)، فَعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فِي خُطْبَتِهِ: أَنَا يَدُ الله المَبْسُوطَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ»(413) كذلك شبله (عليه السلام) فَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ عَيْنُ الله فِي خَلْقِهِ، وَيَدُهُ المَبْسُوطَةُ بِالرَّحْمَةِ عَلَىٰ عِبَادِهِ»(414).
- يد الله: قوله تعالىٰ: ﴿يَدُ الله﴾ (الفتح: 10) عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فِي خُطْبَتِهِ: أَنَا يَدُ الله المَبْسُوطَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ»(415) كذلك شبله (عليه السلام)، ومن البديهي أنَّ عبارة يدي لا تعني الأيدي الحقيقية المحسوسة، لأنَّ البارئ (عزَّ وجلَّ) منزّه عن كافّة أشكال الجسم والتجسيم، وإنَّما اليد هنا كناية عن القدرة(416).
- جنب الله: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)، فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتىٰ عَلىٰ ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله﴾، قَالَ: «جَنْبُ الله أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، وكَذَلِكَ مَا كَانَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ بِالمَكَانِ الرَّفِيعِ إلىٰ أَنْ يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إلىٰ آخِرِهِمْ»(417)، وجاء في الآية عن علي بن إبراهيم قال: «في الإمام»(418)، فجنب الله جانبه وناحيته وهي ما يرجع إليه تعالىٰ مما يجب علىٰ العبد أن يعامله ومصداق ذلك أن يعبده وحده ولا يعصيه(419)، وكذلك شبله (عليه السلام) مثله، فَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «نَحْنُ جَنْبُ الله»(420).
- الثلة والقلة: عَنِ الإمام الصَّادِقِ (عليه السلام) في قوله تعالىٰ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ (الواقعة: 14)، وقوله: ﴿وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِين﴾ (الواقعة: 40): «عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»(421)، وكذلك شبله (عليه السلام).
- المتقون: سُئِلَ الإمام الصادق (عليه السلام) عَنْ قَوْلِه: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ﴾ (الرعد: 35) قَالَ: «هِيَ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) وَأَوْلَادِهِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(422)، المثل بمعنىٰ الصفة أي صفة الجنة التي وعد الله المتقين أن يدخلهم فيها(423).
- المشفقون: قوله تعالىٰ: ﴿مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (المؤمنون: 57) قَالَ الْإِمَامُ الكَاظِم (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَوُلْدِهِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(424)، الخشية لا تعني مطلقاً الخوف، بل تعني الخوف المقترن بالتعظيم والتقديس. وكلمة (المشفق) مشتقّة من (الإشفاق) ومن أصل: الشفق، أي: الضياء المخالط للظلمة، وتعني الخوف الممزوج بالمحبّة والإجلال.
ولكون الخشية ذات جانب عاطفي، والإشفاق ذا جانب عملي، ذكرا معاً إيضاحاً للعلّة والمعلول في الآية. فهي تعني أنَّ الخوف المخلوط بتعظيم الله قد استقرّ في قلوبهم، وقد بدت علائمه في أعمالهم والتزامهم بالتعاليم الإلهيّة، أي أنَّ الإشفاق مرحلة تكاملية للخشية، وهو ما يؤثّر في عمل الإنسان فيجنّبه ارتكاب الذنوب، ويدفعه إلىٰ القيام بمسؤولياته(425).
- السابقون: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ المُقَرَّبُونَ﴾ (الواقعة: 10-11) قَالَ: (سَابِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ)(426)، وَقَالَ الإمَامُ الْبَاقِر (عليه السلام): «السَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ: فَعَلِيٌّ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(427)، وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَاقِرَ (عليه السلام) يَقُولُ: «نَحْنُ السَّابِقُونَ»(428)، ﴿السَّابِقُونَ﴾ ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالإيمان فحسب، بل في أعمال الخير والأخلاق والإخلاص، فهم أُسوة وقدوة وقادة للناس، ولهذا السبب فهم من المقرّبين إلىٰ الحضرة الإلهيّة(429).
- التجارة المربحة: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «أَنَا التِّجَارَةُ المُرْبِحَةُ المُنْجِيَةُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الَّتِي دَلَّ الله عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ(430)، فَقَالَ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىٰ تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: 10]»، وكذلك شبله (عليه السلام) أي تجارة جليلة القدر عظيمة الشأن، وجعل الربح الحاصل منها النجاة من عذاب أليم لا يقدر قدره، ومصداق هذه النجاة الموعودة المغفرة والجنة(431).
- المنفقون: قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الله وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (البقرة: 207)، ابتغاء المرضات هو طلب الرضاء، ويعود إلىٰ إرادة وجه الله(432)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه): (نَزَلَتْ فِي عَلَيٍ)(433)، وَقَالَ: (إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَمْلِكُ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَيْلاً وَبِدِرْهَمٍ نَهَاراً وَبِدِرْهَمٍ سِرّاً وَبِدِرْهَمٍ عَلَانِيَةً فَأَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ فِيهِ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 274])(434)، والتقدير مسرين ومعلنين، واستيفاء الأزمنة والأحوال في الإنفاق للدلالة علىٰ اهتمام هؤلاء المنفقين في استيفاء الثواب، وإمعانهم في ابتغاء مرضاة الله، وإرادة وجهه(435)، وشبله (عليه السلام) مثله.
- مرضاة الله: قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله﴾ (البقرة: 207) قال عليّ بن إبراهيم في معنىٰ الآية، قال: ذاك أمير المؤمنين، ومعنىٰ ﴿يَشْرِي نَفْسَهُ﴾: أي يبذل(436)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كما ورد في زيارة الأربعين: «وَبَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ لِيَستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الجَهالَةِ وَحَيرَةِ الضَّلالَةِ»، وقال الإمام الحسين (عليه السلام): «اللّهم إِن كَان هَذَا يُرْضِيْك فَخُذ حتَّىٰ تَرْضَىٰ»(437).
- حبل الله: عَنِ ابْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً﴾ قَالَ: «عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَبْلُ الله المَتِينُ»، وعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي خُطْبَتِهِ: أَنَا حَبْلُ الله المَتِينُ»(438)، كذلك شبله (عليه السلام) فقد قَالَ أَبو جَعْفَر (عليه السلام): «آلُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) هُمْ حَبْلُ الله الَّذِي أُمِرْنَا بِالاِعْتِصَامِ بِهِ»(439).
- حبل الناس: وقوله تعالىٰ: ﴿بِحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 112) قَالَ أبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «الْحَبْلُ مِنَ الله: كِتَابُ الله، وَالْحَبْلُ مِنَ النَّاسِ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»(440)، وكذلك شبله (عليه السلام)، فقد قال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ حَبْلُ الله»(441)، إنَّ المراد من الحبل الإلهي هو كلّ وسيلة للارتباط بالله تعالىٰ سواء كانت هذه الوسيلة هي الإسلام، أم القرآن الكريم، أم النبي وأهل بيته الطاهرين(442).
- الشهداء: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، فِي قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَىٰ النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ قَالَ: «نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَىٰ النَّاسِ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ، وَبِمَا ضَيَّعُوا مِنْهُ»(443)، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «مِنَّا شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ زَمَانٍ عَلِيُّ فِي زَمَانِهِ وَالْحَسَنُ (عليه السلام) فِي زَمَانِهِ وَالْحُسَيْنُ (عليه السلام) فِي زَمَانِهِ»(444)، كذلك شبله (عليه السلام) فقد جاء في زيارته الرابعة: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ في أَرْضِهِ، وشاهِدَهُ عَلىٰ خَلْقِهِ».
- الإمام المبين: قوله تعالىٰ: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِين﴾ (يس: 12) قَالَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «أَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ المُبِينُ»(445)، وكذلك شبله (عليه السلام).
- الحكمة: قوله تعالىٰ: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾ (البقرة: 269) الإيتاء هو الإعطاء، والحكمة هي القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو علىٰ سعادة الإنسان كالمعارف الحقة الإلهية في المبدأ والمعاد، والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية(446)، قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا»(447) كذلك شبله (عليه السلام) لما جاء في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ حِكْمَةِ رَبِّ العالَمِينَ».
- علم الكتاب: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله: ﴿قُلْ كَفىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ﴾ فَقَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ (عليه السلام) بَعْدَ رَسُولِ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)، وَفِي الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ، وَعَلِيٌّ (عليه السلام) عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»(448).
- الزينة: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً﴾ قَالَ: (زِينَةُ الْأَرْضِ الرِّجَالُ وَزِينَةُ الرِّجَالِ عَلِيُّ)(449)، وكذلك شبله (عليه السلام)، الزينة الأمر الجميل الذي ينضم إلىٰ الشيء فيفيده جمالاً يرغب إليه لأجله(450).
- الوعد: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) فِي قَوْلِه تعالىٰ: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ﴾ (القصص: 61) قَالَ: (نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ)(451)، وكذلك شبله (عليه السلام)، الوعد الحسن هو وعده تعالىٰ بالمغفرة والجنة(452)، وقوله: ﴿فَهُوَ لاقِيهِ﴾ تأكيد علىٰ أنَّ وعد الله لا يتخلَّف أبداً ولابدّ أن يكون كذلك، لأنَّ تخلُّف الوعد إمّا ناشئ عن الجهل أو العجز، وكلاهما مستحيل علىٰ ذات الله المقدسة(453).
- الإيثار: قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) فِي قَوْلِه تعالىٰ: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة﴾ (الحشر: 9): (نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عليهم السلام))(454)، إيثار الشيء اختياره وتقديمه علىٰ غيره، والخصاصة الفقر والحاجة(455).
- بيوت الله: قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصال﴾ [النور: 36]: «بُيُوتُ آلِ مُحَمَّدِ، بَيْتُ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(456)، الإذن في الشيء هو إعلام ارتفاع المانع عن فعله، والمراد بالرفع رفع القدر والمنزلة وهو التعظيم، تسبيحه تعالىٰ تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه، والغدو جمع غداة وهو الصبح والآصال جمع أصيل وهو العصر(457).
- الإخراج: قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ (الحج: 40) كونهم مظلومين(458)، وذنبهم الوحيد أنَّهم موحّدون(459)، فقد قَالَ أبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «نَزَلَ فِي عَلِيٌّ وَجَرَتْ فِي الْحُسَيْنُ»(460).
- الجهاد: قوله تعالىٰ: ﴿وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (التوبة: 19) ما استطاع ببذل ما عنده من مال ونفس(461)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالمُنافِقِينَ﴾: «جَاهَدَ عَلِيٌّ (عليه السلام) جِهَادَ رَسُولِ الله»(462)، وقد جاء في الزيارة: «أَشهَدُ أَنَّكَ جاهَدتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِه»، كذلك شبله لما جاء في زيارة الأربعين: «أشهَدُ أنَّكَ جاهَدتَ فِي سَبيلِهِ حتَّىٰ أتاكَ اليَقينُ»، جهاد القوم ومجاهدتهم بذل غاية الجهد في مقاومتهم وهو يكون باللسان وباليد حتَّىٰ ينتهي إلىٰ القتال، وشاع استعماله في الكتاب في القتال(463).
- جزاء الأعداء: عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)، عَنِ النَّبِيِّ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): أَنَّهُ تَلَا: ﴿فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ (البقرة: 257) قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَصْحَابُ النَّارِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ عَلِيّاً بَعْدِي، أُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ»(464)، وكذلك مصير أعداء شبله (عليه السلام) كما جاء في زيارته: «وَأَشْهَدُ أَنَّ قاتِلَكَ فِي النَّارِ»، وقد قال رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم): «إن قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا وقد شدت يداه ورجلاه بسلاسل من نار منكس في النار حتَّىٰ يقع في قعر جهنم وله ريح يتعوذ أهل النار إلىٰ ربهم من شدة نتنه وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم مع جميع من شايع علىٰ قتله كلما نضجت جلودهم بدل الله (عزَّ وجلَّ) عليهم الجلود حتَّىٰ يذوقوا العذاب الأليم لا يفتر عنهم ساعة ويسقون من حميم جهنم فالويل لهم من عذاب الله تعالىٰ في النار»(465).
- التزايل: قوله تعالىٰ: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (الفتح: 25) قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّهُ كَانَ لِلهِ وَدَائِعُ مُؤْمِنُونَ فِي أَصْلاَبِ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمُنَافِقِينَ، فَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِيَقْتُلَ الْآبَاءَ حتَّىٰ تَخْرُجَ الْوَدَائِعُ، فَلَمَّا خَرَجَتْ، ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَ وَقَتَلَهُ»(466)، روي أنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) كان يوم الطف إذا حمل علىٰ العسكر يقتل بعضاً ويترك آخرين مع تمكنه من قتلهم. فقيل له في ذلك، فقال: كشف عن بصري فأبصرت النطف التي في أصلابهم، فصرفت عن نطفة من هو من أهل الإيمان فتركته عن القتل لاستخلاص تلك الذرية منه، ورأيت من لم تخرج منه نطفته صالحة فقتلته(467).
- المحكمات والراسخون: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله تَعَالَىٰ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ﴾، وقوله تعالىٰ: ﴿ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْم﴾ [آل عمران: 7] قَالَ: «أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةُ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(468)، وقال (عليه السلام): «نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ»(469).
- الأعراف: قوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَىٰ الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيماهُمْ﴾ المراد بالأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار وهو المحل المشرف علىٰ الفريقين أهل الجنة وأهل النار جميعاً، والسيماء العلامة(470)، قَالَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «نَحْنُ عَلَىٰ الْأَعْرَافِ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنْصَارَنَا بِسِيمَاهُمْ وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ الَّذِينَ لاَ يُعْرَفُ الله (عزَّ وجلَّ) إِلَّا بِسَبِيلِ مَعْرِفَتِنَا، وَنَحْنُ الْأَعْرَافُ يُوقِفُنَا الله (عزَّ وجلَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ الصِّرَاطِ، فَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَنَا وَعَرَفْنَاهُ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَنَا وَأَنْكَرْنَاهُ»(471).
- الخليفة: ﴿إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30)، أنَّ المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه علىٰ ظهر الأرض(472)، فقد ثبت أنَّ جميع الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) هم خلفاء الله في أرضه، وأنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وأولاده المعصومين أحدهم كما ورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَنْصارِ اللهِ وَخُلَفائِهِ، رَضِيَكُم خُلَفاءَ في أرضِهِ»، قَالَ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يَا عَلِيُّ أَنْتَ خَلِيفَتِي عَلَىٰ أُمَّتِي، يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَصِيِّي وَوَارِثِي»(473)، كذلك شبله (عليه السلام). وَعَنِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) يَقُولُ: «الْأَئِمَّةُ خُلَفَاءُ الله (عزَّ وجلَّ) فِي أَرْضِهِ»(474)، وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(475).
- المتقلبين: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ﴾ (الشعراء: 217-219)، قَالَ: «فِي عَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)»(476)، أنَّ المراد بالساجدين الساجدون في الصلاة من المؤمنين(477).
- الشاكرين: عن ابن عبّاس، في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَيَجْزِي الله الشّاكِرِينَ﴾ (يَعْنِي بِالشَّاكِرِينَ صَاحِبَكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام))(478)، يعني شكر الله له ثباته(479)، وبذلك مدح القرآن الكريم استقامتهم وصمودهم، ووصفهم بالشاكرين لأنَّهم أحسنوا الاستفادة والانتفاع بالنعم في سبيل الله، وهذا أفضل مصاديق الشكر(480)، وكذلك شبله (عليه السلام) قال: «اللَّهم لك الحمد والشكر بجميع محامدك كلّها علىٰ جميع نعمائك كلّها حتَّىٰ ينتهي الحمد إلىٰ ما تحب ربّنا وترضىٰ»(481)، وأنَّ الشكر لا يتم إلَّا مع الإخلاص لله سبحانه علماً وعملاً، فالشاكرون هم المخلصون لله، الذين لا مطمع للشيطان فيهم(482).
- الصابرين: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ﴾ يَعْنِي صَبَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (عليهم السلام)(483)، يَعْنِي جَزَيْتُهُمْ بِالْجَنَّةِ الْيَوْمَ بِصَبْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ الطَّاعَاتِ وَعَلَىٰ الْجُوعِ وَالْفَقْرِ، وبِمَا صَبَرُوا عَلَىٰ المَعَاصِي وَصَبَرُوا عَلَىٰ الْبَلَاءِ لِلهِ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ وَالنَّاجُونَ مِنَ الْحِسَابِ(484)، والمراد باليوم يوم الجزاء، ومتعلّق الصبر معلوم من السياق محذوف للإيجاز أي صبروا علىٰ ذكري مع سخريتكم منهم لأجله، وقوله: ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ﴾ مسوق للحصر أي هم الفائزون دونكم(485).
- علي بن إبراهيم: في قوله تعالىٰ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرة﴾ (الزمر: 9) نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام)(486) ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾، كذلك شبله (عليه السلام) مثله، قوله: ﴿قانِتٌ﴾ من مادة قنوت بمعنىٰ ملازمة الطاعة المقرونة بالخشوع والخضوع، وقوله: ﴿آناءَ﴾ هي جمع (انا) علىٰ وزن كذا – وتعني ساعة أو مقداراً من الوقت، ﴿قانِتٌ آناءَ﴾ وردت هنا بصيغة اسم فاعل، وكلمة ﴿اللَّيْلِ﴾ جاءت مطلقة لتشير إلىٰ استمرار عبودية وخضوع أُولئك لله سبحانه(487).
- فضل الله ورحمته: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَوْ لا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ قَال: «الْفَضْلُ: رَسُولُ الله (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ)، ﴿وَرَحْمَتُهُ﴾: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»، وَعَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام)، قَالَ: «الرَّحْمَةُ: رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)، وَالْفَضْل: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»(488)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فهو رحمة الله الواسعة.
- السابق بالخيرات: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: «وَأَمَّا السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ: فَعَلِيٌّ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، وَمَنْ قُتِلَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) شَهِيداً»(489)، المراد بالسابق بالخيرات بإذن الله من سبق الظالم والمقتصد إلىٰ درجات القرب فهو إمام غيره بإذن الله بسبب فعل الخيرات(490).
- السبيل والصراط: قَالَ أَبو جَعْفَر (عليه السلام) بقوله تعالىٰ: ﴿سَبِيلُ الله﴾: «عَلِيٌّ وَذُرِّيَّتُهُ»(491)، وقال (عليه السلام): «نَحْنُ السَّبِيلُ لِمَنِ اقْتَدَىٰ بِنَا»(492)، وَعَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: ﴿وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قَالَ: «أَتَدْرِي مَا يَعْنِي بـ﴿صِراطِي مُسْتَقِيماً﴾»؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «وَلاَيَةَ عَلِيٍّ وَالْأَوْصِيَاءِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا يَعْنِي ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾»؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ)»، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا يَعْنِي ﴿وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»؟. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «وَلاَيَةَ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، وَالله»، قَالَ: «وَتَدْرِي مَا يَعْنِي ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾»؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «يَعْنِي سَبِيلَ عَلِيٍّ (عليه السلام)»(493).
- الأبرار: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: «كُلُّ مَا فِي كِتَابِ الله (عزَّ وجلَّ) ﴿إِنَّ الْأَبْرارَ﴾ فَوَ الله مَا أَرَادَ بِهِ إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) وَفَاطِمَةَ وَأَنَا وَالْحُسَيْنَ لِأَنَّا نَحْنُ أَبْرَارٌ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَقُلُوبُنَا عَلَتْ بِالطَّاعَاتِ وَالْبِرِّ وَتَبَرَّأَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَحُبِّهَا وَأَطَعْنَا الله فِي جَمِيعِ فَرَائِضِهِ وَآمَنَّا بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَصَدَّقْنَا بِرَسُولِهِ»(494).
- قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «أُوتِيتُ عِلْمَ المَنَايَا وَالْبَلَايَا وَالْأَنْسَابِ ﴿وَفَصْلَ الْخِطابِ﴾»(495)، قال الإمام الرضا (عليه السلام): «يا أبا الصلت أوَ ما بلغك قول أمير المؤمنين (عليه السلام): أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلَّا معرفة اللغات»(496)، فصل الخطاب تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقه من باطله وينطبق علىٰ القضاء بين المتخاصمين في خصامه(497)، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «أُعطيت علم الأنساب والأسباب، وأعطيت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب، ومددت بعلم القدر، وإن ذلك يجري في الأوصياء من بعدي»(498).
- المحدثون: عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الشَّامِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاً (عليه السلام) يَقُولُ: «إِنِّي وَأَوْصِيَائِي مِنْ وُلْدِي أَئِمَّةٌ مُهْتَدُونَ، كُلُّنَا مُحَدَّثُونَ»، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، ثُمَّ ابْنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ – قَالَ: وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ رَضِيعٌ – ثُمَّ ثَمَانِيَةٌ مِنْ بَعْدِهِ، وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ»،… قَالَ سُلَيْمٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَكَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مُحَدَّثاً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَيُحَدِّثُ المَلَائِكَةُ الْأَئِمَّةَ؟ فَقَالَ: «أَوَ مَا تَقْرَأُ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ – وَلَا مُحَدَّثٍ(499)-﴾»(500).
- باب حطة: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، فِي خُطْبَتِهِ: «أَنَا بَابُ حِطَّةٍ»(501) كذلك شبه (عليه السلام) فهو باب حطة فقد جاء في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ حِطَّةٍ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كانَ مِنَ الآمِنِينَ»، وقَالَ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ»(502).
- أمين الله: جاء في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام): «السَّلامُ عَلَيكَ يا أَمينَ اللهِ في أَرضِهِ»، كذلك شبله (عليه السلام) لما جاء في زيارة الأربعين: «أشهَدُ أنَّكَ أمينُ اللهِ وَابنُ أمينِهِ»، وجاء في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا أمِينَ الرَّحْمنِ» وقال الإمام الرضا (عليه السلام): «نَحْنُ أُمَنَاءُ الله فِي أَرْضِهِ»(503).
- الصِّدِّيق: عن ابن عباس وأبي ذر قالا سمعنا النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) يقول لعلي (عليه السلام): «أنت الصديق الأكبر»(504)، كذلك شبله (عليه السلام) كما جاء في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها الصِّدِّيقُ الشَّهِيدُ».
- خير البشر: قَالَ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «علي خير البشر، فمن امترىٰ فقد كفر»(505)، كذلك شبله (عليه السلام) كما جاء في زيارة عاشوراء: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا خِيَرَةَ الله وَابْنَ خِيَرَتِهِ».
- الشجاعة: جاء في الزيارة الناحية: «فَثَبَتَّ لِلطَّعْنِ والضَّرْبِ، وطَحَنْتَ جُنُودَ الفُجَّارِ، وَاقْتَحَمْتَ قَسْطَلَ الغُبَارِ، مُجَاهِداً بِذِي الفِقَارِ، كَأنَّكَ عَلِيٌّ المُخْتَارُ».
- العبادة: فقد كان – أمير المؤمنين (عليه السلام) – أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوماً، ومنه تعلم الناس صلاة الليل، وملازمة الأوراد وقيام النافلة، وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته علىٰ ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير، فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه وتمرّ علىٰ صماخيه يميناً وشمالاً، فلا يرتاع لذلك، ولا يقوم حتَّىٰ يفرغ من وظيفته، وما ظنّك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده(506)، وكذلك شبله (عليه السلام) في يوم التاسع من محرم لما أراد عمر بن سعد أن يشرع بالقتال بعث إليهم الحسين (عليه السلام) أخاه العباس يستمهلهم سواد الليلة قائلاً: «ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخِّرهم إلىٰ غدوة وتدفعهم عنّا العشية، لعلَّنا نصلّي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار»(507).
- الزهد: قَالَ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) فِي بَعْضِ خُطَبِهِ: «وَالله لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ: أَلاَ تَنْبِذُهَا؟ فَقُلْتُ: اُعْزُبْ عَنِّي، فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يُحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَىٰ»(508)، وقال (عليه السلام): «يا دنيا يا دنيا إليك عنّي، أبي تعرَّضتِ، أم إليَّ تشوَّفتِ! لا حان حينك، هيهات، غرّي غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلَّقتك ثلاثاً لا رجعة فيها»(509)، وقال (عليه السلام): «لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز»(510)، وكذلك شبله (عليه السلام) كما في الزيارة الناحية: «كُنْتَ زاهِداً في الدُّنيَا زُهْدَ الرَّاحِلِ عَنْها، نَاظِراً إِلَيها بِعَينِ المُسْتَوحِشِينَ مِنْها آمَالُكَ عَنْها مَكفُوفَةٌ، وهِمَّتُكَ عَنْ زِينَتِهَا مَصْرُوفَةٌ، وَأَلحَاظِكَ عَن بَهْجَتِهَا مَصرُوفَةٌ، وَرَغْبَتِكَ فِي الآخِرَة مَعرُوفَةٌ».
- الصبر: قَالَ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) فِي بَعْضِ خُطَبِه: «فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ هَاتَا أَحْجَىٰ فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَىٰ وَفِي الْحَلْقِ شَجىٰ، أَرَىٰ تُرَاثِي نَهْباً»(511)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) كان صابراً إلَّا أنَّه فاق صبره الحدود فقد جاء في زيارة الناحية: «وَأنْتَ مُقْدَّمٌ في الهَبَوَاتِ، ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ، قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ، فَأحْدَقُوا بِكَ مِنْ كِلِّ الجِّهَاتِ، وأثْخَنُوكَ بِالجِّرَاحِ، وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَينَ الرَّوَاحِ، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، وَأنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ»، وقال (عليه السلام) في دعائه: «صَبراً علىٰ قضائِكَ يا ربِّ، لا إلهَ سِواكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ، ما لي ربٌّ سِواكَ ولا معبودٌ غيرُكَ، صبراً علىٰ حُكْمِك، يا غِياثَ من لا غِيَاثَ له»(512).
- الحب والبغض: قَالَ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ الله، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيّاً فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ الله»(513)، كذلك شبله (عليه السلام).
- إرث النبوة: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: «تَرَكَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) فِي المَتَاعِ سَيْفاً وَدِرْعاً وَعَنَزَةً وَرَحْلاً وَبَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ فَوَرِثَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام)»(514)، وورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيما عندهم من رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وآثاره وآثار الأنبياء: «إن عندي ألواح موسىٰ، وعصاه، وحجره، وقميص يوسف، وخاتم سليمان، وإن عندي الطشت الذي يقرب به موسىٰ القربان، وإن عندي التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله، وعندي سلاح رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) ورايته، ودرعه، وسيفه، ولامته، ومغفره، وعمامته، وقميصه، لمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله وَرِثَ عَلِيٌّ عِلْمَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَا هُنَالِكَ ثُمَّ صَارَ إلىٰ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»(515).
- الأيتام: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) أباً حنوناً رؤوفاً للأيتام، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي خُطْبَتِهِ: «أَنَا أَبُو الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، وَأَنَا مَلْجَأُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَأْمَنُ كُلِّ خَائِفٍ»(516)، كذلك شبله (عليه السلام) فقد ورد في الزيارة الناحية: «كُنْتَ رَبيعَ الأيْتَامِ، سَالِكاً طَرائِقَ أبِيكَ».
- الاستجارة بالأخ: ورد أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما استضعفوه أصحاب السقيفة – لعنهم الله – استجار بأخيه جعفر قائلاً: «وا جعفراه ولا جعفر لي اليوم»(517)، كذلك شبله (عليه السلام) استجار بأخيه العباس فقال عنه الأُزُرِي: (يَوْمٌ أَبُو الْفَضْلِ اسْتَجَارَ بِهِ الْهُدَىٰ).
- التوسل بهما: «يا أبا الْحَسَن يا أميرَ المُؤمنينَ يا عَليَ بْن أبي طالِب يا حُجَةَ الله عَلىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله، يا أبا عَبْدِ الله يا حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أيُها الشَهِيدُ يا بْنَ رَسُول الله يا حُجَةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله».
- الصلاة عليهما: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ أمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أخي نَبِيِّكَ وَوَلِيِّهِ وَصَفِيِّهِ وَوَزِيرِهِ وَمُستَودَعِ عِلمِهِ وَمَوضِعِ سِرِّهِ وَبابِ حِكمَتِهِ وَالنَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَالداعي إلىٰ شَرِيعَتِهِ وَخَلِيفَتِهِ في أُمَّتِهِ وَمُفَرِّجَ الكَربِ عَن وَجهِهِ، قاصِمِ الكَفَرَةِ وَمُرغِمِ الفَجَرَةِ الَّذي جَعَلتَهُ مِن نَبِيِّكَ بِمَنزِلَةِ هارُونَ مِن مُوسىٰ، اللهُمَّ والِ مَن والاهُ وَعادِ مَن عاداهُ وَانصُر مَن نَصَرَهُ وَاخذُل مَن خَذَلَهُ وَالعَن مَن نَصَبَ لَهُ مِنَ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَيهِ أفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أحَدٍ مِن أوصياء أنبيائِكَ يا رَبَّ العالَمِينَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلىٰ الحُسَينِ المَظلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ العَبَراتِ وَأَسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَةً زاكِيَةً مُبارَكَةً يَصعَدُ أَوَّلُها وَلا يَنفَد آخِرُها أَفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِن أَولادِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينَ يا رَبَّ العالَمِينَ، اللهمَّ صَلِّ عَلىٰ الإمام الشَّهِيدِ المَقتُولِ المَظلُومِ المَخذُولِ وَالسَيِّدِ القائِدِ وَالعابِدِ وَالزَّاهِدِ»(518).
- الصلابة علىٰ الحق: قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): نبايعك علىٰ كتاب الله وسُنَّة رسول الله وسيرة الشيخين، فقال (عليه السلام): «بل علىٰ كتاب الله وسُنَّة رسوله»(519). كذلك شبله (عليه السلام) قال: «مثلي لا يبايع مثله»(520).
- الحق: قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ»(521)، كذلك شبله (عليه السلام).
- مواجه الظلمة: واجه أمير المؤمنين (عليه السلام) أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم، أمّا سبطه (عليه السلام) فقد واجه يزيد وجيشه وأتباعه الظلمة.
- قال رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يا علي حربك حربي وسلمك سلمي»(522)، كذلك شبله (عليه السلام).
- الأُبوة: ورد في زيارة أمير المؤمنين: «السَّلامُ عَلىٰ أَبِي الأَئِمَّةِ»، كذلك شبله (عليه السلام).
- كلاهما استمرت ذريتهما؛ وكلاهما قُتِلَ أولادهما في معركة الطف، أمّا أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) فهم العباس (عليه السلام)، وعبد الله، وجعفر، وعثمان، وأبي بكر، ومحمد الأصغر، والعباس الأصغر(523)؛ وأولاد الإمام الحسين (عليه السلام) علي الأكبر والرضيع.
- أخيراً وليس آخراً قد ورث الإمام الحسين (عليه السلام) من أبيه (عليه السلام) حلمه، وفصاحته، وسخاءه، وكرمه، وخلقه، وتقواه، وذي فقاره وغيرها من الأمور المادية والمعنوية.
الفصل الثامن: السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ
- المودة: قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (الشورىٰ: 23) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): «الْقُرْبىٰ فَاطِمَةُ وَأَوْلَادُهَا»(524)، معنىٰ ﴿الْقُرْبَىٰ﴾ هو التقرُّب إلىٰ الله، و﴿المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ هي التودُّد إليه تعالىٰ بالطاعة والتقرب فالمعنىٰ: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا﴾ أن توددوا إليه تعالىٰ بالتقرب إليه(525).
- الشبه: قوله تعالىٰ: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ (الانفطار: 8) قال الإمام الحسن (عليه السلام): «كانَ الحُسَينُ (عليه السلام) أشبَهَ النّاسِ بِفاطِمَةَ»(526).
- الأذىٰ: قوله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ (الأحزاب: 58) يَعْنِي عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)(527) فقد ضربوها وعصروها بين الحائط والباب، وكذلك ولدها فلذة كبدها (عليه السلام) ضربوه بالسيوف، والحجارة، والرماح، والسهام، والنبال كما جاء في الزيارة الناحية: «وَرَشَقُوكَ بِالسِّهَامِ وَالنِّبَالِ».
- كسر الأضلاع: أشارت الروايات قد كُسِرَ ضلع الزهراء (عليها السلام)، كذلك فلذة كبدها (عليه السلام) فقد رضوا صدره، وطحنوا أضلاعه، كما ورد في الزيارة الناحية: «تَطَؤُكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِهَا».
- الصالحون: قوله تعالىٰ: ﴿أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ… وَالصَّالِحِينَ﴾ (النساء: 69) الصّالحون: وهم الذين بلغوا بأعمالهم الصالحة والمفيدة وباتِّباع الأنبياء وأوامرهم إلىٰ مراتب عالية ومقامات رفيعة(528)، قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «أَمَّا الصَّالِحُونَ فَابْنَتِي فَاطِمَةُ وَأَوْلَادُهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ»(529).
- المعطلون: قوله تعالىٰ: ﴿بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ﴾ (الحج: 45) قال الإمام الصادق (عليه السلام): «فَاطِمَةُ وَوَلَدَيْهَا مُعَطَّلُونَ مِنَ المُلْكِ»(530).
- رحمة الله: قوله تعالىٰ: ﴿وَلَوْلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ (النور: 10) عنِ ابنِ عباسٍ (رضي الله عنه): (رَحْمَتُهُ فَاطِمَةُ)(531)، وكذلك ولدها (عليه السلام) فهو رحمة الله الواسعة، ولا شك في أنَّ الفضل والرحمة الإلهية ينقذان الإنسان من الانحطاط والانحراف من الذنوب جميعاً(532).
- الليلة المباركة: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: 3)، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): «أَمَّا اللَّيْلَةُ فَفَاطِمَةُ (عَلَيْهَا السَّلاَمُ)»(533)، ومن أسمائها (المباركة)، فـ(المبارك) من مادة بركة، وهي الربح والمنفعة والخلود والدوام(534)، وكذلك ولدها (عليه السلام) فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «نَحْنُ الَّليَالِي وَالأَيَّامُ»(535)، وورد في الزيارة الجامعة: «السَّلامُ عَلىٰ مَساكِنِ بَرَكَةِ الله».
- الإجابة: قوله تعالىٰ: ﴿فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (آل عمران: 195)، فاطمة وزوجها(536)، كذلك ولدهما (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ)، التعبير بلفظة ﴿رَبُّهُمْ﴾ حكاية عن غاية اللّطف، ومنتهىٰ الرحمة الإِلهية بالنسبة إليهم(537).
- الشفاعة: قوله تعالىٰ: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضـىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (الأنبياء: 28) (جعل الله مهر فاطمة الزهراء (عليها السلام) شفاعة المذنبين من أُمّة أبيها (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) يوم الحشر)(538)، وقال رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «يا فاطمة، أبشري فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك»(539)، وكذلك ولدها (عليه السلام) فهو شفيع المذنبين، فإنَّ شفاعة الشفعاء تشمل فقط أُولئك الذين بلغوا مرتبة (الارتضاء) أي القبول لدىٰ الله سبحانه وتعالىٰ(540)، وقوله: ﴿وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ هي الخشية من سخطه وعذابه مع الأمن منه بسبب عدم المعصية وذلك لأنَّ جعله تعالىٰ إياهم في أمن من العذاب بما أفاض عليهم من العصمة لا يحدِّد قدرته تعالىٰ ولا ينتزع الملك من يده، فهو يملك بعد الأمن عين ما كان يملكه قبله، وهو علىٰ كل شيء قدير(541).
- البشارة: قال جابر للإمام الباقر (عليه السلام): أشهد بالله أنّي دخلت علىٰ أُمِّك فاطمة (عليها السلام) في حياة رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) فهنَّيتها بولادة الحسين ورأيت في يديها لوحاً أخضر، ظننت أنَّه من زمرُّد ورأيت فيه كتاباً أبيض، شبه لون الشمس، فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) ما هذا اللوح؟ فقالت: «هذا لوح أهداه الله إلىٰ رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) فيه اسم أبي واسم بَعْلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك»(542).
- الوعد بالنصر: ورد في الأخبار أنَّ من ألقاب السيدة (عليها السلام) المنصورة، أي المعانة، وناصرها ومعينها هو الله تبارك وتعالىٰ(543)، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): … حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ،… لِمَ سُمِّيَتْ فِي السَّمَاءِ المَنْصُورَةَ… قَالَ: هِيَ فِي السَّمَاءِ المَنْصُورَةُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ (عزَّ وجلَّ): ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الله﴾ يَعْنِي نَصْرِ الله لِمُحِبِّيهَا»(544)، كذلك ولدها (عليه السلام) فقد قال تعالىٰ: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْـرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾ (الإسراء: 33) قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، لَوْ قَتَلَ وَلِيُّهُ أَهْلَ الْأَرْضِ مَا كَانَ مُسْرِفاً، وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ (عليه السلام)»(545).
- المحدّثة: قال الإمام الصادق (عليه السلام): «إنما سُمِّيت فَاطِمَةُ مُحَدَّثَةً لأنَّ الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها»(546)، كذلك ولدها (عليه السلام)، فقد قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ): «قَوْلُ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ – وَلاَ مُحَدَّثٍ –(547)﴾ [الحج: 52] كُلُّ إِمَامٍ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتَ مُحَدَّثٌ»(548)، وعن الإمام الرِّضَا (عليه السلام): «الْإِمَامُ يَسْمَعُ وَلَا يَرَىٰ الشَّخْصَ»(549).
- هبة الاسم: عَنْ أَبِي عَبْدُ الله (عليه السلام)، قَالَ النَبِي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «قَالَ الله (عزَّ وجلَّ): وَهَبْتُ لاِبْنَتِكَ اسْماً مِنْ أَسْمَائِي، وَهَبْتُ لِسِبْطَيْكَ اسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِي»(550).
- نصرة الملائكة: قال سلمان المحمدي (عليه السلام): (كشف لي الغطاء فرأيت ملائكة مدججين بالحراب، بينهم ملك بيده حربة من نار سأله آخرون ما تنتظر بالقوم؟ قال: أنتظر فاطمة أن تكشف عن قناعها)(551)، كذلك جاء في الخبر: (فإذا بالملائكة قد ملأوا بين السماوات والأرض بأيديهم حراب من النار ينتظرون لحكم الحسين (عليه السلام)، وأمره فيما يأمرهم به من إعدام هؤلاء الفسقة)(552).
- مواجه الظلمة: واجهت الزهراء (عليها السلام) غاصبي حقّها الظالمين أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، أمّا ولدها (عليه السلام) فقد واجه يزيد وجيشه وأتباعه الظلمة لعنهم الله.
- التركة: قال أبو جعفر (عليه السلام): «ورث علي (عليه السلام) علم رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وورثت فاطمة (عليها السلام) تركته»(553)، وعن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من ورث رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: «فاطمة (عليها السلام) وورثته متاع البيت والخرثي(554) وكل ما كان له»(555)، كذلك ولدها (عليه السلام) إذ قال (عليه السلام) لأعدائه: «هل تعلمون أنَّ هذا سيف رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) أنا متقلده»؟ قالوا: اللهم نعم، قال: «أنشدكم الله هل تعلمون أنَّ هذه عمامة رسول الله أنا لابسها»؟ قالوا: اللهم نعم(556).
- الزهد: كانت السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) علىٰ جانب كبير من الزهد، فهي بنت أزهد الزهاد، ومعنىٰ الزهد: التخلي عن الشيء وتركه وعدم الرغبة فيه، وكلما ازداد الإنسان شوقاً إلىٰ الآخرة ازداد زهداً في الدنيا، وكلما عظمت الآخرة في نفس الإنسان صغرت الدنيا في عينيه وهانت، وهكذا كلما ازداد الإنسان عقلاً وعلماً وإيماناً بالله ازداد تحقيراً واستخفافاً لملذات الحياة، ولَعلَّ في قصة العقد المبارك – الذي قَدَّمَتْهُ الزهراء (عليها السلام) إلىٰ الفقير الذي جاء إلىٰ أبيها (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم)، فأرشده النبي إلىٰ دار فاطمة (عليها السلام) – خَيرُ شَاهدٍ علىٰ زهدها (عليها السلام)، فإنَّ في ذلك أروع الأمثلة في الإحسان، والإيثار والمواساة، وكذلك ولدها (عليه السلام) كما في الزيارة الناحية: «كُنْتَ زاهِداً في الدُّنيَا زُهْدَ الرَّاحِلِ عَنْها، نَاظِراً إِلَيها بِعَينِ المُسْتَوحِشِينَ مِنْها آمَالُكَ عَنْها مَكفُوفَةٌ، وهِمَّتُكَ عَنْ زِينَتِهَا مَصْرُوفَةٌ، وَأَلحَاظِكَ عَن بَهْجَتِهَا مَصرُوفَةٌ، وَرَغْبَتِكَ فِي الآخِرَة مَعرُوفَةٌ».
- التوسل بهما: «يا فاطِمَةَ الزَهْراء يا بِنْتَ مُحَمَد يا قُرَةَ عَينِ الرَسُولِ يا سَيدتَنا وَمَوْلاتَنَا إنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكِ إلىٰ الله وَقَدَّمْناكِ بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهةً عِنْد الله اشْفَعْي لَنَا عَنْد الله… يا أبا عَبْدِ الله يا حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أيُها الشَهِيدُ يا بْنَ رَسُول الله يا حُجَةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله».
- الصلاة عليهما: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ الصِّدِّيقَةِ فاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَأُمِّ أحِبَّائِكَ وَأصفيائِكَ الَّتي انتَجَبتَها وَفَضَّلتَها وَاختَرتَها عَلىٰ نِساءِ العالَمِينَ، اللَّهُمَّ كُن الطَّالِبَ لَها مِمَّن ظَلَمَها وَاستَخَفَّ بِحَقِّها وَكُن الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أولادِها، اللهُمَّ وَكَما جَعَلتَها أُمَّ أئِمَّةِ الهُدىٰ وَحَلِيلَةَ صاحِبِ اللِّواءِ وَالكَرِيمَةَ عِندَ المَلأ الأعلىٰ فَصَلِّ عَلَيها وَعَلىٰ أُمِّها صَلاةً تُكرِمُ بِها وَجهَ مُحَمَّدٍ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) وَتُقِرُّ بِها أعيُنَ ذُرِّيَّتِها، وَأبلِغهُم عَنّي في هذِهِ السَّاعَةِ أفضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ… اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلىٰ الحُسَينِ المَظلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ العَبَراتِ وَأَسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَةً زاكِيَةً مُبارَكَةً يَصعَدُ أَوَّلُها وَلا يَنفَد آخِرُها أَفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِن أَولادِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينَ يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهمَّ صَلِّ عَلىٰ الإمام الشَّهِيدِ المَقتُولِ المَظلُومِ المَخذُولِ وَالسَيِّدِ القائِدِ وَالعابِدِ وَالزَّاهِدِ»(557).
- كلاهما ماتا غاضبين، وساخطين، وغير راضيين علىٰ أعدائهما، ومتأذين منهم.
- كلاهما من المطهرين بآية التطهير.
- مقتل بعض أولادهما في معركة الطف، الإمام الحسين (عليه السلام) ابن الزهراء (عليها السلام)، وعلي الأكبر والرضيع أولاد الإمام الحسين (عليه السلام).
- كلاهما استمرت ذريتهما إلىٰ يومنا هذا.
- ورث الإمام الحسين (عليه السلام) اللوح الذي كان مكتوب فيه أسماء الأوصياء (عليهم الصلاة والسلام).
الفصل التاسع: السَّلامُ علَيكَ يا وارِثَ الحَسَنِ الرَضِي
- الخليفة: ﴿إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: 30)، أنَّ المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه علىٰ ظهر الأرض(558)، فقد ثبت أنَّ جميع الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) هم خلفاء الله في أرضه، وأنَّ الإمامين الحسنين (عليه السلام) أحدهم كما ورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَنْصارِ اللهِ وَخُلَفائِهِ، رَضِيَكُم خُلَفاءَ في أرضِهِ»، كذلك شبله (عليه السلام). وَعَنِ الْجَعْفَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) يَقُولُ: «الْأَئِمَّةُ خُلَفَاءُ الله (عزَّ وجلَّ) فِي أَرْضِهِ»(559)، وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)»(560).
- الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر: قوله تعالىٰ: ﴿الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَر﴾ (التوبة: 112)، وهم يدعون الناس لعمل الخير، ولم يقتنعوا بهذه الدعوة للخير، بل حاربوا كل منكر وفساد(561)، فقد ورد في الزيارة الجامعة: «أَمَرْتُمْ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ المُنْكَرِ».
- الطاعة: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)، فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، قَالَ: «الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا) إلىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»(562)، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «نَحْنُ وَالله الَّذِينَ أَمَرَ الله الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِمْ»(563) وقال (عليه السلام): «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ الله طَاعَتَنَا»(564)، إنَّ المراد بالأمر في ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ هو الشأن الراجع إلىٰ دين المؤمنين المخاطبين بهذا الخطاب أو دنياهم(565).
- الهداية: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ)، قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي وُلْدِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلاَمُ) خَاصَّةً ﴿وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لمّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ﴾»(566)، وقال (عليه السلام): «نَحْنُ أَئِمَّةُ الْهُدَىٰ، وَنَحْنُ مَصَابِيحُ الدُّجَىٰ، وَنَحْنُ مَنَارُ الْهُدَىٰ»(567)، لقد ذكرت الآية هنا شرطين للإمامة: أحدهما: الإيمان واليقين بآيات الله (عزَّ وجلَّ)، والثاني: الصبر والاستقامة والصمود، فإنَّ الهداية قد وردت في الآيات والروايات بمعنيين: (تبيان الطريق، والإيصال إلىٰ المطلوب)، وكذلك هداية الأئمّة الإلهيين تتَّخذ صورتين: (فيكتفون أحياناً بالأمر والنهي، وأحياناً أُخرىٰ ينفذون إلىٰ أعماق القلوب المستعدّة والجديرة بالهداية ليوصلوها إلىٰ الأهداف التربوية والمقامات المعنوية)، والتعبير بـ﴿يَهْدُونَ﴾ و﴿يُوقِنُونَ﴾ بصيغة الفعل المضارع دليل علىٰ استمرار هاتين الصفتين طيلة حياة هؤلاء، لأنَّ مسألة القيادة لا تخلو لحظة من المشكلات، ويواجه شخص القائد وإمام الناس مشكلة جديدة في كلّ خطوة، ويجب أن يهبّ لمواجهتها مستعيناً بقوّة اليقين والاستقامة المستمرّة، ويديم خطّ الهداية إلىٰ الله سبحانه(568)، وأنَّ كلمة (الهداية) لها عدَّة معاني في القرآن الكريم، وكلها تعود أساساً إلىٰ معنيين:
1 – الهداية التكوينية: وهي قيادة ربّ العالمين لموجودات الكون، وتتجلّىٰ هذه الهداية في نظام الخليقة والقوانين الطبيعية المتحكمة في الوجود، وواضح أنَّ هذه الهداية تشمل كل موجودات الكون، يقول القرآن علىٰ لسان موسىٰ (عليه السلام): ﴿رَبُّنَا الَّذِي أعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾.
2 – الهداية التشريعية: وهي التي تتم عن طريق الأنبياء والكتب السماوية، وعن طريقها يرتفع الإنسان في مدارج الكمال، وشواهدها في القرآن كثيرة منها قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾(569).
- الصراط: قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾، فالمراد بالآية أن لا تتفرَّقوا عن سبيله ولا تختلفوا فيه(570)، أي إِن طريقي هذا هو طريق التوحيد، طريق الحق والعدل، طريق الطهر والتقوىٰ فامشوا فيه، واتَّبعوه، واسلكوه ولا تسلكوا الطرق المنحرفة والمتفرِّقة، فتؤدّي بكم إلىٰ الانحراف عن الله وإِلىٰ الاختلاف، والتشرذم، والتفرُّق، وتزرع فيكم بذور الفِرقة والنفاق(571)، فقد قال النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): «الأئمة من ولد فاطمة صراط الله»(572)، وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: «نَحْنُ السَّبِيلُ، فَمَنْ أَبَىٰ فَهَذِهِ السُّبُلُ فَقَدْ كَفَرَ»(573)، وقال (عليه السلام): «نَحْنُ الطَّرِيقُ وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمِ إلىٰ الله (عزَّ وجلَّ)»(574).
- السابق بالخيرات: قوله تعالىٰ: ﴿سابِقٌ بِالْخَيْراتِ﴾ (فاطر: 32) قَالَ أَبو جَعْفَر (عليه السلام): «الْإِمَامُ فَهِيَ فِي وُلْدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ»(575)، المراد بالسابق بالخيرات بإذن الله من سبق الظالم والمقتصد إلىٰ درجات القرب فهو إمام غيره بإذن الله بسبب فعل الخيرات(576).
- سبع المثاني: قَالَ حَسَّانُ الْعَامِرِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ المَثانِي﴾ قَالَ: «نَحْنُ هُمْ وُلْدُ الْوَلَدِ»(577)، السبع المثاني هي سورة الحمد علىٰ ما فسّر في عدّة من الروايات المأثورة عن النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) فلا يصغي إلىٰ ما ذكره بعضهم(578).
- المصطفين: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا﴾ الْآيَةَ، فَقَالَ: «وُلْدُ فَاطِمَةَ (عَلَيْهَا السَّلاَمُ)»(579)، إنَّ التعبير بـ(الإرث) هنا وفي موارد أُخرىٰ مشابهة في القرآن الكريم، لأجل أنَّ الإرث يطلق علىٰ ما يستحصل بلا مشقّة أو جهد، والله سبحانه وتعالىٰ أنزل هذا الكتاب السماوي العظيم للمسلمين هكذا بلا مشقّة أو جهد(580)، المراد بـ﴿الْكِتابَ﴾ في الآية علىٰ ما يعطيه السياق هو القرآن الكريم، والاصطفاء أخذ صفوة الشيء ويقرب من معنىٰ الاختيار والفرق أنَّ الاختيار أخذ الشيء من بين الأشياء بما أنَّه خيرها والاصطفاء أخذه من بينها بما أنَّه صفوتها وخالصها، وقوله: ﴿مِنْ عِبادِنا﴾ يحتمل أن يكون ﴿مِنْ﴾ للتبيين أو للابتداء أو للتبعيض الأقرب إلىٰ الذهن أن يكون بيانية وقد قال تعالىٰ: ﴿وَسَلامٌ عَلىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ﴾(581)، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (عليه السلام)، قَالَ: «فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا الله (عزَّ وجلَّ)، ثُمَّ أَوْرَثَنَا هَذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ»(582)، ورد في زيارة الإمام الحسن المجتبىٰ (عليه السلام): «السلام عليك يا صفوة الله»، وجاء في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ الله وَابْنِ صَفِيِّهِ»، وورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَوْلِياءَ اللهِ وَأَصْفِيائِهِ»، وورد في زيارته في شهر رجب: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا صَفْوَةَ اللهِ».
- الاعتزال والقيام: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَمَرَهُ الله تَعَالَىٰ بِالْكَفِّ»، ﴿فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ﴾، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، كَتَبَ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُ»(583)، لذا فقد اعتزل الإمام الحسن المجتبىٰ (عليه السلام) القتال وصالح، والإمام الحسين (عليه السلام) اعتزل للعبادة بعد استشهاد أخيه (عليه السلام) وقام بعدها مأموراً للقتال.
إنَّ كف الأيدي كناية عن الإمساك عن القتال لكون القتل الذي يقع فيه من عمل الأيدي(584)، تتحدَّث الآية بلغة التعجُّب من أمر نفر أظهروا رغبة شديدة في الجهاد خلال ظرف غير مناسب، وأصرّوا علىٰ السماح لهم بذلك، وقد صدرت الأوامر لهم حينئذٍ بالصبر والاحتمال، ودعوا إلىٰ إِقامة الصلاة، وأداء الزكاة، وبعد أن سنحت الفرصة وآتت الظروف للجهاد بصورة كاملة وأمروا به، استولىٰ علىٰ هؤلاء النفر الخوف والرعب، وانبروا يعترضون علىٰ الأمر الإِلهي ويتهاونون في أدائه(585).
- الأنداد: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله﴾ قَالَ: «هُمْ وَالله أَوْلِيَاءُ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، اتَّخَذُوهُمْ أَئِمَّةً دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي جَعَلَهُ الله لِلنَّاسِ إِمَاماً…»، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): «هُمْ وَالله، يَا جَابِرُ أَئِمَّةُ الظَّلَمَةِ وَأَشْيَاعُهُمْ»(586)، فإنَّ الإمام الحسن المجتبىٰ (عليه السلام) رفض القيادة الظالمة وسحب البساط والشرعية من السلطان الجائر ولو كان متظاهراً بالإسلام، فقد ورد في الزيارة الناحية: «كُنْتَ لِعِمَادِ الدِّينِ رَافِعاً، وَلِلطُّغْيَانِ قَامِعاً، وَلِلطُّغَاةِ مُقَارِعاً، وَلِلْأُمَّةِ نَاصِحاً»، والأنداد جمع نِد علىٰ وزن ضدّ، وهو الشبيه والشريك، هذه الأنداد المفتعلة وما تعبدون من دون الله (587)، وأن المراد بالأنداد ليس هو الاصنام فقط بل يشمل الملائكة، وأفراداً من الإنسان الذين اتَّخذوهم أرباباً من دون الله تعالىٰ بل يعم كل مطاع من دون الله من غير أن يأذن الله في إطاعته(588).
- فيهما: قوله تعالىٰ: ﴿أَبْنَاءَنَا﴾ (آل عمران: 61) وقوله تعالىٰ: ﴿فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ﴾ (النور: 35)، وقوله تعالىٰ: ﴿رَبُّ المَغْرِبَيْنِ﴾ (الرحمن: 17)، وقوله تعالىٰ: ﴿اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجانُ﴾ (الرحمن: 22)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُون﴾ (التين: 1)، وقوله تعالىٰ: ﴿الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ (النساء: 69) المراد بالشهداء شهداء الأعمال فيما يطلق من لفظ الشهيد في القرآن، وأنَّ المراد بالصالحين هم أهل اللياقة بنعم الله(589)، وقوله تعالىٰ: ﴿كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (الحديد: 28) والكفل الحظ والنصيب فله ثواب علىٰ ثواب كما أنَّه إيمان علىٰ إيمان(590)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ (الشمس: 3) التجلية هي الإظهار والإبراز(591)، وقوله تعالىٰ: ﴿ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (الفرقان: 74) كناية عمّن يُسرَّ به، هذا التعبير أُخذ في الأصل من كلمة (قر) التي بمعنىٰ البرد، وكما هو معروف، لذا ﴿قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ بمعنىٰ الشيء الذي يسبب برودة عين الإنسان، وهذه كناية جميلة عن السرور والفرح(592)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَالشَّفْعِ﴾ (الفجر: 3) قد ورد في تأويل هذه الآيات أنَّها في الإمامين السبطين الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (صَلَوَاتُ الله وسَلْامُهُ عَلَيْهِما)(593).
- الصلاة عليهما: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ عَبْدَيْكَ وَوَلِيَّيْكَ وَابْنَيْ رَسُولِكَ وَسِبْطَي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدَي شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ أَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلادِ النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، اللهمَّ صَلِّ عَلىٰ الحَسَنِ بْنِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَوَصِيِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يا بْنَ رَسُولِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يا بْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّيَنَ، اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ عَنِّي فِي هذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ»(594)، «اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلىٰ الحُسَينِ المَظلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ العَبَراتِ وَأَسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَةً زاكِيَةً مُبارَكَةً يَصعَدُ أَوَّلُها وَلا يَنفَد آخِرُها أَفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِن أَولادِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينَ يا رَبَّ العالَمِينَ. اللهمَّ صَلِّ عَلىٰ الإمام الشَّهِيدِ المَقتُولِ المَظلُومِ المَخذُولِ وَالسَيِّدِ القائِدِ وَالعابِدِ وَالزَّاهِدِ»(595).
- التوسل بهما: «يا أبا مُحَمد يا حَسَنَ بْنَ عَلي أيُها المُجْتَبَىٰ يَا بْنَ رَسُول الله يا حُجةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَّمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله، يا أبا عَبْدِ الله يا حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أيُها الشَهِيدُ يا بْنَ رَسُول الله يا حُجَةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يا سَيدنا وَمَوْلانَا إنَّا تَوَجَّهْنا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلنا بِكَ إلىٰ الله وَقَدَّمْناك بَيْنَ يَدَيْ حاجَاتِنا، يا وَجِيهاً عِنْد الله اشْفَعْ لَنَا عَنْد الله».
- كلاهما: مطهرين وسبطا النبي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وريحانتاه؛ وأبناء أمير المؤمنين والزهراء (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)؛ ورثا عنهم علمهم، وأخلاقهم، وتقواهم، وزهدهم، وعبادتهم، مكارمهم، وفصاحتهم، وبلاغتهم، وشجاعتهم، وسماحتهم، وفضلهم، وتواضعهم، وما يخصهم.
- إرث النبوة: ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيما عندهم من رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) وآثاره وآثار الأنبياء: «إن عندي ألواح موسىٰ، وعصاه، وحجره، وقميص يوسف، وخاتم سليمان، وإن عندي الطشت الذي يقرب به موسىٰ القربان، وإن عندي التابوت الذي جاءت به الملائكة تحمله، وعندي سلاح رسول الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) ورايته، ودرعه، وسيفه، ولامته، ومغفره، وعمامته، وقميصه، لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله وَرِثَ عَلِيٌّ عِلْمَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَا هُنَالِكَ ثُمَّ صَارَ إلىٰ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ»(596).
- الجود والسخاء: كان الإمام الحسن (عليه السلام) أجود أهل زمانه، ومضرب المثل في سخائه حتَّىٰ لقب بكريم أهل البيت مع أنَّهم معدن الكرم والجود، وكان يضارعه في كرمه أخوه سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين (عليه السلام) فقد كان من أروع وأسمىٰ أمثلة السخاء في دنيا الإسلام(597)، وقد روي أنَّ رجل سأله، فأمر له بخمسين ديناراً، وأمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة وأربعين ديناراً، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين ديناراً؛ لأنَّهم فتية فطموا العلم فطماً وحازوا الخير والحكمة(598).
- هبة الاسم: عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): «قَالَ النَبِي (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم): قَالَ الله (عزَّ وجلَّ): وَهَبْتُ لِسِبْطَيْكَ اسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَائِي فَسَمَّيْتُهُمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ»(599).
- الصلح: ورد في الروايات أنَّ الإمام الحسن (عليه السلام) عندما صالح كان الإمام الحسين (عليه السلام) مطيعاً وملتزماً بالصلح.
- مواجه الظلمة: واجه الإمام الحسن (عليه السلام) معاوية، أمّا سبطه (عليه السلام) فقد واجه يزيد وجيشه وأتباعه الظلمة.
- كسر الطوق الإعلامي: التحصين والإصلاح الإعلامي من التضليل ببيان الإمام الحسن (عليه السلام) والتضحية بالنفس من الإمام الحسين (عليه السلام).
- مقتل بعض أولادهما في معركة الطف وهم القاسم وعبد الله ابنا الإمام الحسن (عليه السلام)(600)، وعلي الأكبر وعبد الله الرضيع ابنا الإمام الحسين (عليه السلام).
- كلاهما استمرت ذريتهما إلىٰ يومنا هذا.
- كلاهما سيدا شباب أهل الجنة.
- كلاهما من المطهرين بآية التطهير.
- فصل الدين عن السلطة والسياسية، ليس بالضرورة أن يكون الحاكم ممثلاً للشرع.
الفصل العاشر: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ الْأَنبِيَاءَ
توطئة:
بعد أن أثبت الباحث ما ورثه الإمام الحسين (عليه السلام) – مادياً ومعنوياً – من الأنبياء والأوصياء المذكورين في زيارة وارث في الفصول السابقة، شرع في فصل جديد لبيان ما ورثه (عليه السلام) من الأنبياء غير المذكورين وإثبات ذلك قرآنياً وروائياً من باب أنَّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه؛ لأنَّ الدراسة لا تقتصر علىٰ الأنبياء المذكورين في زيارة وارث فحسب، بل تشمل كل الأنبياء الذين ورث منهم الإمام الحسين (عليه السلام) ويكون ذلك في مبحثين:
المبحث الأول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ يَحْيَىٰ:
- البشارة: قوله تعالىٰ: ﴿أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ (آل عمران: 39) البشرىٰ والإبشار والتبشير الإخبار بما يفرح الإنسان بوجوده، دليل علىٰ أنَّ تسميته بيحيىٰ إنَّما هو من جانب الله سبحانه(601)، فإنَّ النبي يحيىٰ (عليه السلام) قد بُشِّرَ به النبي زكريا (عليه السلام) قبل ولادته، والإمام الحسين (عليه السلام) بُشِرَ به النبي محمد (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ) قبل ولادته(602).
- التسمية: عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ (عليه السلام)، فِي قَوْلِ الله (عزَّ وجلَّ): ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً﴾ قَالَ: «ذَلِكَ يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّا (عليه السلام) لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً، وَكَذَلِكَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً»(603)، أي لم يسم بهذا الاسم قبله أحد، ولم يكن له شريكاً في الاسم(604).
- المظلومية: قوله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ (عليه السلام)، لَوْ قَتَلَ وَلِيُّهُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِهِ مَا كَانَ مُسْرِفاً، وَوَلِيُّهُ الْقَائِمُ (عليه السلام)»(605)، المراد بجعل السلطان لوليه تسليطه شرعاً علىٰ قتل قاتل وليه قصاصاً، والمعنىٰ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا بحسب التشريع لوليه وهو ولي دمه سلطنة علىٰ القصاص، فلا يفوته القاتل(606)، وَرَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً﴾: «فَإِنَّهُ لا يَذْهَبُ مِنَ الدُّنْيَا حتَّىٰ يُنْتَصَرَ بِرَجُلٍ مِنْ آلِ الرَّسُولِ (صَلَّىٰ الله عَلَيْهِمْ) يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً»(607)، وأنَّ المراد بالنصر هو تشريع حكم للمظلوم يتدارك به ما وقع عليه من وصمة الظلم والبغي فإنَّ في إذنه أن يعامل الظالم الباغي عليه بمثل ما فعل بسطا ليده علىٰ من بسط عليه اليد(608)، وَقَالَ الإمام الباقر (عليه السلام): «إِنَّ الْحُسَيْنَ صَاحِبَ كَرْبَلَاءَ قُتِلَ مَظْلُوماً مَكْرُوباً»(609)، وورد في زيارة الأربعين: «اَلسَّلامُ عَلىٰ الْحُسَيْنِ المَظْلُومِ الشَّهيدِ»، كذلك النبي يحيىٰ (عليه السلام) قتل مظلوماً.
- البكاء: قوله تعالىٰ: ﴿بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرضُ﴾ (الدخان: 29) قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إنَّ الحسين (عليه السلام) بكي لقتله السّماء والأرض واحمرّتا، ولم تبكيا علىٰ أحدٍ قطّ إلَّا علىٰ يحيىٰ بن زكريّا والحسين بن عليّ (عليه السلام)»(610)، وليس هذا فحسب بل جاء في الزيارة الناحية أنَّه قد «بَكَتِ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا، وَالجِنَانُ وَخُزَّانُهَا، وَالهِضَابُ وَأقْطَارُهَا، وَالبِحَارُ وَحِيتَانُها، وَالجِنَانُ وَولْدَانُهَا، وَالبَيتُ وَالمَقَامُ، وَالمَشْعَرُ الحَرَام، وَالحِلُّ والإِحْرَامُ».
- السلام: قوله تعالىٰ: ﴿سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً﴾ (مريم: 15)، السلام قريب المعنىٰ من الأمن، والذي يظهر من موارد استعمالها في الفرق بينهما أنَّ الأمن خلو المحل مما يكرهه الإنسان ويخاف منه والسلام كون المحل بحيث كل ما يلقاه الإنسان فيه فهو يلائمه من غير أن يكرهه ويخاف منه، وتنكير السلام لإفادة التفخيم أي سلام فخيم عليه مما يكرهه في هذه الأيام الثلاثة التي كل واحد منها مفتتح عالم من العوالم التي يدخلها الإنسان ويعيش فيها فسلام عليه يوم ولد فلا يمسه مكروه في الدنيا يزاحم سعادته، وسلام عليه يوم يموت، فسيعيش في البرزخ عيشة نعيمة، وسلام عليه يوم يبعث حيا فيحيا فيها بحقيقة الحياة ولا نصب ولا تعب، وقيل: إنَّ تقييد البعث بقوله: ﴿حَيّاً﴾ للدلالة علىٰ أنَّه سيقتل شهيداً لقوله تعالىٰ في الشهداء لقوله تعالىٰ: ﴿بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (آل عمران: 169). واختلاف التعبير في قوله: ﴿وُلِدَ﴾ ﴿يَمُوتُ﴾ ﴿يُبْعَثُ﴾ لتمثيل أن التسليم في حال حياته (عليه السلام)(611)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) اسْمُهُ يَاسِينُ، وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ الله: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِلْياسِينَ﴾ [الصافات: 130]»(612)، وعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) قَالَ: «يَس مُحَمَّدٌ، وَنَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ»(613).
- السيد: قوله تعالىٰ: ﴿مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله وَسَيِّداً﴾ السيد هو الذي يتولىٰ أمر سواد الناس وجماعتهم في أمر حيوتهم ومعاشهم أو في فضيلة من الفضائل المحمودة عندهم ثم غلب استعماله في شريف القوم لما أن التولي المذكور يستلزم شرفاً بالحكم أو المال أو فضيلة أخرىٰ، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فهو سيد شباب أهل الجنة.
- مواجه الظلمة: واجه النبي يحيىٰ (عليه السلام) ظلمة زمانه والطاغية، أمّا الإمام الحسين (عليه السلام) فقد واجه يزيد وجيشه وأتباعه الظلمة.
- الذبح والشهادة: شهادة النبي يحيىٰ (عليه السلام) تشبه شهادة الإمام الحسين (عليه السلام) حيث ذبحا وقطع رأسهما، جاء في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ يَحْيَىٰ الَّذي أزْلَفَهُ اللهُ بِشَهادَتِهِ»، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك لما جاء في الزيارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ المَقْطُوعِ الوَتِينِ، السَّلامُ عَلىٰ الرَّأسِ المَرفُوعِ»، وجاء في شهادته: «اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلىٰ الحُسَينِ المَظلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ العَبَراتِ وَأَسِيرِ الكُرُباتِ صَلاةً نامِيَةً زاكِيَةً مُبارَكَةً يَصعَدُ أَوَّلُها وَلا يَنفَد آخِرُها أَفضَلَ ما صَلَّيتَ عَلىٰ أَحَدٍ مِن أَولادِ الأَنبِياءِ وَالمُرسَلِينَ يا رَبَّ العالَمِينَ. اللهمَّ صَلِّ عَلىٰ الإمام الشَّهِيدِ المَقتُولِ المَظلُومِ المَخذُولِ وَالسَيِّدِ القائِدِ وَالعابِدِ وَالزَّاهِدِ»(614).
- الطشت: وضع رأس النبي يحيىٰ (عليه السلام) بطشت من ذهب وبعثوه إلىٰ البغية(615)، كذلك رأس الإمام الحسين (عليه السلام) وضع في طشت من ذهب وبعثوه إلىٰ يزيد البغي(616).
- إهداء الرأس: قال سيد الساجدين (عليه السلام): «خرجنا مع الحسين فما نزل منزلاً وما ارتحل منه إلَّا ذكر يحيىٰ بن زكريا وقتله، وقال يوماً: من هوان الدنيا علىٰ الله (عزَّ وجلَّ) أنَّ رأس يحيىٰ بن زكريا أُهدي إلىٰ بغي من بغايا بني إسرائيل»(617)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام).
- قاتلهما ولد زنا: قال أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «كَانَ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) وَلَدَ زِنا وَقَاتِلُ يَحْيَىٰ وَلَدَ زِنا»(618)، وورد في الزيارة الناحية: «السَّلَامُ عَلَىٰ قَتِيلِ الْأَدْعِيَاءِ»، وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنَّ قاتل الحسين بن علي (صلوات الله عليه) ابن بغي وإنَّه لم يقتل الأنبياء ولا أولادهم إلَّا أولاد البغايا»(619).
- الثأر: عندما سقط دم النبي يحيىٰ (عليه السلام) علىٰ الأرض أخذ يغلي ويفور علىٰ وجه الأرض وكلَّما ألقي عليه التراب زاد ارتفاعاً، بقي هكذا حتَّىٰ قُتِلَ من بني إسرائيل سبعين ألفاً ثأراً له حتَّىٰ سكن دمه، وكذلك دم الحسين (عليه السلام) يغلي ويستمر ولا يسكن حتَّىٰ يبعث الله القائم (عليه السلام) فيقتل قتلته حتَّىٰ يسكن(620)، وجاء في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) لما ورد في زيارته: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ الله وَابْنَ ثأرِهِ» وعنِ ابنِ عباسٍ (رضي الله عنه) قال: نزل جبريلُ علىٰ رسولِ اللهِ (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) فقال: «إنَّ اللهَ (جلَّ وعلا) قتل بيحيىٰ بنِ زكريا سبعينَ ألفاً وإنَّه قاتلٌ بابنِ بنتِكَ الحسينِ بنِ عليِّ سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «قتل بالحسين مائة ألف وما طلب بثأره، وسيطلب بثأره»(621).
- الرضاعة: النبي يحيىٰ (عليه السلام) لم يرتضع من ثدي أُمّه ورضع من البان السماء، والإمام الحسين (عليه السلام) لم يرتضع من أُمِّه بل رضع من ثدي الرسالة يعني لسان الرسول (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم)(622).
- الحمل: كلاهما كانت مدَّة حملهما ستة أشهر(623).
- النبي يحيىٰ (عليه السلام) كان يتكلَّم في بطن أُمِّه، والإمام الحسين (عليه السلام) كان يتكلَّم في بطن أُمِّه(624).
- كلاهما نطق رأسهما بعد استشهادهما(625).
- كلاهما خرجا للإصلاح ضد الفساد.
المبحث الثاني: بقية الأنبياء (عليهم السلام) غير المذكورين في الزيارة:
- منطق الحيوان: قَالَ أَبو عَبْدِ الله (عليه السلام): «إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عليه السلام) قَالَ: ﴿عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 16] وَقَدْ وَالله عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَعِلِمَ كُلِّ شَيْءٍ»(626)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله عَلَّمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، كَمَا عَلَّمَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عليه السلام) مَنْطِقَ كُلِّ دَابَّةٍ، فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ»(627)، والمنطق والنطق علىٰ ما نتعارفه هو الصوت أو الأصوات المؤلفة الدالة بالوضع علىٰ معان مقصودة للناطق المسماة كلاماً ولا يكاد يقال إلَّا للإنسان لكن القرآن الكريم يستعمله في معنىٰ أوسع من ذلك وهو دلالة الشيء علىٰ معنىٰ مقصود لنفسه، وكيف كان فمنطق الطير هو ما تدل به الطير بعضها علىٰ مقاصدها، والذي نجده عند التأمل في أحوالها الحيوية هو أن لكل صنف أو نوع منها أصواتا ساذجة خاصة في حالاتها الخاصة الاجتماعية حسب تنوع اجتماعاتها كحال الهياج للسفاد وحال المغالبة والغلبة وحال الوحشة والفزع وحال التضرع أو الاستغاثة إلىٰ غير ذلك ونظير الطير في ذلك سائر الحيوان. لكن لا ينبغي الارتياب في أن المراد بمنطق الطير في الآية معنىٰ أدق وأوسع من ذلك(628).
- التسخير: قوله تعالىٰ: ﴿مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ (سبأ: 12) أي جمع من الجن يعمل بين يديه بإذن ربّه مسخرين له(629)، والجنّ كما هو معلوم من اسمه، ذلك المخلوق المستور عن الحسّ البشري، له عقل وقدرة ومكلّف بتكاليف إلهية كما يستفاد من آيات القرآن(630)، وكذلك قد أتت أفواج من مؤمني الجن الإمام الحسين (عليه السلام) ليأتمروا بأمره ويقاتلون عدوه فجَزّاهُم خيراً، ولم يأذن لهم معللاً بقوله: «إذا أقمت بمكاني فبم يمتحن هذا الخلق المتعوس؟ وبماذا يختبرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي؟»(631).
- الخاتم: ابتُلي النبي سليمان (عليه السلام) بأخذ خاتمه بعد موته، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قُطِعَ خنصره، وسُلِبَ خاتمه الشريف بعد استشهاده (عليه السلام)(632).
- الإصلاح: قوله تعالىٰ علىٰ لسان نبيه شعيب (عليه السلام): ﴿إنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88) إنما يريد الإصلاح ما استطاع، ولا يريد منهم علىٰ ذلك أجراً إن أجره إلَّا علىٰ ربِّ العالمين(633)، فلم يكن هذا الشعار شعار شعيب فحسب، بل هو شعار جميع الأنبياء وكل القادة المخلصين، وإِنّ أعمالهم وأقوالهم شواهد علىٰ هذا الهدف، فهم لم يأتوا لإِشغال الناس، ولا لغفران الذنوب، ولا لبيع الجنّة، ولا لحماية الأقوياء وتخدير الضعفاء من الناس، بل كان هدفهم الإِصلاح بالمعنىٰ المطلق والوسيع للكلمة، الإِصلاح في الفكر، الإِصلاح في الأخلاق، الإِصلاح في النظم الثقافية والاقتصادية والسياسيّة للمجتمع، والإِصلاح في جميع أبعاد المجتمع(634)، والإمام الحسين (عليه السلام) كذلك بقوله: «إنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَلَا بَطِراً وَلَا مُفْسِداً وَلَا ظَالِماً وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي»(635).
- دعا النبي شعيب (عليه السلام) قومه لعبادة الله وحذَّرهم ونصحهم فأجابوه ﴿قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ﴾ (هود: 91)، الفقه أبلغ من الفهم وأقوىٰ، لما حاجهم شعيب (عليه السلام) وأعياهم بحجته لم يجدوا سبيلاً دون أن يقطعوا عليه كلامه من غير طريق الحجة فذكروا له أنَّ كثيراً مما يقوله غير مفهوم لهم فيذهب كلامه لغي لا أثر له، وهذا كناية عن أنَّه يتكلَّم بما لا فائدة فيه(636)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) قال له أعداؤه: (لا نفقه ما تقول يا بن فاطمة).
- التهديد: بعد دعوة النبي شعيب (عليه السلام) قومه للإصلاح هددوه بقولهم: ﴿وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ (هود: 91)، المراد بالانتهاء ترك الدعوة، والرجم هو الرمي بالحجارة(637)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) هدَّده أعدائه بالقتل إذا لم يبايع، أو ينزل عن حكم أميرهم الفاسق، فأبىٰ (صلوات الله عليه وسلامه)، فجاءهم الأمر أن (اقتلوا الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة)(638)، وقد أنباهم (عليه السلام) بذلك: «والله لا يدعوني حتَّىٰ يستخرجوا هذه العلقة من جوفي»(639).
- الصفات والخصال الحميدة: قوله تعالىٰ علىٰ لسان قوم النبي شعيب (عليه السلام): ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود: 87) كذلك هي في الإمام الحسين (عليه السلام) كما ورد في الزيارة الناحية: «كُنْتَ حَلِيمٌ، رَشِيدٌ».
- ناقة صالح: قوله تعالىٰ: ﴿فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ الله وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ (الشمس: 13-14) المقصود من ﴿رَسُولُ اللهِ﴾ نبيّ قوم ثمود صالح (عليه السلام)، وعبارة ﴿نَاقَةَ الله﴾ إشارة إلىٰ أنَّ هذه الناقة لم تكن عادية، بل كانت معجزة، تثبت صدق نبوة صالح، ومن خصائصها كما في الرواية المشهورة أنَّها خرجت من قلب صخرة في جبل لتكون حجة علىٰ المنكرين(640)، وقد جاءَ في بعضِ الرواياتِ أنَّ الإمام الحسين (عليه السلام) رمىٰ دمه ودم رضيعه نحوَ السماء فلم تسقط منه قطرة واحدة، وقال: «هوّن عليَّ ما نزل بي أنَّه بعين الله»، ثمّ قال: «اللّهم لا يكونُ أهونَ عليكَ مِنْ فصيلِ ناقةِ صالح فانتقم لنا، اللَّهمّ إن كنت حبست عنّا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لنا»(641).
- عذاب الأعداء: قوله تعالىٰ: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم بِذَنْبِهِم فَسَوَّاهَا﴾ (الشمس: 14)، قال علي بن إبراهيم القمي: أخذهم بغتة وغفلة بالليل(642)، والمراد شمولهم بعذاب يقطع دابرهم ويمحو أثرهم بسبب ذنبهم، وقوله: ﴿فَدَمْدَمَ﴾ والمعنىٰ فسوىٰ الدمدمة بينهم فلم يفلت منهم قوي ولا ضعيف ولا كبير ولا صغير(643)، وقوله: ﴿فَسَوَّاهَا﴾ بمعنىٰ إنهاء حالة هؤلاء القوم، أو تسويتهم جميعاً في العقاب والعذاب، حتَّىٰ لم يسلم أحد منهم، ومن الآية نستنتج بوضوح أنَّ عقاب هؤلاء القوم كان نتيجة لذنوبهم وكان متناسباً مع تلك الذنوب، وهذا عين الحكمة والعدالة(644)، كذلك أعداء الإمام الحسين (عليه السلام) عذبهم الله جميعاً بذنوبهم وانتقم منهم فلم يبقَ منهم أحد، ودعا علىٰ أعدائه قائلاً: «اللَّهم احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف، يسقيهم كأساً مصبرة، فإنَّهم كذّبونا وخذلونا، وأنت ربَّنا عليك توكَّلت وإليك المصير»(645)، وقال (عليه السلام): «اللهم فامنعهم بركات الأرض، وإن منعتهم ففرقهم تفريقاً، ومزقهم تمزيقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا تُرضِ الولاة عنهم أبداً، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا يقاتلونا ويقتلونا»(646)، وقال (عليه السلام): «اللَّهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً»(647)، فاستجاب له ربُّه.
- النصح: نصح النبي صالح (عليه السلام) قومه و﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (الأعراف: 79)، أي بعد هذه القضية تولىٰ صالح وهو يقول: لقد أديت رسالتي إليكم، ونصحت لكم ولكنّكم لا تحبّون من ينصحكم(648)، ونصح النبي هود (عليه السلام) قومه قائلاً: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (الأعراف: 68)، إنَّ مهمته هي إبلاغ رسالات الله إليهم، وإرشادهم إلىٰ ما فيه سعادتهم وخيرهم، وإنقاذهم من ورطة الشرك والفساد، كل ذلك مع كامل الإخلاص والنصح والأمانة والصدق(649)، أي لا شأن لي بما أني رسول إلَّا تبليغ رسالات ربي خالصاً من شوب ما تظنون بي من كوني كاذباً فلست بغاش لكم فيما أريد أن أحملكم عليه، ولا خائن لما عندي من الحق بالتغيير ولا لما عندي من حقوقكم بالإضاعة، فما أريده منكم من التدين بدين التوحيد هو الذي أراه حقاً، وهو الذي فيه نفعكم وخيركم، فإنَّما وصف نفسه بالأمين محاذاة لقولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ﴾(650)، ونصح النبي شعيب قومه و﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ (الأعراف: 93)، ونصحتكم بالمقدار الكافي، ولم آلُ جهداً في إرشادكم، ولست متأسّفاً علىٰ مصير الكافرين، لأنَّني قد بذلت كل ما في وسعي لهدايتهم وإرشادهم، ولكنّهم لم يخضعوا للحق ولم يسلّموا، فكان يجب أن ينتظروا هذا المصير المشؤوم(651)، وكذلك الإمام الحسين (عليه السلام) نصح أعدائه وقومه كما جاء في زيارة الأربعين: «مَنَحَ النُّصحَ، وَبَذَلَ مُهجَتَهُ فيكَ لِيَستَنقِذَ عِبادَكَ مِنَ الجَهالَةِ وَحَيرَةِ الضَّلالَةِ»، ولكن لم يستجيبوا له وقالوا له: (لا نفقه ما تقول يا بن فاطمة)، بل وأجابوه بالسيوف؛ ورشقوه بالرماح، والنبال، والحجارة؛ وسحقوا جسده ورضوا صدره الشريف وكسر أضلاعه (صلوات وسلامه الله عليه).
- رفض عبادة الأصنام والنجاة: رفض النبي هود (عليه السلام) عبادة الأصنام و﴿قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ (هود: 54)، أجاب النبي هود (عليه السلام) عن قولهم بإظهار البراءة من شركائهم من دون الله(652)، مشير بذلك إلىٰ أنَّ الأصنام إِذا كانت لها القدرة فاطلبوا منها هلاكي وموتي لمحاربتي لها علناً فعلام تسكت هذه الأصنام؟ وماذا تنتظر بي؟(653)، ﴿وَلمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (هود: 58) المراد بمجيء الأمر نزول العذاب وبوجه أدق صدور الأمر الإلهي الذي يستتبع القضاء الفاصل بين الرسول وبين قومه، وقوله: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ الظاهر أنَّ المراد بها الرحمة الخاصة بالمؤمنين المستوجبة نصرهم في دينهم وإنجاءهم من شمول الغضب الإلهي وعذاب الاستئصال(654)، وفي قوله تعالىٰ: ﴿نجّينا﴾ وتكرار هذه الكلمة في الآية مرّتين أقوال مختلفة للمفسّرين، فـ﴿نَجَّيْنَا﴾ الأولىٰ تعني خلاصهم من عذاب الدنيا و﴿نَجَّيْنَا﴾ الثانية تعني نجاتهم في المرحلة المقبلة من عذاب الآخرة، وينسجم هذا التعبير مع وصف العذاب بالغلظة أيضاً(655)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) رافض لعبادة الأصنام الحجرية والبشرية وبمقتله نجىٰ الدين، ونجىٰ محبيه ومواليه من عذاب الدنيا والآخرة.
- الصبر: قوله تعالىٰ: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنبياء: 85)، فكلّ واحد من هؤلاء صبر طوال عمره أمام الأعداء، أو أمام مشاكل الحياة المجهدة المضنية، ولم يركع أبداً في مقابل هذه الحوادث، وكان كلّ منهم مثلا أعلىٰ في الصبر والاستقامة(656)، وقوله تعالىٰ عن النبي أيوب (عليه السلام): ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ (ص: 44)، أي فيما ابتليناه به من المرض وذهاب الأهل والمال(657)، والنبي زكريا (عليه السلام) كما جاء في الزبارة الناحية: «السَّلامُ عَلىٰ زَكَريَّا الصَّابِر فِي مِحْنَتِهِ»، وورد في زيارته أيضاً: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ إِسْماعيلَ ذَبيحِ اللهِ»، فقد ذبح الإمام الحسين (عليه السلام) وكان صابراً إلَّا أنَّ صبره قد فاق الحدود حتَّىٰ جاء في زيارة الناحية: «وَأنْتَ مُقْدَّمٌ في الهَبَوَاتِ، ومُحْتَمِلٌ للأذِيَّاتِ، قَدْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِكَ مَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ، فَأحْدَقُوا بِكَ مِنْ كِلِّ الجِّهَاتِ، وأثْخَنُوكَ بِالجِّرَاحِ، وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَينَ الرَّوَاحِ، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ نَاصِرٌ، وَأنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ»، وقال (عليه السلام) في دعائه: «صَبراً علىٰ قضائِكَ يا ربِّ، لا إلهَ سِواكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ، ما لي ربٌّ سِواكَ ولا معبودٌ غيرُكَ، صبراً علىٰ حُكْمِك، يا غِياثَ من لا غِيَاثَ له»(658).
- الحكمة وفصل الخطاب: قوله تعالىٰ: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (ص: 20) ﴿الْحِكْمَةَ﴾ هنا تعني العلم والمعرفة وحسن تدبير أُمور البلاد، أو مقام النبوّة، أو جميعها، وقد تكون أحياناً ذات جانب علمي ويعبّر عنها بالمعارف العالية، وأُخرىٰ لها جانب عملي ويعبّر عنها بالأخلاق والعمل الصالح وقد استخدمت عبارة ﴿فَصْلَ الْخِطَابِ﴾ لأنَّ كلمة ﴿الْخِطَابِ﴾ تعني أقوال طرفي النزاع، أمّا ﴿فَصْلَ﴾ فإنَّها تعني القطع والفصل(659)، وهو يعني تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقّه من باطله وينطبق علىٰ القضاء بين المتخاصمين في خصامه(660)، فقد قال الإمام الرضا (عليه السلام): «يَا أَبَا الصَّلْتِ… أَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): وَأُوتِينَا فَصْلَ الْخِطَابِ فَهَلْ فَصْلُ الْخِطَابِ إِلَّا مَعْرِفَةُ اللُّغَاتِ»(661)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورث النبي داوّد (عليه السلام) فقد روي عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، قَالَ: «يَا يُونُسُ، إِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِيحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّا وَرِثْنَاهُ، وَأُوتِينَا شَرْحَ الْحِكْمَةِ، وَفَصْلَ الْخِطَابِ», فَقُلْتُ: يَا بْنَ رَسُولِ الله، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَرِثَ كَمَا وَرِثْتُمْ مِنْ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)؟ فَقَالَ: «مَا وَرِثَهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ الْاِثْنَا عَشَرَ»(662)، وقد ورد في زيارة الأول من رجب الأصب: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بابَ حِكْمَةِ رَبِّ الْعالَمينَ».
- المجتبون: وقال (عزَّ وجلَّ): ﴿اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (الشورىٰ: 13)، الاجتباء هو الجمع والاجتلاب، والمعنىٰ الله يجمع ويجتلب إلىٰ دين التوحيد(663)، وقوله تعالىٰ عن نبيه يونس (عليه السلام): ﴿فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (القلم: 50)، والاجتباء الجمع علىٰ طريق الاصطفاء واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يقارنهم من الصديقين والشهداء(664)، وقوله تعالىٰ عن أنبيائه: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلّاً فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إلىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الأنعام: 85-87)، قوله تعالىٰ: ﴿كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ (يوسف: 6)، الاجتباء من الجباية ففي معنىٰ الاجتباء جمع أجزاء الشيء وحفظها من التفرق والتشتت، وفيه سلوك وحركة من الجابي نحو المجبي فاجتباه الله سبحانه عبداً من عباده هو أن يقصده برحمته ويخصه بمزيد كرامته فيجمع شمله ويحفظه من التفرق في السبل المتفرقة الشيطانية المفرقة للإنسان ويركبه صراطه المستقيم وهو أن يتولىٰ أمره ويخصه بنفسه فلا يكون لغيره فيه نصيب كما أخبر تعالىٰ بذلك في يوسف (عليه السلام) إذ قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا المُخْلَصِينَ﴾ (665)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام)، فَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ المُجْتَبَوْنَ»(666).
- علم التأويل: قوله تعالىٰ: ﴿يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ (يوسف: 6)، وهو ما يؤول إليه الحوادث المصورة في نوم أو يقظة ويتم نعمته هذه، والتأويل هو ما ينتهي إليه الرؤيا من الأمر الذي تتعقبه، وهو الحقيقة التي تتمثل لصاحب الرؤيا في رؤياه بصورة من الصور المناسبة لمداركه ومشاعره(667)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فَعَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: «نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ»(668)، وقَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ (عليه السلام): «نَحْنُ النِّعْمَةُ الَّتِي أَنْعَمَ الله بِهَا عَلَىٰ عِبَادِهِ، وَبِنَا يَفُوزُ مَنْ فَازَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(669).
- الحسد: قوله تعالىٰ: ﴿يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النساء: 54)، والمراد بـ﴿النَّاسَ﴾ علىٰ ما يدل عليه هذا السياق هم الذين آمنوا، وبـ﴿مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ﴾ هو النبوة والكتاب والمعارف الدينية(670)، فقد ورد أنَّ الأنبياء حُسِدوا، فقد جاء عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): «كَانَ يُوسُفُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً، وَكَانَ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ وَيُؤْثِرُهُ عَلَىٰ أَوْلاَدِهِ، فَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ»(671)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) حسدوه فقتلوه، وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «نَحنُ وَالله النَّاسُ المَحْسُودُون(672)، عَلَىٰ مَا آتَانَا الله مِنَ الْإِمَامَةِ دُونَ خَلْقِ الله أَجْمَعِينَ»(673).
- الرجعة: جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله تعالىٰ: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيّاً﴾ (مريم: 54) قَالَ: «ذَاكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِزْقِيلَ النَّبِيُّ بَعَثَهُ الله إلىٰ قَوْمِهِ، فَكَذَّبُوهُ وَقَتَلُوهُ وَسَلَخُوا وَجْهَهُ، فَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ سَطَاطَائِيلَ مَلَكَ الْعَذَابِ، فَقَالَ لَهُ: يَا إِسْمَاعِيلُ: أَنَا سَطَاطَائِيلُ مَلَكُ الْعَذَابِ، وَجَّهَنِي إِلَيْكَ رَبُّ الْعِزَّةِ لِأُعَذِّبَ قَوْمَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ إِنْ شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ يَا سَطَاطَائِيلُ؛ فَأَوْحَىٰ الله إِلَيْهِ: فَمَا حَاجَتُكَ يَا إِسْمَاعِيلُ؟ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ أَخَذْتَ الْمِيثَاقَ لِنَفْسِكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَلِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ، وَلِوَصِيِّهِ بِالْوَلاَيَةِ، وَأَخْبَرْتَ خَيْرَ خَلْقِكَ بِمَا تَفْعَلُ أُمَّتُهُ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) بَعْدَ نَبِيِّهَا، وَإِنَّكَ وَعَدْتَ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) أَنَّ تَكُرَّهُ إلىٰ الدُّنْيَا، حتَّىٰ يَنْتَقِمَ بِنَفْسِهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ، فَحَاجَتِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ أَنْ تَكُرَّنِي إلىٰ الدُّنْيَا، حتَّىٰ أَنْتَقِمَ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِي كَمَا تَكُرُّ الْحُسَيْنَ (عليه السلام). فَوَعَدَ الله إِسْمَاعِيلَ بْنَ حِزْقِيلَ ذَلِكَ، فَهُوَ يَكُرُّ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا)»(674).
- السير بالأهل: امتثل النبي لوط (عليه السلام) قوله تعالىٰ: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ (هود: 81)، الإسراء هو السير بالليل، المعنىٰ: وإذ جئناك بعذاب غير مردود وأمر من الله ماض يجب عليك أن تسير بأهلك ليلا وتأخذ أنت وراءهم لئلا يتخلفوا عن السير ولا يساهلوا فيه ولا يلتفت أحد منكم إلىٰ ورائه وامضوا حيث تؤمرون، وفيه دلالة علىٰ أنه كانت أمامهم هداية إلهية تهديهم وقائد يقودهم(675)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) امتثل أمر ربه وسار بأهله فلما سئل عن ذلك قالَ: «شاءَ اللهَ أن يراهنَّ سبايا»(676).
- السلام: قوله تعالىٰ: ﴿وَسَلَامٌ عَلَىٰ المُرْسَلِينَ﴾ (الصافات: 181) تسليم علىٰ عامة المرسلين وصون لهم من أن يصيبهم من قبله تعالىٰ ما يسوؤهم ويكرهونه(677)، السلام الذي يوضّح السلامة والعافية من كلّ أنواع العذاب والعقاب في يوم القيامة، السلام الذي هو صمّام الأمان أمام الهزائم ودليل للانتصار علىٰ الأعداء(678)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد ورد عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلم) اسْمُهُ يَاسِينُ، وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ الله: ﴿سَلامٌ عَلىٰ إِلْياسِينَ﴾ [الصافات: 130]»(679)، وعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ) قَالَ: «يَس مُحَمَّدٌ، وَنَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ»(680).
- الإجابة: بقوله تعالىٰ في النبي يوسف (عليه السلام) ﴿فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَـرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (يوسف: 34)، والنبي زكريا (عليه السلام) ﴿فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيىٰ وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ﴾ (الأنبياء: 90)، والمخلصين ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: 60)، والمضطرين ﴿أمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ (النمل: 62)، والداعين ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (سورة البقرة: 186)، والنبي يونس (عليه السلام) ﴿فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء: 88)، وعد بالإنجاء لمن ابتلي من المؤمنين بغم ثم نادىٰ ربَّه(681)، والنبي أيوب (عليه السلام) ﴿فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرىٰ لِلْعابِدِينَ﴾ (الأنبياء: 84)، ليعلم المسلمون أنَّ المشاكل كلّما زادت، وكلّما زادت الابتلاءات، وكلّما زاد الأعداء من ضغوطهم وضاعفوا قواهم، فإنَّها جميعاً ترفع وتحلّ بنظرة ومنحة من لطف الله، فلا تجبر الخسارة وحسب، بل إنَّ الله سبحانه يعطي الصابرين أكثر ممّا فقدوا جزاءً لصبرهم وثباتهم، وهذا درس وعبرة لكلّ المسلمين(682)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) استجاب الله له دعائه وقد مرَّ بيانه.
- الذرية الطيبة: دَعَا النَبِي زَكَرِيَّا (عليه السلام) رَبَّهُ (عزَّ وجلَّ)، فَقَالَ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ﴾ (آل عمران: 38) – طيب الشيء ملائمته لصاحبه فيما يريده لأجله(683) -، ﴿فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ بقوله: ﴿أَنَّ الله يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران: 39) كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) رزقه الله تسعة أئمة حق طيبين من ذريته، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إنَّ الله عوَّض الحسين (عليه السلام) من قتله أن جعل الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره»(684).
- علم الكتاب: قوله تعالىٰ: ﴿عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ﴾ (النمل: 40) أي علم لا يحتمل اللفظ وصفه والمراد بالكتاب الذي هو مبدأ هذا العلم العجيب إمّا جنس الكتب السماوية أو اللوح المحفوظ، والعلم الذي أخذه هذا العالم منه كان علماً يسهل له الوصول إلىٰ هذه البغية(685)، وَرَدَ عَنْ أَميرِ المُؤمِنينَ (عليه السلام) أَنَهُ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ عِنْدَ وَصِيِّ سُلَيْمَانَ مِنِ اسْمِ الله الْأَعْظَمِ حَرْفٌ وَاحِدٌ، فَسَأَلَ الله جَلَّ اسْمُهُ، فَخُسِفَ لَهُ الْأَرْضُ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ سَرِيرِ بِلْقِيسَ، فَتَنَاوَلَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ طَرْفِ الْعَيْنِ، وَعِنْدَنَا مِنِ اسْمِ الله الْأَعْظَمِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَرْفاً، وَحَرْفٌ عِنْدَ الله تَعَالَىٰ، اسْتَأْثَرَ بِهِ دُونَ خَلْقِهِ»(686)، والإمام الحسين (عليه السلام) عنده علم الكتاب كله فقد قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام): «عِنْدَنَا وَالله عِلْمُ الْكِتَابِ كُلُّهُ»(687).
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قوله تعالىٰ عن لسان لقمان الحكيم (عليه السلام): ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ﴾ (لقمان: 17)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) لما ورد في زيارته: «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَآتَيْتَ الزَّكاةَ وَأَمَرْتَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ».
- الكهف: قوله تعالىٰ: ﴿فَأْوُوا إلىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً﴾ (الكهف: 16)، ﴿يُهَيِّئْ﴾ مُشتقة مِن تهيئة بمعنىٰ الإِعداد، ﴿مِرْفَقاً﴾ تعني الوسيلة التي تكون سبباً للطف والرفق والراحة، وبذا يكون معنىٰ الجملة ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً﴾ أنَّ الخالق سبحانهُ وتعالىٰ سيرتب لكم وسيلة للرفق والراحة، من الألطاف المعنوية لله تبارك وتعالىٰ، والجوانب المادية التي تؤدي إلىٰ خلاصهم ونجاتهم(688)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام)، قال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ كَهْفُكُمْ كَكَهْفِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ»(689).
- الاصطفاء: قَوْلُهُ فِي طَالُوتَ: ﴿إِنَّ الله اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: 247)، الاصطفاء والاستصفاء الاختيار وأصله الصفو، والبسطة هي السعة والقدرة(690)، كذلك الإمام الحسين (عليه السلام) فقد جاء عن علي بن إبراهيم في قوله تعالىٰ: ﴿وَسَلامٌ عَلىٰ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفىٰ﴾ (النمل: 59) قال: هُمْ آلُ مُحَمَدّ (عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)(691)، وقال ولده أَبُو الْحَسَنِ الإمَامُ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): «نَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا الله»(692)، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «نَحْنُ صَفْوَةُ الله»(693)، وجاء في زيارة الأربعين: «السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ الله وَابْنِ صَفِيِّهِ»، وورد في الزيارة الجامعة: «اَلسَّلامُ عَلىٰ أَوْلِياءَ اللهِ وَأَصْفِيائِهِ».
الهوامش:
(1) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص326.
(2) الكافي: ج1، ص293؛ بصائر الدرجات: ص469.
(3) بصائر الدرجات: ص119؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج2، ص14-15.
(4) بصائر الدرجات: ص208-209.
(5) ليست رواية واحدة فقط بل جمعتها من مجموع الروايات، إليك بعضها، الكافي: ج1، ص235؛ بصائر الدرجات: ص177.
(6) بحار الأنوار: ج25، ص169؛ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (عليه السلام): ج1، ص177.
(7) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج12، ص38.
(8) بحار الأنوار: ج43، ص294.
(9) تفسير القمي: ج1، ص354.
(10) تفسير القمي: ج2، ص105.
(11) شمس الدين: https://maarefhekmiya.org/10405/wareth/
(12)الطائي وإبراهيم, 2023: ص52, زيارة وارث دراسة في السند والدلالة.
(13) شمس الدين: https://maarefhekmiya.org/10405/wareth/
(14) الطائي وإبراهيم, 2023: ص52, زيارة وارث دراسة في السند والدلالة.
(15) الحسين وارث الأنبياء، محمد مهدي الآصفي.
(16) الطائي وإبراهيم, 2023: ص51, زيارة وارث دراسة في السند والدلالة.
(17) الحسين (عليه السلام) وارث الأنبياء إضاءات جديدة، السيد سامي البدري: ص3-4.
(18) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص11-17.
(19) الميزان في القرآن: ج1، ص300.
(20) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص165.
(21) تفسير القمي: ج2، ص129.
(22) الكافي: ج1، ص226.
(23) الأمالي: ص654.
(24) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص155.
(25) كامل الزيارات: ص235.
(26) الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص116.
(27) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ص217.
(28) الخصال: 305؛ معاني الأخبار: ج1، ص125: المناقب: لابن المغازلي، ج1، ص105.
(29) الملهوف: ص72 – 74.
(30) كامل الزيارات: ص415.
(31) مقاتلِ الطالبيّينَ: ص59؛ المناقبِ: ج3، ص257؛ الملهوف: ص69؛ وغيرِهم.
(32) الميزان في تفسير القرآن: ج7، ص246.
(33) الكافي: ج1، ص191.
(34) لسان العرب 15: 394 – وصي – أدب الحوزة – قم.
(35) الجوهري، مقتضب الأثر في النص علىٰ الأئمة الاثني عشر: ص40.
(36) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص20.
(37) بحار الأنوار: ج25، ص356.
(38) لسان العرب ابن منظور: ج14، ص84.
(39) الطريق إلىٰ منبر الحسين لنيل سعادة الدارين: ج3.
(40) ثمرات الأعواد: ج1، ص43.
(41) كامل الزيارات: ص252؛ التهذيب: ج6، ص76؛ ثواب الأعمال: ص89.
(42) الكافي: ج8، ص114.
(43) الأمالي: ص226.
(44) طهارة آل محمد (عليهم السلام) – السيد علي عاشور: ص159.
(45) الدمعة الساكبة: ج4، ص351؛ معالي السبطين: ج2، ص22؛ ذريعة النجاة: ص139.
(46) كامل الزيارات: ص538.
(47) الاختصاص: ص269؛ الكافي: ج1، ص231؛ بصائر الدرجات: ص183.
(48) بصائر الدرجات: ص208.
(49) المنتخب: ص48؛ العوالم: ج17، ص101.
(50) بحار الأنوار: ج44، ص242.
(51) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص223.
(52) بحار الأنوار: ج91، ص184.
(53) بحار الأنوار: ج23، ص12؛ ميزان الحكمة: ج4، ص2820.
(54) بحار الأنوار: ج26، ص322.
(55) الكافي: ج1، ص145؛ بصائر الدرجات: ص61.
(56) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص471.
(57) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص340 و432.
(58) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(59) الأمالي: ص558؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(60) الميزان في تفسير القرآن: ج20: ص29.
(61) بحار الأنوار: ج45، ص12.
(62) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج19، ص50.
(63) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص102-103.
(64) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص406.
(65) الملهوف: ص59.
(66) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص297.
(67) بحار الأنوار: ج45، ص316.
(68) الإرشاد: ج2، ص76.
(69) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص202.
(70) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص202.
(71) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص510.
(72) الملهوف: ص18.
(73) الميزان في تفسير القرآن ج19، ص213.
(74) بحار الأنوار: ج11، ص326.
(75) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17، ص308.
(76) بحار الأنوار: ج45، ص91.
(77) كتاب الغيبة: ج1، ص294.
(78) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص244.
(79) العوالم: ص360.
(80) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج5، ص88.
(81) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص. 175
(82) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص211
(83) الميزان في تفسير القرآن: ج17: ص145.
(84) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج19، ص68.
(85) الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص34.
(86) الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص37.
(87) بحار الأنوار: ج45، ص10.
(88) بحار الأنوار: ج45، ص43.
(89) بحار الأنوار: ج45، 36.
(90) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص68.
(91) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17، ص309.
(92) الكافي: ج8، ص255؛ كامل الزيارات: ص135.
(93) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص212.
(94) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج11، ص416.
(95) كامل الزيارات: ص157.
(96) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص298.
(97) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص146.
(98) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص329.
(99) كامل الزيارات: ص275.
(100) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص341.
(101) بحار الأنوار: ج98، ص69.
(102) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج8، ص299.
(103) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص368.
(104) علل الشرائع: ج1 ص29.
(105) بحار الأنوار: ج87، ص76.
(106) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص22.
(107) بحار الأنوار: ج44، ص243.
(108) الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص278.
(109) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص153.
(110) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص368.
(111) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(112) الأمالي: ص558؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(113) الخصال: ص308.
(114) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص21.
(115) تفسير القمي: ج2، ص129.
(116) الكافي: ج1، ص226.
(117) الأمالي: ص654.
(118) الكافي: ج1، ص225.
(119) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج20، ص140.
(120) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص45
(121) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص146.
(122) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص463.
(123) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص146.
(124) الكافي: ج1، ص145؛ بصائر الدرجات: ص61.
(125) تفسير القرطبي: ج11، ص.297
(126) تفسير البغوي – إحياء التراث: ج3، ص292.
(127) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص298.
(128) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص24.
(129) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص220.
(130) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص367.
(131) بصائر الدرجات: ص164؛ إثبات الهداة: ج4، ص60.
(132) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص473.
(133) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص298.
(134) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص67.
(135) بحار الأنوار: ج23، ص224.
(136) تفسير العيّاشي: ج1، ص.367
(137) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص77.
(138) بحار الأنوار: ج27، ص74.
(139) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص369.
(140) تفسير القمي: ج2، ص83.
(141) كامل الزيارات: ص157.
(142) كامل الزيارات: ص243.
(143) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص152.
(144) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص367.
(145) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص153.
(146) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج2, ص268.
(147) بحار الأنوار: ج45، ص46.
(148) معاني الأخبار: ص126.
(149) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص20.
(150) الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص270.
(151) الكافي: ج2، ص466؛ وسائل الشيعة: ج7، ص25؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج12، ص3.
(152) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص226.
(153) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج4، ص368.
(154) الجديد في الحسين (عليه السلام) – الكوراني: ص161؛ العوالم: ص350.
(155) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص226.
(156) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص376.
(157) تفسير العيّاشي، ج1، ص195.
(158) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص376.
(159) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص368.
(160) بحار الأنوار: ج87، ص76.
(161) الكافي: ج1، ص191.
(162) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7، ص523.
(163) علل الشرائع: ج1، ص35.
(164) مناقب آل أبي طالب: ج4، ص66.
(165) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص59.
(166) بحار الأنوار: ج45، ص316.
(167) الإرشاد: ج2، ص76.
(168) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص180.
(169) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17، ص98.
(170) حياة الإمام الحسين (عليه السلام) – الشيخ باقر شريف القرشي: ج1، ص127.
(171) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص151.
(172) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص362.
(173) معاني الأخبار: ص391.
(174) تفسير العيّاشي: ج2، ص152.
(175) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(176) الكافي: ج1، ص465.
(177) تفسير القمي: ج1، ص354.
(178) علل الشرائع: ج1، ص34.
(179) بحار الأنوار: ج96، ص37.
(180) مقتل الحسين (عليه السلام) للسيد المقرّم: ص276.
(181) بحار الأنوار: ج44، ص243.
(182) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص244.
(183) تذكرة الخواص: ص144؛ مقتل الحسين (عليه السلام) للسيد المقرّم: ص273.
(184) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج2، ص452.
(185) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص243.
(186) تفسير القمي: ج2، ص129.
(187) الكافي: ج1، ص226.
(188) الأمالي: ص654.
(189) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص151.
(190) تفسير القمي: ج2، ص135.
(191) الكافي: ج1، ص145؛ بصائر الدرجات: ص61.
(192) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص153.
(193) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص556.
(194) شرح نهج البلاغة: ج15. ص194.
(195) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص385.
(196) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(197) الأمالي: ص558؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(198) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص347.
(199) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص12.
(200) مجمع الزوائد: ج9، ص168.
(201) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص471.
(202) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص446 و548.
(203) بحار الأنوار: ج13، ص11.
(204) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص21.
(205) بحار الأنوار: ج44، ص187.
(206) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص12.
(207) تذكرة الخواص: ص284؛ ينابيع المودة: ص320 و356؛ الصواعق المحرقة: ص116 و192.
(208) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص12، ص540.
(209) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص143.
(210) الكافي: ج1، ص231.
(211) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص245.
(212) تفسير القمي: ج1، ص239.
(213) الكافي: ج1، ص225.
(214) الكافي: ج1، ص231.
(215) بحار الأنوار: ج24، ص303.
(216) البرهان في تفسير القرآن: ج3، ص47، نقلاً عن المناقب: ص252، ح301.
(217) الميزان في تفسير القرآن: ج13، ص218.
(218) الملهوف: ص40.
(219) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص419.
(220) كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص150.
(221) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص25.
(222) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج12، ص210.
(223) كامل الزيارات: ص252؛ التهذيب: ج6، ص76؛ ثواب الأعمال: ص89.
(224) الإرشاد: ج2، ص34.
(225) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص277.
(226) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج11، ص384.
(227) كامل الزيارات: ص134.
(228) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج12، ص169.
(229) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص7.
(230) بحار الأنوار: ج45، ص143.
(231) الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص294.
(232) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7، ص261.
(233) الإرشاد: ج1، ص290.
(234) الكافي: ج4، ص170؛ علل الشرائع: ج2، ص389.
(235) الغيبة للنعماني: ص143.
(236) كامل الزيارات: ج1، ص62؛ الكافي: ج8، ص206.
(237) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص249.
(238) بحار الأنوار: ج45، ص91.
(239) تفسير العيّاشي: ج1، ص49.
(240) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص26.
(241) الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص199.
(242) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص13.
(243) مثير الأحزان: ص41؛ الملهوف: ص26؛ كشف الغمة: ج2، ص29؛ العوالم: ص17، ص217.
(244) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص117.
(245) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص26.
(246) بحار الأنوار: ج44، ص244.
(247) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص547.
(248) بحار الأنوار: ج25، ص22.
(249) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص121.
(250) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص193.
(251) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(252) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج4، ص184.
(253) شذرات من فلسفة تاريخ الحسين (عليه السلام).
(254) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص47.
(255) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ص371.
(256) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص15.
(257) بصائر الدرجات: ص467؛ الكافي: ج1، ص272.
(258) بحار الأنوار: ج25، ص134.
(259) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص47.
(260) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص439.
(261) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص175.
(262) الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص133.
(263) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص522.
(264) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج6، ص373.
(265) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص214.
(266) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص314.
(267) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص28.
(268) تفسير العيّاشي: ج1، ص350.
(269) مثير الأحزان: ص41؛ الملهوف: ص26؛ كشف الغمة: ج2، ص29؛ العوالم: ص17، ص217.
(270) الكافي: ج8، ص364.
(271) العوالم: ص25.
(272) الكافي: ج1، ص465.
(273) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص28.
(274) نهج البلاغة: ج2، في عظمة الله وحمده وذكر الأنبياء ص58.
(275) نهج البلاغة: ج2، في عظمة الله وحمده وذكر الأنبياء: ص58.
(276) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257.
(277) بحار الأنوار: ج44، ص244.
(278) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص331.
(279) الطبقات الكبرىٰ: ج1، ص192.
(280) الأمالي: ص654.
(281) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص88.
(282) الأمالي: ص455.
(283) بحار الأنوار: ج23، ص295.
(284) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص369.
(285) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج18، ص301.
(286) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص241.
(287) علل الشرائع: ج1، ص205.
(288) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص341.
(289) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص338.
(290) كامل الزيارات: ص235.
(291) مصباح الزائر: ص254.
(292) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص27.
(293) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص341.
(294) بصائر الدرجات: ص369.
(295) بصائر الدرجات: ص403؛ الكافي: ج1، ص266.
(296) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص210.
(297) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج18، ص181.
(298) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص330.
(299) الكافي: ج1، ص425.
(300) الميزان في تفسير القرآن: ج11، ص277.
(301) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص408.
(302) الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص53.
(303) الإرشاد: ج2، ص34.
(304) بحار الأنوار: ج44، ص367.
(305) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص199.
(306) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج14، ص54.
(307) الملهوف: ص18.
(308) بحار الأنوار: ج45، ص7.
(309) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص195.
(310) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص339.
(311) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص518.
(312) الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص252.
(313) الأمالي: ص177.
(314) كامل الزيارات: ص157.
(315) الملهوف: ص38.
(316) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص68.
(317) تفسير القمي: ج2، ص88.
(318) الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص53.
(319) مختار الخرائج والجرائح: ص204.
(320) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج8، ص371.
(321) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص53.
(322) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص121.
(323) تفسير القمي: ج2، ص410.
(324) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص352.
(325) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص417.
(326) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص6.
(327) الكافي: ج1، ص190.
(328) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص408.
(329) تفسير القمي: ج2، ص445.
(330) بحار الأنوار: ج98، ص69.
(331) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج20، ص499-501.
(332) ميزان الحكمة: ج4، ص3227.
(333) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص345.
(334) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص278.
(335) العوالم: ص233.
(336) الكافي: ج8، ص245.
(337) بحار الأنوار: ج71، ص220.
(338) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج11، ص475.
(339) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص329.
(340) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص227.
(341) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): ص.330
(342) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص517.
(343) الكافي: ج1، ص131.
(344) بحار الأنوار: ج93، ص84.
(345) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص277.
(346) عيون أخبار الرضا: ج1، ص.216
(347) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج8، ص95.
(348) شواهد التنزيل: ج1، ص446.
(349) بصائر الدرجات: ص86.
(350) تفسير القمي: ج2، ص332.
(351) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص441.
(352) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص364.
(353) الكافي: ج1، ص210.
(354) تفسير القمي: ج2، ص147.
(355) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص402.
(356) مناقب آل أبي طالب: ج2، ص288.
(357) الكافي: ج1، ص213.
(358) تفسير العياشي: ج1، ص260-261.
(359) مقتل الحسين (عليه السلام) للمقرم: ج1، ص283.
(360) تفسير القمي: ج1، ص304.
(361) بحار الأنوار: ج36، ص228.
(362) الإرشاد: ج2. ص84.
(363) الكافي: ج1: ص236؛ بصائر الدرجات: ص206.
(364) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج12، ص145.
(365) الخصال: ص77.
(366) نظم درر السمطين: ص271،
(367) الإرشاد: ج2، ص127.
(368) كنز العمال: ج13، ص659؛ المعجم الكبير: ج3، ص95.
(369) بحار الأنوار: ج43، ص294.
(370) الملهوف: ص53.
(371) بحار الأنوار: ج26، ص335.
(372) كامل الزيارات: ص70.
(373) الإرشاد: ج2، ص96.
(374) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج19، ص116.
(375) الملهوف: ص170-171.
(376) شجرة طوبىٰ: ج2، ص451.
(377) بحار الأنوار: ج16، ص231.
(378) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص222؛ العوالم: ص63.
(379) بحار الأنوار: ج22، ص157.
(380) مقتل الحسين (عليه السلام): ص283.
(381) الملهوف: ص62.
(382) الكافي: ج1، ص465.
(383) بحار الأنوار: ج45، ص316.
(384) موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في الكتاب والسُّنَّة والتّاريخ: ج4، ص433.
(385) بحار الأنوار: ج98، ص69.
(386) بصائر الدرجات ص81؛ الكافي: ج1، ص145.
(387) تفسير العياشي: ج1، ص252.
(388) تفسير القمّيّ: ج2، ص66.
(389) الكافي: ج1، ص186.
(390) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص391.
(391) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص241.
(392) علل الشرائع: ج1، ص205.
(393) عليّ المرتضىٰ نقطة باء البسملة: 1، ص76،
(394) شرح إحقاق الحق: ج22، ص98؛ شواهد التنزيل: ج1، ص476.
(395) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص113.
(396) الكافي: ج8، ص204.
(397) الأمالي: ص562.
(398) بحار الأنوار: ج23، ص20.
(399) الأمالي: ص654.
(400) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص231.
(401) البدري: زيارة وارث تؤسس المقارنة بين الحسين (عليه السلام) والأنبياء (عليهم السلام): ص27.
(402) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص376.
(403) بحار الأنوار: ج24، ص153.
(404) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص437.
(405) مناقب آل أبي طالب: ج2، ص273.
(406) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج16، ص211.
(407) تفسير القمي: ج1، ص168.
(408) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص35.
(409) تفسير فرات الكوفي: ص500.
(410) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص394.
(411) الفضائل: ص175.
(412) الميزان في تفسير القرآن: ج6، ص33.
(413) التوحيد: ص164.
(414) الكافي: ج1، ص143.
(415) التوحيد: ص164.
(416) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص555.
(417) لكافي: ج1، ص145.
(418) تفسير القمي: ج2، ص252.
(419) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص282.
(420) بصائر الدرجات: ص83.
(421) تفسير فرات الكوفي: ص465؛ تفسير القمي: ج2، ص348.
(422) تفسير فرات الكوفي: ص417.
(423) الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص232.
(424) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص531.
(425) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص468.
(426) تفسير فرات الكوفي: ص463.
(427) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص.471
(428) الأمالي: ص654.
(429) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج19، ص258.
(430) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص664.
(431) الميزان في تفسير القرآن: ج6، ص33.
(432) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص390.
(433) تفسير فرات الكوفي: ص71.
(434) كشف الغمة: ج1، ص177.
(435) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص400.
(436) تفسير القمي: ج1، ص71.
(437) الوثائق الرسميّة لثورة الإمام الحسين (عليه السلام): ص236.
(438) التوحيد: ص164.
(439) تفسير العياشي: ج1، ص194.
(440) تفسير العياشي: ج1، ص196.
(441) الأمالي: ص654.
(442) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص622.
(443) بصائر الدرجات: ص82.
(444) الفضائل: ج94.
(445) بحار الأنوار: ج40، ص176.
(446) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص395.
(447) بحار الأنوار: ج40، 203.
(448) تفسير العياشي: ج2، ص221.
(449) بحار الأنوار: ج36، ص177.
(450) الميزان في تفسير القرآن: ج13، ص240.
(451) بحار الأنوار: ج24، ص163.
(452) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص63.
(453) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج12، ص275.
(454) شواهد التنزيل: ج2، ص332.
(455) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص206.
(456) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص359.
(457) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص126.
(458) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص384.
(459) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص357.
(460) مناقب آل أبي طالب: ج1، ص374.
(461) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص205.
(462) تفسير القمي: ج2، ص377.
(463) الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص339.
(464) الأمالي: ص364.
(465) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج1، ص51.
(466) بحار الأنوار: ج29، ص428.
(467) موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام): ص109.
(468) الكافي: ج1، ص415.
(469) الكافي: ج1، ص213.
(470) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص121.
(471) الكافي: ج1، ص184.
(472) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص155.
(473) الأمالي: ص450.
(474) الكافي: ج1، ص193.
(475) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص365.
(476) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص396.
(477) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص329.
(478) مناقب آل أبي طالب: ج2، ص120.
(479) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص67.
(480) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص720.
(481) بحار الأنوار: ج87، ص76.
(482) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص39.
(483) مناقب آل أبي طالب: ج2، ص120.
(484) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج1، ص531.
(485) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص71.
(486) تفسير القمي: ج2، ص246.
(487) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج15، ص33.
(488) تفسير العياشي: ج1، ص260-261.
(489) مجمع البيان في تفسير القرآن: ج8، ص639.
(490) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص46.
(491) بحار الأنوار: ج35، ص371.
(492) الأمالي: ص654.
(493) تفسير العياشي: ج1، ص284.
(494) مناقب آل أبي طالب: ج4، ص2.
(495) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج1، ص224.
(496) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج1، ص251.
(497) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص190.
(498) مشارق أنوار اليقين: ص260.
(499) كذلك، القراءات، اليساري، ح350؛ موسوعة أهل البيت (عليهم السلام) القرآنية: كتاب قراءة أهل البيت (عليهم السلام): مجلد10، ص165.
(500) الاختصاص: ص329.
(501) التوحيد: ص164.
(502) مجمع الزوائد: ج9، ص168.
(503) الكافي: ج1، ص223.
(504) الغدير: العلامة الأميني، ج2، ص313.
(505) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج3، ص60.
(506) الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام): ج22، ص286.
(507) كلمات الإمام الحسين (عليه السلام) الشيخ الشريفي: ص392.
(508) جامع أحاديث الشيعة: ج16، ص696.
(509) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج18، ص224.
(510) نهج البلاغة، خطب الإمام علي (عليه السلام): ج1، ص37؛ عفطة العنز ما تنثره من أنفها كالعفطة، عفطت تعفط من باب ضرب، غير أن أكثر ما يستعمل ذلك في النعجة، والأشهر في العنز النفطة بالنون، يقال ما له عافط ولا نافط أي نعجة ولا عنز، كما يقال ما له ثاغية ولا راغية.
(511) معاني الأخبار: ص361. الخطبة الشقشقية.
(512) مقتل الحسين (عليه السلام) للمقرم: ج1، ص283.
(513) كنز العمال: ج11، ص622.
(514) الكافي: ج1، ص234.
(515) ليست رواية واحدة فقط بل جمعتها من مجموع الروايات، إليك بعضها، الكافي: ج1، ص235؛ بصائر الدرجات: ص177.
(516) التوحيد: ص164.
(517) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج11، ص111.
(518) مصباح الزائر: ص254.
(519) حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) عن لسانه: ج3، ص191.
(520) الملهوف: ص18.
(521) بحار الأنوار: ج38، ص29.
(522) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص18.
(523) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج14، ص268.
(524) تفسير فرات الكوفي: ص237.
(525) الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص45.
(526) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص170.
(527) تفسير القمي: ج2، ص196.
(528) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص315.
(529) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص137.
(530) تأويل الآيات: ج1، 344.
(531) مناقب آل أبي طالب: ج2، ص294.
(532) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج11، ص57.
(533) الكافي: ج1، ص479.
(534) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج16، ص118.
(535) مشارق أنوار اليقين: ص67.
(536) بحار الأنوار: ج43، ص34.
(537) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص54.
(538) كشف الغمة: ج1، ص506.
(539) بحار الأنوار: ج29، ص346.
(540) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص10.
(541) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص277.
(542) الكافي: ج1، ص527.
(543) الخصائص الفاطمية: ج1، ص214
(544) معاني الأخبار: ص396.
(545) الكافي: ج8، ص255؛ كامل الزيارات: ص135.
(546) علل الشرائع: ج1، ص182.
(547) القراءات، اليساري، ح350؛ موسوعة أهل البيت (عليهم السلام) القرآنية: كتاب قراءة أهل البيت (عليهم السلام): مجلد10، ص165.
(548) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص341.
(549) بصائر الدرجات: ص369.
(550) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص.604
(551) محاضرات الخطباء.
(552) موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام): ص579.
(553) الكافي: ج7، ص86.
(554) الخرثىٰ – بالضم: أثاث البيت والمتاع والغنايم.
(555) الكافي: ج7: ص86.
(556) الملهوف: ص53.
(557) مصباح الزائر: ص254.
(558) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص155.
(559) الكافي: ج1، ص193.
(560) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص365.
(561) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص138-140.
(562) كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص222.
(563) تفسير القمّيّ: ج2، ص66.
(564) الكافي: ج1، ص186.
(565) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص391.
(566) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص437.
(567) الأمالي: ص654.
(568) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص20.
(569) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص4.
(570) الميزان في تفسير القرآن: ج7، ص377.
(571) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج4، ص510.
(572) تفسير فرات الكوفي: ص137.
(573) تفسير القمي: ج1، ص221.
(574) الأمالي: ص654.
(575) بصائر الدرجات: ج1، ص45.
(576) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص46.
(577) تفسير فرات الكوفي: ص231.
(578) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص191.
(579) الكافي: ج1، ص215.
(580) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص86.
(581) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص44-45.
(582) الكافي: ج1، ص226.
(583) تفسير العياشي: ج1، ص258.
(584) الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص6.
(585) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج3، ص330.
(586) الكافي: ج1، ص374؛ الاختصاص: ص334.
(587) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص6.
(588) الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص405.
(589) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص407.
(590) الميزان في تفسير القرآن: ج19، ص174.
(591) الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص296؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج20، ص232.
(592) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج11، ص320.
(593) البرهان في تفسير القرآن، وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وغيرها.
(594) مصباح المتهجد: ص401.
(595) مصباح الزائر: ص254.
(596) ليست رواية واحدة فقط بل جمعتها من مجموع الروايات، إليك بعضها، الكافي: ج1، ص235؛ بصائر الدرجات: ص177.
(597) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج3، ص23.
(598) بحار الأنوار: ج43، ص333.
(599) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص604.
(600) موسوعة سيرة أهل البيت (عليهم السلام): ج14، ص262.
(601) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص175.
(602) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(603) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص295.
(604) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص16.
(605) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص274.
(606) الميزان في تفسير القرآن: ج13، ص90.
(607) تفسير العياشي: ج2، ص290.
(608) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص400.
(609) كامل الزيارات: ص313.
(610) كامل الزيارات: ص181.
(611) الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص21.
(612) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(613) الأمالي: ص558؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(614) مصباح الزائر: ص254.
(615) ميزان الحكمة: ج4، ص3175.
(616) موسوعة كربلاء، لبيب بيضون: ج2، ص459.
(617) الإرشاد: ج2، ص132.
(618) الإرشاد: ج2، ص132.
(619) بحار الأنوار: ج27، ص240.
(620) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص285.
(621) مناقب آل أبي طالب: ج3، ص234؛ ترجمة الإمام الحسين (عليه السلام) ابن عساكر: ص352.
(622) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(623) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(624) حكم ومواعظ من حياة الأنبياء (عليهم السلام): ص284.
(625) شجرة طوبىٰ: ج2، ص404.
(626) بصائر الدرجات: ص344.
(627) بصائر الدرجات: ص343.
(628) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص350.
(629) الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص633.
(630) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص405.
(631) الملهوف: ج1، ص129.
(632) الطريق إلىٰ منبر الحسين لنيل سعادة الدارين: ج3.
(633) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص693.
(634) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7، ص50.
(635) بحار الأنوار: ج44، ص329.
(636) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص743.
(637) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص297.
(638) بحار الأنوار: ج45، ص316.
(639) الإرشاد: ج2، ص76.
(640) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج20، ص242.
(641) مقاتل الطالبيين: ص60؛ مناقب آل أبي طالب ج3، ص257.
(642) تفسير القمي: ج2، ص425.
(643) الميزان في تفسير القرآن: ج20، ص299.
(644) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج20، ص243.
(645) بحار الأنوار: ج45، ص10.
(646) بحار الأنوار: ج45، ص43.
(647) بحار الأنوار: ج45، 36.
(648) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج5، ص104.
(649) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج5، ص93.
(650) الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص178.
(651) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج5، ص120.
(652) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص301.
(653) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص567.
(654) الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص304.
(655) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج6، ص571.
(656) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص228.
(657) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص210.
(658) مقتل الحسين (عليه السلام) للمقرم: ج1، ص283.
(659) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14 ص470.
(660) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص190.
(661) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج1، ص251.
(662) كفاية الأثر في النص علىٰ الأئمة الاثني عشر: ص255.
(663) الميزان في تفسير القرآن: ج18، ص31.
(664) الميزان في تفسير القرآن: ج7، ص246.
(665) الميزان في تفسير القرآن: ج11، ص97.
(666) الكافي: ج1، ص191.
(667) الميزان في تفسير القرآن: ج11، 79-83.
(668) الكافي: ج1، ص213.
(669) الكافي: ج1، ص217.
(670) الميزان في تفسير القرآن: ج4، ص376.
(671) تفسير القمي: ج1، ص340.
(672) الكافي: ج1، ص206.
(673) بصائر الدرجات: ص55.
(674) كامل الزيارات: ص138.
(675) الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص183.
(676) الملهوف: ص40.
(677) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص179.
(678) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج14، ص432.
(679) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص489.
(680) الأمالي: ص558؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص315.
(681) الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص179.
(682) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج10، ص225.
(683) الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص175.
(684) بحار الأنوار: ج98، ص69.
(685) الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص363.
(686) خصائص الأئمة (عليهم السلام) (خصائص أمير المؤمنين): ص47.
(687) الكافي: ج1، ص229.
(688) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج9، ص209.
(689) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ص471.
(690) الميزان في تفسير القرآن: ج2، ص287.
(691) تفسير القمي: ج2، ص129.
(692) الكافي: ج1، ص226.
(693) الأمالي: ص654.