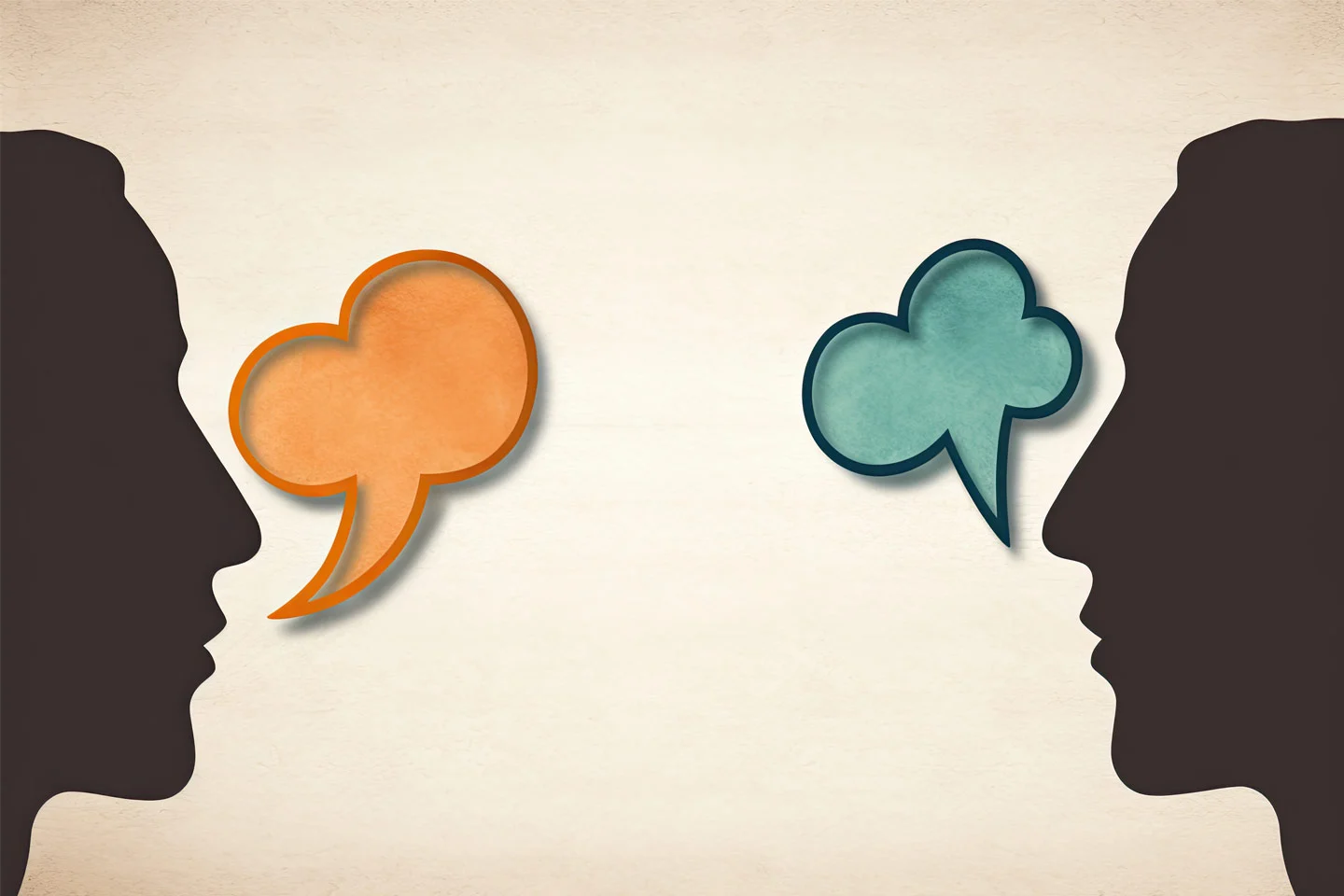
كان من الأفكار التي طُرحت وتبلورت كي تطبق عملياً في عصر ما بعد الحداثة وهي من نتائج عصر بعد ما بعد الحداثة عند الغرب، وفي مجال النقد الأدبي (الشعري والنثري)، وكردة فعل علىٰ البنيوية (التي كانت تدعو إلىٰ البنية المتكاملة والمتراصة في النص) هي ما أسماه البعض بالممارسة النقدية التفكيكية والمذهب الفلسفي أو الاستراتيجية الجديدة في مقاربة النص الأدبي والتي أخذت بالتوسُّع من النص الأدبي إلىٰ غيره كالتفكيكية في الفن التشكيلي والعمارة وغيرها، بل طبقها البعض ممن درس في الغرب من المسلمين علىٰ القرآن الكريم، فَانتقلت الأفكار والرؤىٰ الغربية إلىٰ مقدسات المسلمين الأساسية، وهذا يدل علىٰ الخطر الكبير الناتج من هذه الممارسة النقدية، إذ إنَّ هناك آثاراً سلبية كبيرة من جراء تطبيق النقد التفكيكي علىٰ النصوص الشرعية بشكل عام والقرآن الكريم بشكل خاص، حيث إن التفكيكية تشكك أو تنفي كل ما هو ثابت، وكذلك تفصل الكتابة عن المؤلف ولا تعتمد قواعد اللغة والتفسير، وبالتالي تجعل القرآن نصاً أدبياً خاضعاً للنقد من أي شخص ولو لم يكن متخصصاً، وبالتالي تظهر لنا قراءات وآراء شخصية غربية أو بروح غربية بعيدة عن نص القرآن الكريم والإسلام.
ولخطورة هذه الممارسة النقدية علىٰ النص الديني سنقف عليها بشكل مختصر، ونحاول بيان بعض ما تتَّصف به ثم نبيِّن بعض أوجه الخلل فيها.
بعض ما تتَّصف به الممارسة النقدية التفكيكية:
سُلِّطت الأضواء علىٰ هذه الممارسة النقدية من قبل الكثير من المفكرين وذُكر لها الكثير من الخصائص والصفات، منها:
أولاً: لا تعتقد هذه الممارسة بقداسة المؤلف فضلاً عن قداسة الظروف المحيطة به، بل هناك دعوة إلىٰ موت المؤلف وتركيز النظر علىٰ النص فقط أو ما يعبر عنه بترك الكلام والتركيز علىٰ الكتابة فقط، وهذا ما قد يعبّر عنه في النقدية التفكيكية بميتافيزيقا الحضور أي التعامل مع النص فقط وترك المؤلف.
ثانياً: جعلت القارئ والمتلقي هو العامل الأساسي في النص الأدبي فهو الذي يحلل ويستخرج المعاني بحسب ظروفه المحيطة به ومشاعره وأحاسيسه وتجربته، مما قد يؤدّي إلىٰ تعدُّد القراءات وربما تباينها واختلافها عن ما يريده المؤلف، وربما يُركن إلىٰ التأويل، وهذا ما قد يعبّر عنه في هذه الممارسة بالاختلاف والإرجاء، فكل معنىٰ يحصل عليه القارئ فهو غير ثابت حتىٰ يأتي معنىٰ آخر يختلف عنه ويحل محله.
ثالثاً: إقصاء اللغة والدعوة إلىٰ عدم الترابط والتلازم في الدلالة بين الدال والمدلول، فيمكن لنا أن نتوفَّر علىٰ عدَّة معاني من نص واحد وربما هذه المعاني ليست مرادة للمتكلِّم.
رابعاً: يمكن للقارئ أن يفكك النص الواحد إلىٰ عدَّة نصوص، ثم يعيد تشكيله مرة أخرىٰ ويحصل علىٰ نص تركيبي آخر يتألف من عدَّة نصوص، فهي تهدم وتنبني إلىٰ ما لا نهاية، وهذا ما قد يعبّر عنه بالحضور والغياب، أي حضور معنىٰ وغياب معنىٰ آخر.
خامساً: فصل النص الأدبي عن كل ما يحيط به من ظروف تاريخية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها، بمعنىٰ أنَّ النص لا يوجد له أي مرجعية من المرجعيات المعروفة والمعمول بها في نقد النص الأدبي والتي كان يعتمد عليها في عصر الحداثة، وهذا يمكن التعبير عنه بنقد المركزية أي لا يوجد مرجعية للنص الأدبي يرجع لها.
وقبل طرح بعض الأسئلة والإجابة عنها حول ممارسة النقد التفكيكي، من الملفت للنظر في هذا الأسلوب من النقد أنَّه طبق عند المسلمين، مع العلم أنَّه قام في مناخ غربي وفي ظروف خاصة به وكان يدعو إلىٰ الانفكاك عن العقلانية، وهذا الأسلوب ناقض نفسه بنفسه فهو في نفس الوقت الذي ينكر مركزية العقل أخذ يفكر بالعقل ويصل إلىٰ هذه النتائج بواسطته، وكذلك فإنَّ التفكيكية نشأت في أجواء اللامركزية واللاثبات، فكيف لها أن تقف عند معنىٰ معيَّن ثابت، وتقول هذا هو المعنىٰ المراد من النص بعد أن دعت إلىٰ ما لا نهاية من المعاني!؟
أسئلة وأجوبتها حول الممارسة النقدية التفكيكية الغربية:
وهنا عدَّة أسئلة نجيب عنها حتّىٰ نقف علىٰ عدم صحة الممارسة النقدية التفكيكية الغربية:
١ – ما هو الأصل الأوَّلي في الكلام هل الحقيقة أم المجاز، ومتىٰ يمكن لنا أن نلجأ إلىٰ التأويل؟
تلجأ الممارسة التفكيكية إلىٰ ترك الحقيقة والركون إلىٰ المجاز والتأويل ومخالفة القواعد العقلائية في مقام التخاطب حيث إنَّ الأصل العقلائي في اللفظ المستعمل هو الحقيقة أي استعمال اللفظ فيما وضع له ومن دون قرينة، وليس المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة مع القرينة، وكذلك لا تعتمد هذه الممارسة النقدية علىٰ ظاهر الكلام وتتَّجه نحو التأويل مع العلم أنَّ ظهور الكلام حجة عند العقلاء يعتمدون عليه في خطاباتهم ومكاتباتهم.
أمّا التأويل وهو مخالفة الظاهر فله حكمه الخاص ولا يصار إليه إلّا عند وجود مشكلة ما في إمكانية حمل النص علىٰ الظاهر مع لابدية وجود دليل علىٰ التأويل، لأن التأويل عملياً يقلب الحقائق والظواهر إلىٰ غير معانيها، فلابد من وجود دليل لأجل مخالفة الظاهر والجنوح إلىٰ التأويل، ومن هنا فإنَّ الذهاب إلىٰ التأويل والمجاز مباشرة، ومن دون دليل وقرينة مع إمكانية حمل الكلام علىٰ الظاهر والحقيقة أمر غير مقبول ومناف لقواعد التخاطب والحوار عند العقلاء.
٢ – هل من الصحيح الإعراض عن مقصود المتكلِّم؟
قالت الممارسة التفكيكية بإمكانية الحصول علىٰ معانٍ ومقاصد متعدِّدة غير التي يريدها الكاتب من اللفظ الواحد وبالتالي أعرضت عن مقاصد المتكلِّم والكاتب، وهذا لا يمكن القبول به حيث إنَّه لابد من البحث في الكلام عن قصد المتكلم ومراده، حيث إنَّ هذه الكلمات صدرت منه ومن الواضح أنَّ استعمال اللفظ في المعنىٰ من قبل المتكلّم والكاتب العاقل الجاد وعلىٰ اختلاف المباني لابد أن يكون تابعاً لقصده وإرادته، فقد قسمت الدلالة إلىٰ قسمين:
الأول: الدلالة التصورية وهي الانتقال إلىٰ المعنىٰ عند سماع اللفظ مطلقاً عند العلم بالوضع، وهذه الدلالة تابعة للوضع وليست تابعة للقصد والإرادة، إلّا علىٰ مبنىٰ التعهُّد، فإنَّها فيه تابعة للقصد.
والثاني: الدلالة التصديقية وهي أيضاً علىٰ قسمين:
القسم الأول: الدلالة التصديقية الأولىٰ وهي إخطار المعنىٰ في ذهن السامع، وهي تتضمن الدلالة التصورية والإرادة الاستعمالية.
والقسم الثاني: الدلالة التصديقية الثانية ومعناها أنَّ المتكلِّم يريد المعنىٰ بنحو الإرادة الجدية، وهي تتضمن الدلالة التصورية والإرادة الاستعمالية والجدية، وهنا لابد من إحراز أنَّ المتكلِّم في مقام البيان وأنَّه جاد غير هازل، إمّا عن طريق ظهور حال المتكلّم أو علىٰ سبيل الغلبة في أنَّ المتكلِّم إذا تكلَّم بكلام فهو قاصد ومريد لمعناه جداً، وكذلك لابد من عدم وجود قرينة ينصبها المتكلِّم بأنَّه لا يريد هذا المعنىٰ المقصود، وفي هذا القسم أيضاً تكون الدلالة تابعة للقصد والإرادة.
فإذا كان الكلام دالّاً علىٰ معناه بتبعيته للإرادة والقصد سواء في الدلالة التصورية أو التصديقية علىٰ مبنىٰ التعهد أو علىٰ القول إنَّ الدلالة فقط هي الدلالة التصديقية والدلالة التصورية هي مجرد تداعي معاني والذي يحصل بأدنىٰ مناسبة، فإذن هناك معنىٰ خاص يريد المتكلِّم إيصاله للمخاطب من دلالة اللفظ علىٰ المعنىٰ ولابد من البحث عنه والوقوف عليه ولا يمكن لنا بعد ذلك إقصاء المتكلِّم والظروف المحيطة به وجعل المتلقي والمخاطب هو المركز.
٣ – ما هي علاقة الدال أو اللفظ بالمدلول أو المعنىٰ؟
إنَّ الممارسة التفكيكية قالت بعدم الترابط بين الدال والمدلول بمعنىٰ أنَّنا يمكن أن نحصل علىٰ معاني متعدِّدة في النص الواحد ومتباينة وإلىٰ ما لا نهاية، وربما هذه المعاني ليست هي نفس المعنىٰ أو المعاني التي قصدها المتكلِّم، وبالتأمل في هذا الكلام نجد أنَّنا لا يمكن أن نقبل به لأنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين الدال وهو اللفظ والكلمة اللذان صدرا من اللافظ والكاتب وبين المدلول، وهو المعنىٰ الذي قصده المتكلِّم أو الكاتب، وعلىٰ كل النظريات التي حدَّدت كيفية ارتباط اللفظ بالمعنىٰ سواء قلنا بنظرية الارتباط الذاتي بين اللفظ والمعنىٰ أي كان اللفظ علَّة تامة للمعنىٰ أو مقتضي، أو قلنا بالاعتبار، أي كان اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنىٰ بالاعتبار أو باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنىٰ الموضوع له، أو باعتبار تخصيص الواضع اللفظ لهذا المعنىٰ، أو قلنا بنظرية التعهُّد، أي تعهُّد المتكلِّم بإبراز المعنىٰ بلفظ مخصوص، أو قلنا بنظرية الاقتران الأكيد بينهما، أي عند تصوُّر اللفظ يقترن المعنىٰ معه أكيداً في الذهن، أو غيرها من النظريات.
فالمتكلِّم عندما يتكلَّم أو يكتب فهو يريد معنىٰ معيناً مخصوصاً من خلال اختياره لهذا اللفظ أو ذاك، بحيث إنَّ هذا اللفظ المعيَّن ارتبط بذاك المعنىٰ المراد بنحو من الارتباط الوثيق، نعم لو أراد المتكلِّم أو الكاتب غير هذا المعنىٰ المخصوص فعليه أن يأتي بقرينة خاصة نفهم منها أنَّه لا يريد هذا المعنىٰ، وعليه فلا يمكن لنا أن نستخرج معاني متباينة من النص تخالف غرض المتكلِّم أو الكاتب خصوصاً عندما لا توجد هناك قرائن تدل علىٰ المعاني المغايرة عما يريده المتكلِّم.
٤ – هل يمكن إقصاء المؤلف والظروف المحيطة به وجعل القارئ هو العامل الأساسي في النص الأدبي؟
إنَّ من الأمور الإيجابية التي وصلت إليها هذه النظرية هي إمكانية القراءات المتعدِّدة للنص، ولكن علىٰ حساب فصل المؤلف عن النص المكتوب، وهذا لا يقبل بحال لأنَّ الغرض من الإتيان بالكلام في النص الأدبي بل في كل كلام أنَّ هناك غرضاً مقصوداً فيه، والمتكلِّم أراد أن يعبِّر عما في نفسه من مشاعر وأحاسيس بألفاظ دالة علىٰ مراده بعد الفراغ من أنَّ هذه الكلمات والهيئات لها أوضاع خاصة في كل لغة، وعليه لابد من التفتيش والبحث عن هذا الغرض المقصود التابع للمتكلِّم ورعاية الظروف المحيطة به، حتىٰ نصل إلىٰ هذا الغرض، ولابد للمتلقّي من رعاية القواعد الخاصة في فهم الكلام واستخراج معانيه حتّىٰ يصل إلىٰ المعنىٰ المراد لا أن نراعي الظروف المحيطة بالمخاطب ونجعله هو الأساس، فإنَّ هذا يجعل الكلام موجَّه من المخاطب لا من المتكلِّم.
وكذلك فإنَّ هناك ظروفاً محيطة بالكلام والكتابة وهي التي جعلت المتكلِّم يصوغ كلماته بهكذا طريقة وكيفية، فهناك ظروف تاريخية واجتماعية وسياسية وغيرها أحاطت بالكلام والكتابة حتّىٰ صدرا من المتكلِّم، وهذه الظروف هي بمثابة القرائن المحيطة بالكلام والكتابة فلا يمكن فصلها ونسيانها وإلّا لاختلَّ مراد المتكلِّم.
النتيجة:
من خلال ما مرَّ يتَّضح لنا عدم القبول بهذه الممارسة من النقد لأنَّها أهملت المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع النص وأبعدت المتكلِّم عن قصده وساهمت في تحريف الكلام، ولم تكشف لنا عن مراد المتكلِّم أبداً، بل هي تُقوِّل النص والمتكلّم وإن كانت تدعو ظاهراً إلىٰ الثراء العلمي في فهم النص ولكنها في الحقيقة تقوم بتشتيت النص وتمزيقه وإبعاده عن مقصده الأصلي، وكذلك لا يمكن تطبيق هذه الممارسة علىٰ النصوص الشرعية وبالأخص القرآن الكريم، فإنَّه نص إلهي مقدَّس أنزله المولىٰ تبارك وتعالىٰ علىٰ رسوله (صلّىٰ الله عليه وآله وسلَّم) وفيه أغراض ومقاصد شرعية خاصة وثابتة ومطلقة لا يستطيع الوقوف عليها إلّا المختص العالم بأساليب القرآن ومفرداته وتراكيبه ووحدة سياقه وتعدّدها، ولابد أن يتعامل معه ضمن أسلوب ومنهج خاص.


